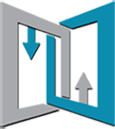خطاب العنف والدم.. الحاكمية بين المودودي وسيد قطب والتراث (2-2)
الإثنين 22/مايو/2017 - 05:33 م
طباعة
نستكمل اليوم مفهوم الحاكمية بين أبو الاعلى المودودي وسيد قطب والتراث، حيث نرى أن الحاكمية في نسختها النهائية ألا تجعل أحدًا حكمًا على قلبك ولسانك ويدك وكافة جوارحك؛ غير الله تعالى، وأن تترك الحكم على الخلائق لله وحده، وألا تجعل من نفسك قاضيا على الناس وجلادًا لهم، وأن تحرَّم الظلم على نفسك وألا ترتضي وقوعه على غيرك؛ فأنت عبد للحكم العدل؛ وأن توقن أنها الارتضاء التام والقبول العام لكل ما قدره عليك رب الأنام؛ مدركا أن تمام العبودية لله- جل وعلا- أن تعيش حياتك طالبا لحكمته، باحثا عن سبيل الوصول إليه.
ولا بد من التأكيد هنا ان "الحاكمية" ليست من إبداعات سيد قطب الحصرية كما يدعي البعض؛ فكتب أصول الفقه السنية التراثية تجعلها مبحثًا رئيسًا ضمن مباحث «الحكم الشرعي» والحاكم هو الله باتفاق. ومن ضمن إطار الحاكمية أن لكل فعل إنساني حكمًا شرعيًا يدور بين الأحكام الخمسة المشهورة (الوجوب- الندب- الإباحة- الكراهة- التحريم)؛ وبالتالي فإن لكل فعل حكمه، وإلا نكون قد جوّزنا أن الإنسان قد يُترك سدى (لا يؤمر ولا ينهى) كما نقل عن الإمام الشافعي. ويتفرع من هذا التنظير امتناع الإنسان عن “الحكم” إلا بسند شرعي (نص أو حمل على نص كالقياس ونحوه)، بل وعندما اعتبر الأحناف والمالكية أصل الاستحسان – وهو من أغمض المباحث الخلافية، قال عنهم الشافعي «من استحسن فقد شرّع»، وقال عن الاستحسان ذاته إنه «تشهٍ وقولٌ بالهوى».
ومن المعروف تاريخيًا أن عبارة (لا حكم إلا لله) قالها المُحكّمة الأوائل – المعروفون تراثيًا بالخوارج-، وقد أجابهم الإمام علي بمقالته «كلمة حق يراد بها باطل»، فالعبارة ذاتها لم تمثل إشكالًا للإمام، وإنما الإشكال في الموقف الذي قيلت فيه عندما رفضت المحكمة التحكيم بين جيشي علي ومعاوية أثناء صفين وقد ناقشهم ابن عباس – على ما نقل لنا- في كيفية تبيان حكم الله، وأن الكتاب لا ينطق وإنما ينطق به الرجال، فيستحيل – عمليًا- الحكم والتنفيذ دون إقحام العامل البشري، ولكن حدود العامل البشري تتمثل في فهم مراد الله والحكم به وليس بآرائهم الشخصية.
بل وقد سبقه الشيخ الباكستاني «أبو الأعلى المودودي» في التنظير للحاكمية إبان إنشائه للجماعة الإسلامية.
ويتجلى رأي قطب في الحاكمية في تفسيره لآية "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" فيقول في تفسيرها «ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحدّ الإسلام، يقرره الله سبحانه بنفسه ويقسم عليه بذاته فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام ولا تأويل لمؤول، اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام، وهي أن هذا القول مرهون بزمان وموقوف على طائفة من الناس، وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئًا ولا يفقه من التعبير القرآني قليلًا ولا كثيرًا، فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد، وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله – صلى الله عليه وسلم- هو تحكيم شخصه، إنما هو تحكيم لشريعته ومنهجه، وإلا لم يبقَ لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته، وذلك قول أشد المرتدين ارتدادًا على عهد أبي بكر – رضي الله عنه-، وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين، بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير، وهو مجرد عدم الطاعة لله ولرسوله في حكم الزكاة، وعدم قبول حكم رسول الله فيها بعد الوفاة. وإذا كان يكفي لإثبات (الإسلام) أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله، فإنه لا يكفي في (الإيمان) هذا ما لم يصحبه الرضا النفسي والقبول القلبي وإسلام القلب والجنان في اطمئنان، هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان، فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان»
المبدأ السابق ذاته، يقرره قطب في آية المائدة (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) فيقول "والعلة هي التي أسلفنا، هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله، فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية ومن يحكم بغير ما أنزل الله يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب، ويدّعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟، وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان والعمل – وهو أقوى تعبيرًا من الكلام- ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟" ويقول «والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه، وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل. وليست تعني قومًا جددًا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى، إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها لاصقة بمن لم يحكم بما أنزل الله من أي جيل ومن أي قبيل. الكفر برفض ألوهية الله ممثلًا هذا في رفض شريعته والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد في حياتهم والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه، فهي صفات يتضمنها الفعل الأول وتنطبق جميعها على الفاعل ويبوء بها جميعًا دون تفريق» ويذكرنا النص الأخير بالمفهوم الذي قرره ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من بعده في قسمة التوحيد لقسمين (توحيد ربوبية – توحيد ألوهية) فتوحيد الربوبية – بالمعنى التيمي- هو الإقرار لله بالخلق والرزق ونحوهما. أما توحيد الألوهية فإفراد الله وحده بالعبادة والطاعة دون شركاء أو أنداد أو حتى وسطاء. واستدل ابن تيمية بأن كفار قريش كانوا يقرون لله بالخلق (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ )، ولكنهم كانوا يقحمون وسطاء ليقربوهم من الله زلفى. وبما أن النص القرآني كفّرهم باتخاذهم الوسطاء، فالتوحيد، إذن، لا يكتمل إلا بنفي الطاعة والعبادة عما سوى الله.
أما نص قطب السابق فإنه يرفع الشريعة لمرتبة العقيدة، ويعتبر أي قانون إنساني (وضعي) محاولة لتأليه البشر يجب أن تجابه بكل صرامة حتى يتم توحيد الله (ربوبية + ألوهية)، فمن انفرد بالخلق ينفرد كذا بالأمر.
قد نجد جذورًا لهذا المفهوم في العقيدة السنية أيضًا كما وجدنا له جذورًا في الفقه التيمي، فأهل السنة (أو الأشاعرة تحديدًا) يقولون بالحسن والقبح الشرعيين، فلا تتمايز الأفعال إلى خير وشر بذواتها وإنما باختيار الله لها، فبالتالي من يحكم أفعالنا هو النص حصرًا، وليس للعقل مدخل في معرفة الحسن والقبح، وفي هذا الموقف يتم نفي العقل البشري كليًا وتحكيم النص الإلهي حصريًا.
لا نزعم أن قطب يقر بعقيدة (التحسين والتقبيح الشرعيين) كما هي، وإنما نبحث عن جذور فكرة الحاكمية في التراث السني ونزعم أنها لم تخلق عند قطب من فراغ وإنما نمت عنده كبذرة كامنة في الموروث.
ولأن مفهوم «الحاكمية» يكاد أن يكون الأكثر إنتاجاً للعنف، فإن تفكيكاً له يكون هو المطلوب لا محالة.
ورغم ما شاع من نسبة هذا المفهوم إلى الخوارج، فإن الذهاب إليهم بهذا المفهوم- بالصورة التي وصل عليها إلى العصر الحديث- يبدو حكماً متعسفاً يفضحه التحليل. فإنهم قد استخدموا مفهوم «الحكم» بمعنى القضاء بين طرفين متنازعين؛ وهو المعنى الذى عرفوه في زمانهم بحسب ما ينطق به الاستخدام القرآني له. ولعل ذلك ما يؤكده أن المفهوم قد انبثق فعلاً في إطار التنازع بين طائفتين من المسلمين رأى الخوارج أنه لا مخرج من الاقتتال الدامي بينهما إلا بأن يكون تنازعهما موضوعاً لحكمٍ وقضاء. إن ذلك يعنى أنهم لم يرفعوا المفهوم ليحاربوا به حكومة يعترضون عليها بأنها لا تحكم بما أنزل الله على نحو ما يفعل الحاملون لمفهوم الحاكمية فى اللحظة الراهنة، بل رفعوه إعلاءً لمبدأ التحاكم بين المتنازعين حقناً لدمائهم.
ولهذا فإنه إذا كان لابد سلفٍ يجد عندهم مفهوم «الحاكمية» ما يؤسسه، فإن هذا السلف لن يكون الخوارج، بل إنه سوف يكون ابن تيمية؛ وبالذات فى نظريته عن التوحيد. والمُلاحظ أن هذه النظرية هي الأساس الغائر الذى يتكأ عليه كل الذين يرفعون راية الحاكمية. فقد دشن ابن تيمية ذلك التمييز بين ضربين من التوحيد؛ أحدهما هو «توحيد الربوبية» الذى يعنى الإقرار بأن الله هو الخالق والمُدبر والمُحيى والمُميت وغيرها، والآخر هو «توحيد الألوهية» الذى يعنى وجوب إفراد الله وحده بالعبادة من دون شريك؛ وبما يترتب على ذلك من وجوب أن تكون الحاكمية لله لأن جعلها لغيره سيكون نوعاً من الشرك به. ولقد كان هذا التصور للتوحيد هو نفس ما تبناه، وعلى نحوٍ كامل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبو الأعلى المودودي وسيد قطب الذين رفعوا جميعاً راية «الحاكمية». يقول المودودي في كتاب «المصطلحات الأربعة» الذى خصصه لهذا التمييز بين نوعى التوحيد: «ألم تر أنه بينما جاء في القرآن أن الله تعالى لا شريك له في الخلق وتقدير الأشياء وتدبير نظام العالم (وهو توحيد الربوبية)، جاء معه أن الله له الحكم وله المُلك، وليس له شريك فيهما، مما يدل دلالة واضحة على أن الألوهية تشتمل على معانى الحكم والمُلك أيضاً، وأنه مما يستلزمه توحيد الإله (الألوهية) ألا يُشرك بالله تعالى في هذه المعاني كذلك». وهكذا فإن «الذى يدَّعى أنه مالك المُلك والمسيطر القاهر والحاكم المطلق بالمعاني السياسية، فإن دعواه إذن كدعوى الألوهية». وغنيٌّ عن البيان أن سيد قطب قد فعل الشيء نفسه، وأسند «الحاكمية» إلى ما قال إنه «توحيد الألوهية».
وهنا يلزم التنويه بأن نظرية ابن تيمية في توحيد الألوهية التي انبنى عليها مفهوم «الحاكمية» إنما تجد ما يؤسس لها، وعلى نحوٍ كامل، في المفهوم الأشعري عن الإنسان باعتباره- حسب نظرية الكسب الأشعرية- مجرد فاعلٍ بالمجاز وليس بالحقيقة. ولعل ذلك ما يكشف عنه أن مفهوم الحاكمية يتفرَّع، عند سيد قطب، عن أحد أكثر المفاهيم المركزية في خطابه؛ وهو مفهوم العبودية المطلقة لله وحده. وهو يرى أن هذه العبودية تتمثل في أن يكون الإنسان مجرد «مُتلقي» في كل أحوال وجوده؛ وبما يعنيه ذلك من أنه ليس أهلاً لأن يفكر أو يفعل بذاته. فإنه يحضر في العالم منفعلاً وليس فاعلاً، ومتلقياً وليس مفكراً. وإذ يبدو هكذا أن البشر يحضرون في خطاب الحاكمية، لا بما هم «ذوات» فاعلة ومؤثرة، بل بوصفهم «أدوات» ينحصر دورها في تحقيق خطة جاهزة ومُعدَّة سلفاً (سواء من الله أو غيره)، فإنه ليس من شكٍ أبداً في أن هذا النوع من الحضور هو جوهر ما تنتهى إليه نظرية الكسب الأشعري.
ويعنى ذلك، بطبيعة الحال، أن مفهوم الحاكمية هو بمثابة المآل النهائي الذى تؤول إليه نظرية الكسب الأشعري؛ وبما يترتب على ذلك من أن محاصرة مفهوم «الحاكمية» لن تكون ممكنةٌ حقاً ما لم يتم التعامل مع نظرية الكسب الأشعري، وبيان ما ينتهى إليه هذا الكسب- عبر نسبة كل ما يصدر عن الإنسان إلى الله بوصفه هو الفاعل له على الحقيقة- من تهديدٍ للذات الإلهية نفسها عبر تحويلها إلى قناعٍ يتخفى خلفه الطغاة والمحتكرون والقتلة بادعاء أن كل ما يصدر عنهم من أفعال الطغيان هو من الله في الحقيقة، وهم فقط مجرد أدواته في إتيان هذه الأفعال البغيضة.
وربما كان في ذلك تفسيراً لحقيقة أن فيالق الجهاديين المعاصرين لا تخرج فقط من البلدان التي تسود فيها الحنبلية، بل إن قسماً منهم- وفيهم القادة والقائمون على إنتاج الفتاوى والأسانيد الشرعية- ينتسبون إلى بلدانٍ تغلب فيها الأشعرية.
ويجدر بنا هنا ان نتساءل: هل اختلاف المختلفين مع قطب – من علماء الإسلام- هو اختلاف في الغاية أم في الوسيلة وما يلابسها من عنف وتكفير؟، وهل لهذه الغاية من وسائل أخرى تنسجم مع الواقع المعاش (الدعوة مثلا)؟، وهل هذه الغاية وما يلابسها من وضع العقل الإنساني والخبرة البشرية بإزاء إرادة الإله تؤول إلى صلاح المجتمع؟.
وبالأخير: هل يتحمل قطب مسئولية العنف والتكفير وحده ونغض الطرف عن الجذور الحقيقية للأزمة؟.