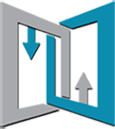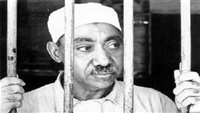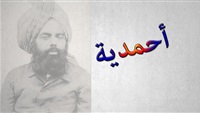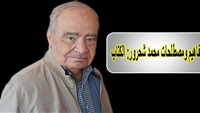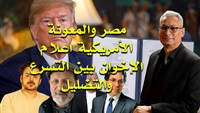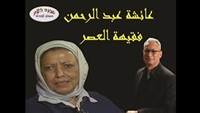الإمامة.. " فرض كفاية" عند الأزهر و"ركن من الإيمان" في الإسلام السياسي
الأحد 05/يوليو/2015 - 06:44 م
طباعة


فكرة الإمامة أو الخلافة اكتنفها جدل طويل بين الفرق الإسلامية قديما والإسلام السياسي حديثا، ولأن الأزهر الشريف يعد المرجعية السنية في العالم الإسلامي فسوف نعرض رأي الأزهر على لسان الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والذي قال: إن الإمامة تعني الإمام الذي يقود المسلمين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- سواء سُمِّي إماما أو خليفة، وأهل السنة سموه خليفة، لأنه خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والشيعة سموه إمامًا لأن المسلمين يأتمون به كما كانوا يأتمون بالنبي - صلى الله عليه وسلم-، وقضية الإمامة قضية خطيرة جدا، يقول الشهرستاني: ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلَّ على الإمام، وربما قصد أن مسألة الإمامة كانت من أكثر القضايا التي افترق المسلمون على أساسها فكريًّا وسياسيًّا.
وأضاف فضيلته في حديثه اليومي، الذي يذاع في هذا الشهر المبارك على الفضائية المصرية قبيل الإفطار: إنَّ إجماع أهل السنة على أنَّ مسألة الخلافة ليست من أصول الدين، وإنما هي مسألة عملية تنظيمية بحتة، ومحل بحثها الأحكام العملية في الفقه، وهي من فروض الكفاية، كصلاة الجنازة، التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، بمعنى أنه إذا صلى عشرة على ميت، وهناك مئة آخرون بالخارج لم يصلوا عليه، سقطت عنهم هذه الصلاة، لقيام البعض بأدائها، وفرض الكفاية هو في مقابل فرض العين الذي لا يسقط أبداً عن الشخص إلا إذا فعله، مثل: فرض الصلاة الذي يجب على الجميع القيام به، لأنه فرض يتعلق بعين المكلف.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن مسألة الإمامة ليست من أصول الاعتقاد ولا متعلقة بالإيمان أو بالكفر عند أهل السنة، لأن الإيمان يبُنى على الاعتقاد، حيث إنه عمل قلبي، وليس من أعمال الجوارح، وفي المقابل الشيعة يقولون: إن الإمامة أصل من أصول الدين فمن لا يؤمن بالإمامة لا يكتمل إيمانه وليس شيعيًا، وأصول الدين عند الشيعة، هي: التوحيد والعدل، والنبوة، والإمامة، والإيمان بالمعاد بالبعث أي الحياة بعد الممات والجنة والنار، والسنة والشيعة متفقون في كل هذه الأصول ماعدا أصل الإمامة، فالشيعة يعتقدون أنها من أصول الدين فكما يجب على المسلم أن يعتقد بالنبوة فيجب عليه أيضًا أن يعتقد بالإمامة.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن تعيين الإمام عند الشيعة اختيار إلهي، بمعنى أن الله تعالى أوحى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- هو الإمام من بعده، ثم إن سيدنا عليًّا سمَّى الإمام الحسن، والإمام الحسن سمَّى الإمام الحسين إمامًا، وهكذا إلى الإمام الثاني عشر، الذي اختفى وما زال الشيعة إلى الآن ينتظرون خروجه ويدعون له بالفرج، وأما أهل السنة فيعتقدون أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم ينص على شخص معين حدده باسمه ليكون خليفة من بعده، بل ترك الأمر لاختيار صحابته يختارون من يشاؤون ويتفقون عليه لقيادتهم ورئاستهم وحكمهم، وبالتالي فإن الإمامة عند الشيعة أصل من أصول الدين، وعند أهل السنة ليست كذلك.
البنا ومسألة الإمامة:

وعلى النهج الشيعي في مسألة الإمامة وجعلها ركنا من أركان الايمان سار حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان حيث كتب البنا في رسالة المؤتمر الخامس تحت عنوان "الإخوان المسلمون والخلافة":
ولعل من تمام هذا البحث أن أعرض لموقف الإخوان المسلمين من الخلافة وما يتصل بها، وبيان ذلك أن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية، ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها، والاهتمام بشأنها، والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله، ولهذا قدم الصحابة رضوان الله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، حتى فرغوا من تلك المهمة، واطمأنوا إلى إنجازها.
والأحاديث التي وردت في وجوب نصب الإمام، وبيان أحكام الإمامة وتفصيل ما يتعلق بها، لا تدع مجالاً للشك في أن من واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن منهاجها، ثم ألغيت بتاتًا إلى الآن.
والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لابد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات:
لابد من تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها، يلي ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات، وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد، وإن المؤتمر البرلماني الإسلامي لقضية فلسطين، ودعوة وفود الممالك الإسلامية إلى لندن للمناداة بحقوق العرب في الأرض المباركة لظاهرتان طيبتان، وخطوتان واسعتان في هذا السبيل، ثم يلى ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية، حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الاجتماع على (الإمام) الذى هو واسطة العقد، ومجتمع الشمل، ومهوى الأفئدة، وظل الله في الأرض.
حيث يتضح من الفقرة الاخيرة في رسالة البنا ان "الامام واسطة العقد، ومجتمع الشمل، ومهوى الافئدة، وظل الله في الارض" ان جماعة الاخوان تجعل من الامامة او الخلافة قضية ايمانية محورية وان الامام لدى هذه الجماعة هو ظل الله في الارض وشاهدنا هذا عمليا في عام حكم المعزول مرسي.
السلفيون والخلافة:

ان المتابع لتاريخ السلفية الحديثة يلاحظ انه ما كانت الخلافة بين مشروعات هذه السلفية الحديثة لاستعادة الشرعية. فالإحياء السلفي الأول في الأزمنة الحديثة ظهر لدى سلفية محمد بن عبد الوهاب بنجد، ووقع في مواجهة الخلافة العثمانية التي قاتلت الإحياء الوهّابي على مدى أكثر من قرن. فالسلفيون المُحدَثون كانون يعتبرون الخلافة جزءًا من التقليد الذي خرجوا عليه باعتباره تحوَّل بعد عهد الراشدين إلى بدعٍ وضلالاتٍ ومُلْكِ عضوض. ولذلك دعا السلفيون منذ القرن الثامن عشر إلى دولة الكتاب والسنة وأقاموها بالفعل في نجد، وما سعوا إلى إنشاء خلافةٍ بديلةٍ في أزمنة المواجهة مع العثمانيين، ولا في أزمنة الاستضعاف والمُهادنة، وعندما امتدَّت السلفية إلى الهند في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دخلت من جانب بعض نُخَبها الجديدة في مسألة "فقد الشرعية" إلى جانب بعض فقهاء الأحناف، لأنّ الدار لم تُعُدْ دار إسلامٍ بسبب الاحتلال البريطاني. إنما حتى في تلك الحالة، ما أُثيرت قصة استعادة الخلافة الراشدة لدى السلفيين، لأنّ فقهاء المذاهب الأُخرى بشبه القارة الهندية وأواسط آسيا أعلنوا ولاءهم للخلافة العثمانية العدوّ الأول للسلفيين. والمعروف أنّ علماء الأحناف التقليديين والإصلاحيين، أنشأوا بالهند في الربع الأول من القرن العشرين "جمعية الخلافة" لنُصرة السلطان العثماني. فلمّا أزال البريطانيون ومن بعدهم مصطفى كمال أتاتورك السلطة والخلافة (1922-1924) تنادت مجموعاتٌ من الفقهاء والسياسيين بالهند ومصر والشام والحجاز وآسيا الوسطى لاستعادةُ "الخلافة الجامعة" كما سمَّوها، لكنّ سلفيي الملك عبد العزيز آل سعود ما شاركوهم حماسهم، ولا رأوا في ذلك أية فائدة، وسخر دُعاتُهم من خلافةٍ ينتجها البريطانيون لصالح الهاشميين أو ملك مصر أو حتى مصطفى كمال وفي آخِر مؤتمرات النُواح على الخلافة بالقدس عام 1931، انتقل النقاش إلى كيفية تكوين سلطة إسلامية جامعة مُفيدة في مكافحة الاستعمار، وجمع كلمة المسلمين. وقد كان هناك مَنْ دعا إلى "جمعية أُمَمٍ إسلامية" على الطريقة التي اقترحها عبد الرزاق السنهوري في أُطروحته للدكتوراه بالسوربون عام 1927
وبعد زوال السلطنة العثمانية تشعب النقاش في الأوساط الدينية غير السلفية إلى شعبتين: شعبة تقليدية ترى أنّ الخلافة وإن لم تكن من الدين، فإنها الصيغة التي أطبقت عليها الأمة عبر العصور. وشعبة إصلاحية ترى أنه ما دامت الخلافة ليست جزءًا من الدين، فلا ينبغي الالتزامُ بها لسببين: الأول الانحطاط الذي شهدتْه عبر التاريخ، وأنها كانت دائماً مُلكاً عَضوضاً في حالات القوة، أو تغطية للاستبداد في أزمنة الضعف والسلطنات. والسبب الثاني أنّ المسلمين الذين أنتجوا نظام الخلافة أو صيغتها عندما كانت ملائمة، قادرون اليومَ على إنتاج أنظمةٍ سياسيةٍ ملائمةٍ لزمانهم الحاضر. وإلاّ كانوا يكررون الفشل الذي عانته الدولة البابوية الكهنوتية في أزمنة أوروبا الوسيطة ( علي عبد الرازق – الاسلام واصول الحكم)
ورغم أنّ التقليديين والسلفيين لم يوافقوا علي عبد الرازق في تصويره لتاريخ الخلافة وتجربتها، فإنهم جميعاً انضووا في التجارب الجديدة: السلفيون في تجربة الملك عبد العزيز، والتقليديون كالإصلاحيين في تجارب الحكم الدستوري الملكي والجمهوري الذي اعتبروه قائماً على الشورى التي تُناظرُ تجربة الخلافة الراشدة. وبقي فريقان صغيران مع تجربة الخلافة: الإحيائيون الإسلاميون الجدد( الإخوان المسلمون) الذين اعتبروا استعادة الخلافة هدفاً بعيداً ضرورياً لاستكمال استعادة الشرعية التي عهدها المسلمون الأوائل، وحزب التحرير الإسلامي، الذي اعتبر الشكل والمضمون معاً ضروريين لاستعادة الشرعية. ولذلك تناسى الإخوان بعد حسن البنا، وأهل "الجماعة الإسلامية" التي أسسها المودودي بالهند(1941) مسألة الخلافة، ورفعوا شعار "تطبيق الشريعة" إلى حين القيام والتمكين. ولذا فإنه حتى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وباستثناء حزب التحرير، ما عاد أحدٌ من الإحيائيين المسلمين إلى ذكر الخلافة على شفةٍ أو لسانٍ أو قلم والذي ظلَّ يعتبر الخلافة حكم الله في الأرض، في مواجهة "الديمقراطية" العاتية التي هي حكم البشر المخطئين والضالين! بيد أنه رغم هذه التناقضات الظاهرة، فإنّ الجامع بين الإحيائيين السلفيين وغيرهم كان وما يزال اعتبارهم أنّ الإسلام يقول بالدولة الدينية. وهذه المقولة ينكرها الإحيائيون رغم اعتقادهم لها من خلال فرضية تطبيق الشريعة!

فما قال أحدٌ في الإسلام الكلاسيكي السُنّي (ولا الشيعي) إنّ النظامَ السياسي مكلَّفٌ بتطبيق الشريعة. لأنّ الشريعة هي الدين (الطبري)، وما دامت كذلك، فإنّ الشرعية قائمةٌ في المجتمع الذي يحتضن الدين والقرآن، والتكليف متحققٌ والدين مكتمل: { اليوم أكلمتُ لكم دينكم، وأتممتُ عليكم نعْمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينا}. فالقول بالحاجة إلى قيام نظامٍ سياسيٍ مهمته تطبيق الشريعة، هو قولٌ بأنّ الدين غير موجودٍ الآن، ولذلك فالشرعية التأسيسية غير موجودة، والناس جميعاً كفار أو غافلون حتى تقوم دولة التمكين الإخوانية، أما الشيعة الإمامية والذين يعتبرون الإمامة من أركان الدين، فإنهم لا يعطون الدول القائمة قبل ظهور الإمام الغائب مهمةً دينيةً، بل يطلبون الدولة العادلة. ولذا فإنّ دولتي تطبيق الشريعة، وولاية الفقيه، هما انشقاقان دينيان حديثان، مفارقان للتجربة الدينية والسياسية الوسيطة.
بينما عاد السلفيون الجدد إلى مقولة الخلافة بعد أن تركوها على مدى القرنين الأخيرين، متأثرين بإخوان الظواهري وحزب التحرير، وإذا كان الشيعة قد استحضروا الإمامة فلماذا لا يستحضرون هم الخلافة؟- بعد أن فارقوا خارج المملكة ثم بداخلها تجارب السلفية الحديثة مع إقامة الدولة. و أنّ أول مرةٍ سمعنا فيها سلفيين يقولون بخلافةٍ اليوم عام 1999 في كلامٍ لأُسامة بن لادن يذكر فيه أنه بايع الملاّ عمر زعيم طالبان بأفغانستان بالخلافة وإمارة المؤمنين.

ثم لحقه عبد المنعم الشحات من الدعوة السلفية لينظر لمفهوم الخلافة او الامامة كما يراه السلف فيقول في محاضراته "مقارنة بين الخلافة وبين الدولة الحديثة" بعدما عملت الدعوة السلفية في السياسة بعد ثورة 25 يناير 2011 وشكلت لها ذراع سياسي "حزب النور" حيث يقول الشحات: "استنبط علماء الأمة نظامًا سياسيًّا كاملاً، طبقته الأمة لقرون عديدة... كانت أهم ملامحه الآتي:
1- الإمامة وظيفة شرعية يُراد بها: "حفظ الدين، وسياسة الدنيا بالدين".
2- هذه المهام في الأصل هي مهام للأمة ككل، وهي: "إما فروض كفايات أو سنن كفايات"، وقد جاء النص القرآني عادة في هذه الأمور بخطاب الجمع: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ... ) (المائدة:38)، (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ... ) (آل عمران:104)، إلى آخر ذلك... ثم جاء الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ... )، والتطبيق العملي منه -صلى الله عليه وسلم- يقرر قاعدة الوكالة بين الأمة والحاكم.
3- ومِن خلال بيعة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وجماعة الشورى التي أسند إليها عمر اختيار الخليفة تَمَهَّد للأمة مفهوم "أهل الحل والعقد"، وهم الذين يتولون اختيار الحاكم نيابة عن الأمة، ثم يقومون بعد ذلك بالدور الأكبر في مراقبة الحاكم وعزله إذا لزم الأمر، ويجب على الأمة ككل أن تساهم في هذا الدور، إلا أن قرار عزل الحاكم يرجع إلى مَن ولاه.

ومما سبق، يتضح أن النظام الإسلامي رغم أنه يجمع السلطات في يد الحاكم إلا أنه لم يكن كالنظم الديكتاتورية التي كانت تعاني منها أوروبا"
هكذا يصنع الاخوان والسلفيين ديكتاتور يهمن على شعبه باسم الدين فهو عند الاخوان ظل الله في الارض وعند السلفيين المحافظ على الدين والدنيا.. الحاكم بأمر الله.