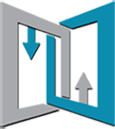الدين والسياسة وهموم أخرى..
السبت 25/يوليو/2020 - 08:45 م
طباعة
 حوار: حسام الحداد
حوار: حسام الحداد
حول الدين والتدين والعلمانية ومفاهيم الدولة المحادية والدولة الدينية، وسؤال النهضة وأزمة العقل العربي، وغيرها من المفاهيم والأسئلة التي تؤرق القارئ العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص كان على بوابة الحركات الإسلامية أن تتوجه للمتخصصين تستقي منهم إجابات أو ان صح التعبير أطروحات حول الهم الفكري والديني والسياسي الذي نعانيه، فكان حوار البوابة مع الدكتور حدي الشريف الباحث والكاتب والأكاديمي المصري، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة السياسية، يشغل وظيفة مدرس الفلسفة بكلية الآداب- جامعة سوهاج، وله كتابات مرجعية في الفلسفة السياسية. كتب في مجالات مختلفة ومتنوعة في الفكر المعاصر، ومن بين مؤلفاته التي تعكس مواقفه الفكرية: "الدين والثورة بين لاهوت التحرير المسيحي واليسار الإسلامي المعاصر"، "فلسفة الكذب والخداع السياسي"، "مفهوم العدالة في فلسفة مايكل ولتـزر"، "أزمة الرأسمالية وتحولات الخطاب الليبرالي"، "الأسطورة والتاريخ في فلسفة هانز بلومنبرج"، وغيرها من الدراسات والأبحاث العلمية.
وقد أكد الشريف في حواره لبوابة الحركات الإسلامية على:
إن أيّة محاولة لإقحام الدين في السياسة، أو جعل الدين متحكمًا في تصريف شئون الدولة من شأنه أن يضر بالدين والدولة معًا.
تمثل العلمانية حماية للدولة المدنية الديمقراطية من تدخل رجال الدين، وهي تمثل أيضًا حماية للدين من تدخل السياسة وتوظيف الدين لخدمة مصالح وأهداف بعينها.
جُل اهتمام الفكر العربي في الوقت الراهن لا يزال أسيرًا لإشكالية التراث والمعاصرة، رغم تغير الظروف والأحوال التي خرجت من رحمها هذه الإشكالية منذ أكثر من قرنين من الزمان.
لقد حان الوقت لهجر النقاش حول مسائل وقضايا وهمية كقضية التراث والتجديد أو الأصالة والمعاصرة، والتركيز على القضايا الحضارية والعلمية المصيرية التي تمثل محور انطلاق أي مجتمع في ركب التقدم الإنساني
نص الحوار:
- بداية نود تعريف القارئ بكم وبإنتاجكم العلمي?
كل الشكر لبوابة الحركات الإسلامية على إجراء مثل هذه الحوارات التي تقرب وجهات النظر المتخصصة إلى القارئ، كما تفضلتم؛ فأنا باحث وأستاذ جامعي، من بين مؤلفاتي وأبحاثي هي التي أشرتم إليها.. أعيش في محافظة سوهاج وأعمل بجامعتها في تدريس الفلسفة في كليتي الآداب والتربية.. وهمومي البحثية تنصب على قضايا الفكر والسياسة والدين بصفة عامة، وإن كان اهتمامي الدقيق يتركز حول قضايا ومشكلات الفلسفة السياسية المعاصرة.
- لك عدد من المقالات تتحدث فيها عن "الدين" و"السياسة" و"العلمانية"، ماذا تعني هذه المفاهيم وكيف ترى العلاقة بينها؟
ما دفعني إلى الاهتمام بمسائل الدين والسياسة والقضايا المرتبطة بهما هو ما نعانيه في مجتمعاتنا العربية في الوقت الراهن؛ أعني غياب الدولة المدنية الحقيقية، والدولة المدنية- على عكس ما يُروج له أحيانًا- لا تعني إقصاء الدين عن المجتمع أو نبذه، أو الدعوة إلى الإلحاد، الدولة المدنية هي دولة على أساس إنساني واقعي لا ديني. وإذا كانت العلمانية تعني التفكير في النسبي بما هو نسبى وليس بما هو مطلق، فإن الأمر كذلك بالنسبة للدولة المدنية، ومن ثم فإن أيّة محاولة لإقحام الدين في السياسة، أو جعل الدين متحكمًا في تصريف شئون الدولة من شأنه أن يضر بالدين والدولة معًا. ومن هنا تمثل العلمانية حماية للدولة المدنية الديمقراطية من تدخل رجال الدين، وهي تمثل أيضًا حماية للدين من تدخل السياسة وتوظيف الدين لخدمة مصالح وأهداف بعينها. وقد بدأ اهتمامي بفكرة الدولة المدنية يتمحور بعد ثورات الربيع العربي، وخلال فترة تولي الإخوان مقاليد الحكم في مصر، وحينها أكدت على أنه يقع على عاتق كل مفكر ومثقف تنويري الدفاع عن قيمة وأهمية الدولة بصفة عامة، والدولة المدنية بصفة خاصة، انطلاقًا من الإيمان بقدسية تراب الوطن وحضارة مصر العريقة، وتنمية روح الفكر والنقد، وتصحيح مسار الوعي، والنضال ضد الفكر الظلامي، والدفاع عن كيان الدولة المصرية من أي محاولة يراد من ورائها هدمها. وقد ترسخ لدي هذا الإيمان خاصة عندما انتُكِست ثورة يناير بتدخل جماعة الإخوان لتغيير مسارها والانقضاض عليها، وتمكين مشروعها في الخلافة الإسلامية، وفرض نزعتها التسلطية، وتعاملها مع الدولة كإقطاعية أو عزبة خاصة بأصحابها، وعندئذ كان تصحيح مسارها عن طريق ثورة 30 يونيو.
- تحدثت في دراسة سابقة حول طبيعة التّفسيرات الأيديولوجيّة للإسلام، وللقرآن خصوصًا، فماذا تعني هذه التفسيرات وكيف تشتغل في أرض الواقع؟
في اعتقادي أن السياسة لم تترك أيّ نوع من العلوم والمعارف إلَّا وظفته لصالحها، وقد امتدت سطوتها إلى استخدام "العلم" ذاته استخدامًا أيديولوجيًا نفعيًا خالصًا في جميع المجالات، وقد أوضحت ذلك في بعض أبحاثي منها دراسة تحت عنوان: «تسييس العلم» (وهي منشورة في مجلة "المدونة"، الجزائر، جامعة البليدة2، المجلد الخامس، العدد الأول، 2018). والأمر كذلك بالنسبة للتفسيرات الأيديولوجية للإسلام؛ فهي باختصار أي تفسيرات أو تأويلات تنزع إلى قراءة النصوص الدينية إما قراءة ثورية تحررية، أو قراءة تبريرية تكرس لبقاء الوضع القائم كما هو عليه. ومرة أخرى تتبدى لنا هنا إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة، وهي إشكالية لا يمكن مناقشتها على نحو دقيق بعيدًا عن مسألة الأيديولوجيا؛ فقد اقترن الدين في الكثير من الأوقات بالسلطة السياسية، وتم تفسير العقيدة الدينية وَفْقًا لمَنْطَق مَنْ يملك السلطة. وليس ذلك بغريب؛ إذ إن الدين يُعَدُّ المنظومة المعيارية الأكثر والأسهل توظيفًا لإضفاء الشرعية على الأنظمة السياسية والاجتماعية، وتسعى كل سلطة في كل عصر إلى استعمال الدين كأيديولوجيا أو سلطة رمزية روحية رديفة للسلطة السياسية.
والناظر إلى مسألة تاريخ العلاقة بين الدين والسياسة سيجدها قد اتخذت أشكالًا وصورًا متباينة لدى الحركات السياسية والدينية، وقد كان للأيديولوجيا دورٌ كبير في تأجيج الصراع بينهما في كثير من الأحيان، كما كان النص الديني عُرْضَةٌ لأي استخدام أيديولوجي مُوَظَّف ومُغْرض. على سبيل المثال: لقد وظفت بعض التيارات الإسلامية- كالخوارج وبعض فرق الشيعة والمعتزلة- بعض النصوص الدينية كأصل من أصول التغيير والخروج على أئمة الضعف، والفسق، والظلم، وقد انعكست الاختلافات المَذْهبية بيَنها على تناول مسألة الثورة، بحيث يُمْكِنُ القول: إن مواقفها من الثورة قد تأثرت بطابع الرؤية المَذهبية، والتفسير الذاتي للنصوص الدينية. ومن هنا فقد حاولت هذه الفِرَق قراءة الدين بنهجٍ أيديولوجي ثوريٍ ملتحم بحركة الواقع والتاريخ. وعلى النقيض من ذلك نجد تفسيرات تبريرية نابعة من قراءة أيديولوجية خاصة للنصوص الدينية، وتمثلها التيارات السياسية المحافظة في العصور المختلفة من التاريخ العربي الإسلامي، مثل «المُرْجِئة»، والتيار السياسي المحافظ في الفكر الشيعي، الذي تمثله الشيعة الاثنى عشرية، والتي ارتبطت الثورة عندهم بظهور المهدي المنتظر (المُخْلِص).
وإذا كان الدين يُمَثِّل ضربًا من ضروب التعامل مع الواقع القائم، إما لتغييره أو تبريره، فإِنَّ التفسير الذي يخضع له النص الديني سَيُؤثر بدوره على طبيعة هذا الواقع، سلبًا أو إيجابًا، ولاسيما ذلك التفسير الذي تتبناه المُؤسَّسَة الدينية الرسمية داخل الدولة. وفي النتيجة فإن مسار تفسير القرآن لدى كل الفرق والتيارات والحركات الإسلامية: القديمة، والحديثة، اتخذ أشكالا مختلفة، شديدة الاختلاف، والسبب في ذلك يكمن في أن تفسيراتها كانت بالدرجة الأولى تفسيرات أيديولوجية تركز محور اهتمامها على توظيف النص القرآني تبعًا لأيديولوجية المفسر والأهداف التي يرمي إليها من تفسيره، الأمر الذي يقودُنا إلى التساؤل من جديد: إلى متى سيظل القرآن ساحة للنزاع والتفسيرات الأيديولوجية والسياسية؟ شيءٌ آخر أعتقد أن له دلالة مهمة هنا، وهو أن ماهية العلاقة المتبادلة بين الدين والإنسان ينبغي أن تقوم، لا على أساس عبودية الإنسان لله، وإنما على أساس أن الدين جاء لتحرير الإنسان وخدمته وتحقيق صالحه وسعادته في الدنيا قبل الآخرة، وفي هذا الإطار يمكن أن نستدعي قول السيد المسيح: "السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِ". وبالتالي يتعين علينا التركيز على الجانب الاجتماعي التقدمي في الأديان، والابتعاد عن الخلافات العقائدية والمذهبية، التي لا تؤدي إلا إلى الإقصاء والعنف والتكفير.
- ماذا يعني بالنسبة لك مفهوم الدولة المحايدة؟
يُفترض أن تكون الدولة محايدة تجاه الأديان والعقائد الدينية في المجتمع، والحياد يعنى الاستقلال التام عن المعتقدات الدينية بالنسبة للدولة في تنظيم أمور السياسة والاجتماع. والدولة المحايدة هي الضمان الحقيقي للمساواة أمام القانون وتعزيز الحرية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والحيلولة دون أن يحتكر طرف واحد أو حزب ما أو جماعة معينة سياسات الدولة وتوجهاتها. والدولة المحايدة (أو العلمانية) لا تلغي الدين من المجتمع، ولا تعطي الأولوية أو الأفضلية لعقيدة دينية معينة على أصحاب العقائد الأخرى.. وهنا وجب التنويه إلى أنه لا غرو في أنه عندما تحتكر المؤسسة الدينية، وخصوصًا عندما تكون مدفوعة بعوامل سياسية معينة، تفسير النصوص الدينية، فعندئذ تظهر التفسيرات السياسية للدين. ومكمن الخطورة في التفسيرات السياسية/الأيديولوجية للدين يتمثل في أن النصوص الدينية تصبح عرضة لأي تفسير تفرضه السلطة الحاكمة بالقوة- قوة الإكراه المادي أو المعنوي. ولا غرو كذلك في أن التفسيرات الأيديولوجية الموجهة للنصوص الدينية تجعل منها ساحة للإقصاء والتناحر والتنابذ بدلًا من أن تكون ساحة للتواصل الخلاق وفضاء لإنتاج قراءات مُنتجة للنص الديني- إذا استخدمنا تعبير المفكر الراحل علي مبروك. وفي حالة استخدام السلطة للدين، أو بمعنى أصح ارتباط السلطة بالدين، نكون بإزاء "دولة ثيوقراطية" أو دولة دينية، وهي تمثل خطرًا على الدين والسياسة معًا. وهنا تتضح ضرورة الدولة المدنية التي لا تعني- كما قلت- فصل الدين عن المجتمع أو إقصاءه بعيدًا عن الحياة الاجتماعية والشخصية، وإنما تعني في الأساس احترام كل الأديان والوقوف على مسافة واحدة منها من جانب، والفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية من جانب آخر.
- كيف ترى مشروعات قراءة التراث بحكم كونك أستاذ فلسفة سياسية؟ وأين يقبع فكرنا العربي المعاصر في الوقت الراهن؟
في اعتقادنا أن جُل اهتمام الفكر العربي في الوقت الراهن لا يزال أسيرًا لإشكالية التراث والمعاصرة، رغم تغير الظروف والأحوال التي خرجت من رحمها هذه الإشكالية منذ أكثر من قرنين من الزمان. ورغم أهمية هذه الإشكالية، فإن ما حدث في معالجاتها طوال أكثر من قرنين هو الانقسام الحاد بين ثلاثة تيارات: تيار سلفي يرفض كل المنتجات الفكرية والثقافية للحداثة الغربية وينغلق على التراث جملة وتفصيلًا دون مراعاة للحظة التاريخية التي نعيش فيها، فيما يرفض التيار الثاني (وهو ما يُسمى بالتيار التغريبي) التراث جملة وتفصيلًا دون مراعاة أيضًا من جانب أنصاره للحظة التاريخية التي نعيش فيها محاولًا فرض رؤى وتصورات وأيديولوجيات فكرية غربية نشأت في سياق محدد وفي ظروف معينة على الواقع العربي والإسلامي. وتيار ثالث حاول الجمع بين الترث والمعاصرة، مع الأخذ في الاعتبار غلبة نزعة التلفيق على بعض أنصار هذا التيار وهي نزعة قد تصل في أحيان كثيرة إلى حد التناقضات الصارخة كما في مشروع الدكتور حسن حنفي في "التراث والتجديد".
- لماذا فشل التنوير العربي حتى الأن في جذب الجمهور إليه وتحقيق أهدافه؟ وهل استطاع الفكر العربي أن يخرج من دائرة الجمود إلى آفاق ثورية خاصة بعد ثورات الربيع العربي؟
لا يجوز لي- على الأقل- القول بفشل مشروعات التنوير العربي، وإن كان بعضها قد أخفق ببساطة لأنها لا تزال تدور في فلك الثنائيات القديمة: التوفيق بين العقل والنقل، بين الأصالة والمعاصرة، بين التراث والتجديد، بين الفلسفة والدين.. وكما أشرتُ، فرغم تغيُّر الظروف وتبدل الأحوال التي طُرح فيها سؤال النهضة الكبير، والمتمثل في: "لماذا تخلَّف العرب والمسلمون، ولماذا تقدَّم غيرهم؟"، رغم تغيُّر الظروف وتبدل الأحوال التي طُرح فيها هذا السؤال، إلا أننا لا نزال ندور في نفس الإجابة التقليدية، إما الاكتفاء بالتراث وحده، أو رفضه كليةً، أو محاولة التوفيق بين التراث ومستجدات الحداثة الغربية. لكن ثمة استثناء مهم من ذلك، وهو ذلك التيار الذي حاول دراسة التراث والفكر الديني دراسة نقدية. هذا التيار الذي يمثله نصر أبو زيد وعلي مبروك يمتد إلى الشيخ أمين الخولي وتلميذه محمد أحمد خلف الله. ولكن لأسباب عديدة ظل هذا التيار محاصرًا في الثقافة المصرية ومتهَمًا في أعين رجال الدين المحافظين.. المحاولات الأهم في رأيي جاءت من بعض المفكرين التنويريين أمثال زكي نجيب محمود، وفؤاد زكريا، ومحمود أمين العالم، ومحمود إسماعيل..
لقد حان الوقت لهجر النقاش حول مسائل وقضايا وهمية كقضية التراث والتجديد أو الأصالة والمعاصرة، والتركيز على القضايا الحضارية والعلمية المصيرية التي تمثل محور انطلاق أي مجتمع في ركب التقدم الإنساني. لقد تعلمت أوروبا الدرس جيدًا منذ مطلع العصور الحديثة، فبدأت ثورة المنهج على يد ديكارت، وأعقبها تأسيس المذاهب الفلسفية الكبرى التي جاءت مختلفة ومتنوعة تبعًا لاختلاف المناهج وتنوع الرؤى، وفي الوقت ذاته وقعت ثورة التنوير والحداثة الأوروبية التي رفعت شعار إعمال العقل والعلم في شتى المجالات، واستمرت ثورة الحداثة وأولوية العقل في القرن التاسع عشر.. وباختصار ينبغي أن يكون لدينا إيمان بالعلم كقيمة حضارية وبالتكنولوجيا كوسيلة للتطوير وبالثقافة كأداة للحفاظ على مكتسبات الحضارة والتعامل مع الأزمات وتخطيها، كل هذا يمثل المحاور والركائز الأساسية للحفاظ على مكتسباتنا الحضارة ونقاط دفع للحاق بقطار التقدم الذي لا يرحم ولا ينتظر أحدًا..
- هل يمكننا القول إن الثقافة العربية أنتجت وبلورت خلال السنوات الماضية سؤالًا فكريا ثقافيا عربيا جامعا؟
رغم المحاولات العديدة من المفكرين العرب في القرن العشرين، فإنه لم يكن ثمة سؤال مركزي هو الذي يشغلهم- باستثناء سؤال النهضة القديم- ولكن يبدو لي أن المدرسة العقلانية في الفكر العربي التي أسس لها محمد عبده وأمين الخوالي لا تزال موجود بقوة، نذكر هنا كتابات الدكتور أحمد سالم أستاذ الفكر العربي بجامعة طنطا التي يحاول من خلالها الإسهام في في إجابة عن السؤال المركزي حول ماهية التجديد.
- كيف تنظر لحركات الإسلام السياسي؟
نظرتي إلى خطاب الحركات الإسلامية هي نظرة لخطاب فاشل في الأساس لم يستطع حتى الآن تحقيق أي نجاحات ملموسة على أرض الواقع، وهنا يمكن أن أُعيد ما طرحته في كتابي "الدين والثورة بين لاهوت التحرير المسيحي واليسار الإسلامي" 2016، حيث أرجعت إخفاق الحركات الإسلامية إلى مجموعة من الأسباب التي حالت دون مواكبتها للتحولات الجديدة في المجتمعات العربية، ومن هذه الأسباب: (1) غياب البعد الاجتماعي للإصلاح؛ (2) انشغالها بالعمل التنظيمي والتعبوي، على حساب الجوانب الفكرية؛ لأن أقصى ما كانت تطمح إليه هو الاعتراف بها، من قبل السلطة الحاكمة، كأحزاب سياسية، تستطيع من خلالها الوصول إلى السلطة؛ (3) طغيان الجوانب العقائدية والأصولية في فكرها؛ (4) سيادة مَبْدأ التكفير، والعنف في نهجها السياسي، وتعطش بعض أنصارها للسلطة؛ (5)وأخيرًا، فقدان الضمانات الحقيقية للاهتمام بالأبعاد الاجتماعية في الدين.
الحركات الإسلامية ما تزال في حاجة إلى بلورة مفاهيم الإسلام الاجتماعي في صيغ مُعاصرة، كما أن عليها تحليل واقع المجتمعات العربية والإسلامية؛ حتى يتسنى لها فَهْم مظاهر الخلل والحيف وأسبابه، والوصول إلى بلورة حلول بديلة. كما أنها ما تزال في حاجة إلى مزيد من الضمانات حتى لا تتغير مواقفها الإيديولوجية، وحتى تبقى الرؤى التقدمية في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع قائمة، خاصة بعد أن تَتَسلم هذه الحركات السلطة. والواقع أن معظم هذه الحركات، التي تضمر منذ زمن بعيد، هدف إقامة دولة إسلامية، استشعرت بعد تسلمها السلطة بعد الثورة بدنُوَّ اللحظة؛ فما لبثت أن انقلبت على المضامين الاجتماعية للدين، والتي ارتكز عليها خطابها قبل ثورات الربيع العربي. ومع أن هذه الحركات تتشدق بتأييد مفاهيم الحرية، والديمقراطية، والحزبية السياسية، فإنه يوجهها دائمًا الاعتقاد بأن العودة إلى أصول الإسلام هو الحل لكل شيء. فهدفها الأكبر إِذَنْ هو إقامة الدولة الإسلامية (حسب فَهْمها هي)، و(أسلمة) المجتمع؛ إما من القاعدة صعودًا لأعلى، أو- إذا أتيحت لها فرصة الوصول إلى السلطة أو في وقت تكون فيه على يقين تام من الحصول على السلطة- من القمة نزولًا لأسفل، كما حدث في التجربة الإيرانية بعد ثورة 1979، والتجربة السودانية بعد انقلاب 30 يونيو 1989م (للمزيد حول هذه المسألة، يمكن الرجوع إلى كتابي السابق الذي أشرنا إليه).