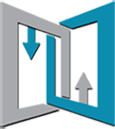الناقد مدحت صفوت: التعصب للتراث والسلف ليس مقصورًا على السلفيين فحسب، فهناك بعض "التنويرين" الذين لم يبرحوا القرن السادس
الإثنين 16/أبريل/2018 - 01:47 م
طباعة

مدحت صفوت ناقد أدبي وباحث بتحليل الخطاب. عمل كمحاضر زائر في جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، وحاضَر في عدد من المراكز البحثية المصرية، حاصل على درجة الماجستير في تحليل الخطاب، يكتب في المحاور النقدية ونقد الخطاب الديني الأصولي، له كتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان «السلطة والمصلحة.. استراتيجيات التفكيك والخطاب العربي»، وله قيد الطبع "جناية الفقهاء: تمارين على طرح الأسئلة". ومن هذه الخلفيات الثقافية المتعددة كان لنا معه هذا الحوار
في الوقت الذي ينادي البعض باعتماد فكر ابن رشد لتحدي الأصولية نجدك تهاجمه، فلماذا؟
جوهر المسألة ليس الهجوم على ابن رشد ولا الوقوف في صفه، فلسنا في صراع ولا تنافس، إنما البحث في الدراسات الإنسانية غرضه التحاور والفهم، ومن ثم فإنني استهدف في المقام الأول فهم أبي الوليد ابن رشد، وأشدد على أن الحاجة الرئيسة لابن رُشد الآن هي فهم ابن رُشد، والإحاطة برؤيته، وفلسفته أولًا في إطار زمنه وسياقه التاريخي بالقرن السادس الهجري، ثم نقد ابن رُشدٍ والرُشديةِ، أو حتى نقضهما وتقويضهما على النحو الذي يسمح بتجاوزهما وتخطيهما، وتقديم رؤية راهنة تكون بالتبعية ابنةً للسياق الحضاري والثقافي الذي نعيش فيه.
وأقصد فهم ومعرفةَ الرُشدية من كتاباتها لا من الصور المُتخيلة التي رسمها كثيرٌ من باحثيّ ومفكريّ العصر الراهن. ونتيجةً للفهم لا مانع أن نوجّه نحو الموروث الرُشدي معاولَ الهدم حدّ مفهوم مارتن هيدغر، أو التفكيك برؤية جاك دريدا، الأمر الذي يصبح معه السؤال عن عقلانية ابن رشد مشروعًا.. هل كان حقًا ابن رشد عقلانيًا تنويريًا مفارقًا لزمانه ومكانه؟
الخلاف ليس فقط مع ابن رشد وإنما مع «الرشديين الجدد»، ومشروع التنوير القائم على الرشدية، ومع الباحثين العرب المشتغلين بالفكر والفلسفة، والباحثين عن آليات الاستنارة الحديثة، الذين حاولوا أن ينتجوا قراءة فلسفية للموروث وفق رؤية عقلانية نقدية، وإعادة تحرير المُحدث طبق منطق علمي رصين، الأمر الذي لم يخلُ من اسقاطات إيديولوجية، بلغت عند بعضهم أن تصير هي الخيط الناظم للرؤية الكلية للتراث، وفي خضم الصراع ما بين الخضوع الإيديولوجي في قراءة التراث وإنتاج قراءة موضوعية، توزع جهد المفكرين العرب وتشتت في أحايين كثيرة، بين التنظير التقعيريّ والممارسة المشتبكة مع الواقع.
وما ملامح الصورة المتخيلة؟
التعصب للتراث والسلف ليس مقصورًا على السلفيين فحسب، فهناك بعض "التنويرين" و"العقلانيين" الذين لم يبرحوا القرن السادس الهجري، وتنتمي أطرهم الفكرية إلى عصر مرّ عليه تسعة قرون على الأقل. من بينهم التنويريون الرُشديون في عصرنا الحديث، الذين تعاملوا مع التراث الرُشدي خارج أُطر التاريخ، وهو منطق الأصوليين الذين يتعاملون به مع التراث الديني، بوصفه بطبيعة لا تاريخية، متجاوزًا الأُطر الزمكانية، وبات النصّ الرُشدي في عيون المحدثين كنصّ أرسطو من وجهة نظر أبي الوليد نفسه "منتهى ما وقفت عليه العقول الإنسانية".
من بين هؤلاء في اعتقادي الباحث الدكتور عاطف العراقي الذي عُرف بحبه وغرامه بفلسفة ابن رشد، وظل خمسين عامًا مخلصًا لقراءة الرشدية، ورافعًا لواء إعادة إحياء ابن رشد مرة أخرى. ومع نبل الغاية التي استهدفها العراقي وهي إشاعة التنوير ونشر العقلانية، فإننا نعتقد أن أدواته كانت إمّا "سلفية" وإمّا "دوجماطيقية" في أغلب جوانبها، وبدتْ لغته في كثير من سماتها انفعالية وغير علمية، يصيبها الانفلات وتفتقد إلى الانضباط.
كما ينحو عابد الجابري للتراث الرشدي كمطية إيديولوجية يمرر من خلالها تصورات غربية ومنتج فكري واجتماعي أوروبي مثالًا على ذلك أن يتقول بأن ابن رشد أول من دعا إلى فصل الدين عن الدولة، وذلك من خلال افتراض الجابري أن ابن رشد سمّى كتابه المعروف بـ"الضروري في السياسة" بـ"الضروري في العلم المدني"، استنادًا إلى فقد أصل الكتاب وبقاء النسخة المترجمة إلى العبرية، واستثمارًا لما تسقطه كلمة "مدني" من دلالات حديثة اكتسبها المفهوم عبر القرنين الأخيرين. وعلى الرغم من أن مفردة مدني دلت في مخطوط الضروري في السياسة على المعارف التي من شأنها أن يعلمها الإنسان ويعملها، أي العملية، فإن الجابري يفرط من استخدام "مدني" كمحاولة لتقويل ابن رشد أن ميدان السياسة "الحكم" منفصل تمامًا عن ميدان الشرع والدين، وهي رؤية بعيدة تمامًا عن سياقات العصر، ومتأخرة زمنيًا عن ابن رشد، لكن الغرض الرئيس هنا هو امتطاء ابن رشد إيديولوجيًّا، وتحويله إلى قناع يتحدث بلسان المفكر العربي المعاصر، وكي يمكن للمعاصر تمرير خطابه عبر قوة الأسلاف وما يتمتعون به من رأسمال رمزي وسطوة ثقافية.
هل قامت نهضة أوروبا فعلا على ترجمة ابن رشد؟
تأكيد العبارة على الإطلاق ليس صحيحًا، ونفيها كلية أيضًا أمر خاطئ، لقد عانى ابن رُشد وميراثه الفكري من التقول عليه مثلما عانى في محنته ونكتبه مع الخليفة المنصور الموحديّ، وكانت الجريرة الجديدة والواقعة في العصر الحديث بسبب "التنوير" والمحاباة لابن رُشد وليس "الجمود" أو الرفض للتفلسف وعلم الكلام.
إذ احتاج كتاب التنوير"العربيّ" إلى آباء يأسسون لهم حداثهم المنشودة، ويكسبون طروحاتهم أصالة تاريخية، فراحوا يفتشون عمّا يساند أفكارهم، ليقعوا في كثيرٍ من الأحايين في شرك ليّ عنق الخطابات التاريخية وانتزاعها من سياقها، فصار أبو ذر الغفاري شيوعيًّا ماركسيًّا! وأصبح ابن خلدون مفسرًا ماديًا للتاريخ، وصارت فرقة المُعتزلة عقلانيّةً تقدميّةً تُدافع عن "العدالة الاجتماعيّة".
لماذا نضع افكار ابن رشد في مواجهة الغزالي وابن تيمية وهل هذه المواجهة صحيحة؟
لسنا من يضع هذه الثنائيات، وإنما السياق الثقافي القائم على الازدواج والثنائيات، وهو نظام ميتافيزيقي في أصله، فطالما يوجد الأبيض لابد من ألسود، وثمة أفضلية لأحد الحدين داخل السياق التقليدي، ولأننا نعيش سياقات تقليدية، حلّ أبو حامد الغزالي في مواجهة ابن رشد، وهي ثنائية غير دقيقة، فالرجلان لا يتناقضان في جوهر موقفهما، وإن بدا تناقضًا واختلافًا شكليًا.
إن الغزالي حاضر في كتابات ابن رشد، في صورة الشبح، بمفهوم جاك دريدا، يطرح التساؤل الرئيسي، ألا وهو موقف الشرع من علوم الفلسفة، لتبدو كتابات ابن رشد بخاصة «فصل المقال» كفتوى وحيثياتها بشأن إباحة الفلسفة والمنطق، وردًا على الغزالي الذي يكرر في أكثر من مؤلف وكتاب كـ"الاقتصاد في الاعتقاد" و"إلجام العوام عن علم الكلام" و"فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" و"المنقذ من الضلال" و"تهافت الفلاسفة"، تحذيراته من كتب الفلاسفة لأن الأمر "آفة عظيمة، لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم". وشبح الغزالي لا يتوقف على تحديد التساؤلات، وإنما يتسلل إلى خطاب "فصل المقال" في انتظام حتى يتمكن في النهاية موقف الغزالي من فرض رؤيته ولو بشكل غير معلن، وينتهي ابن رشد كهنوتيًا. وتبدو الغاية الكبرى من "فصل المقال" جزءًا من غاية فلسفة ابن رشد في كُليتها، المتمثلة في "عقلنة الإيمان"، أيّ إصباغ الإيمان بالصبغة العقلية، هل يمكن القول بتبرير الإيمان عقليًا؟ أعتقد أنّه بإمكاننا ذلك.
وماذا عن ثنائية ابن رشد وابن تيمية؟
هي ثنائية خاصة بالأكاديمي مراد وهبة، الذي صور ابن تيمية بالشيطان منبع الجهل والتخلف والشرور التي تحيط بالسياق العربي والإسلامي برمته، فيما تجلى ابن رشد كأيقونة التقدم والعقلانيّة والحلول التي سبقت مراحل الحداثة وما بعدها وما بعد بعدها منذ القرن السادس الهجري! وهي صورة متخيلة عن ابن رُشد اخترعها بعض الكتاب العرب ومنهم وهبة، ولا تمت لفيلسوف قرطبة بشيءٍ.
والسؤال: لماذا اختار وهبة ابن تيمية ليكون نقيض ابن رشد؟ فطالما الأمر سيقتصر على ثنائية "خير/ شر" لماذا لم يكن رمز التخلف والجمود هو الغزاليّ؟ ربّما تكمن أسباب هذه الثنائية "الوهبية" نسبة إلى مراد وهبة، مردها الشكلي هو الاختلاف الجليّ بين ابن تيمية وابن رشد في قضيتي، التفسير الحرفي والتأويلي للقرآن، والموقف من النظر في كتب الأسبقين.
هل لنا من شرح أكثر؟
جاء ابن تيمية امتدادًا لمشروع التفسير الحرفي للقرآن، الأمر الذي انتهى بتفسير آيات الصفات الإلهية نصوصيًا أنتج عنه رؤية تجسيدية للذات الإلهية، فأصبح لله يدان وقدمان ووجه، ويجري عمليات صعود وهبوط، كما يمارس الضحك والغضب. الخ، طبقًا للرؤية التجسيدية للنص. وفيما يخصّ المسألة الثانية، وضع ابن تيمية كتاب "الرد على المناطقة"، بيّن فيه أن "المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي، ولا ينتفع به البليد" بينما كان موقف الرُشدية هو التأويل في الأولى وكيفيته إخراج اللفظ من دائرة الحقيقة لدائرة المجاز، واعتبر في القضية الثانية أن النظر في كتب الأسبقين واجب شرعي.
ومع ذلك، ثمة أسباب أخرى يمكن تكشفها وراء اختيار مراد وهبة لوضع ابن تيمية مقابل ابن رشد، تلخصها موقف مراد وهبة من السلطة السياسية والسلطة الدينية الرسمية، ويمكن أن نشير عليهما في مراحل ما كونهما سلطة واحدة، نتيجة التوافق وتلاقي المصالح. في اعتقادنا، كانت ثنائية مراد وهبة مخرجًا للهروب من مواجهة الأزهر والرؤية الأشعرية، فالاعتماد على الثنائية السائدة "الغزالي/ ابن رشد" يعني وضع نسق الغزالي برمته موضع الخصم بالنسبة لوهبة، ويجر ذلك بالتبعية خصومة المؤسسة التي اعتمدت منذ قرون الأشعرية عقيدة لها، ومثّل الغزالي "حجة الإسلام" لديها ومُنقِذ الأمة من ضلالها.
إن مواجهة سلطة دينية غير رسمية، وتبدو هامشية كالجماعات الدينية المستندة إلى تنظيرات ابن تيمية لعلها أسهل بالنسبة للمثقف الذي يولي السلطة جانبًا كبيرًا من حساباته، وربما يتهم منتقديها بـ"الخيانة" كما حدث من وهبة. ويمثل بذلك وهبة صورة متأرجحة بين حالتي "مثقف الخانة الآمنة" و"مثقف السلطة"، الأول فريق نخبوي يعيش في برجه، بعيدًا عن قضايا المجتمع الحقيقة، أو بتعبير أدق، العملية ذات الصلة المباشرة بالإنسان العادي، مفضلًا البقاء في "الخانة الآمنة" وعدم الاشتباك مع الواقع المعيش وتبريره أحيانًا. أمّا الفريق الآخر فيتمثل في مَن "لم يضبط المسافة" بينه وبين المؤسسات المتهالكة والمتجذرة في التسلط والديكتاتورية، وارتضى بكامل إرادته أن يكون ترسًا في ماكينات طحن الفقراء وقهرهم، مترجلًا إلى أحضان السلطة لا لتبرير الواقع فحسب؛ بل لتزييفه أيضًا.
على أيّ حال، من وجهة نظري، تبدو كل حوارات وأحاديث وهبة عن العلمانية والتعددية "فشنك"، تصدر بالأساس من مصدر أصولي علماني، إذ لا تقتصر الأصولية على الدينيين فحسب. فالأصولية موقف الذين يرفضون تكييف عقيدة أو إيديولوجية مع الظروف الجديدة، بتعبير روجيه جارودي، وهي نسق يستند على الجمود والتصلب ومعارضة التطور، والتشدد في الانتساب للتراث ومُنتج السلف، سواء كان السلف متمثلًا في ابن تيمية أو ابن رشد، كلاهما سلف وكلاهما ماضِ سحيق. كما تستند الأصولية على عدم التسامح ورفض الآخر، واللجوء إلى العنف لتطبيق التعاليم أو تمرير الرؤية المنتسب إليها الأصوليون.
ما الجسور التي تربط بن الأصولية والتراث؟
يدفعنا هذا السؤال إلى تحديد ماهية الأصولية، وهل هي مرتبطة بالنسق الديني فحسب، أم أنها نسق فكري يمكن أن يتمثله الدينيون وغيرهم؟ في اعتقادي الأصولية نسق عام يحيط بالخطابات ويسيطر عليها مع اختلاف نوعيتها ومرجعياتها ومستوى لغتها، وتتخذ شعارات إيديولوجية متباينة، دون أن يكون لها سند ديني. واليوم يبدو أن مصطلح "الأصولية" يوظف بطرق متباينة؛ منها، توظيفه بوصفه علامة على الحدة والعدائية، ما يعني أنه صفة عائمة بحريةٍ، وليس شرطًا أن يشير إلى وجود التزام عقائدي معين أو موقف لاهوتي. وبات المصطلح يتضمن الحدة الدوجمائية في رفض التعامل مع الآراء المعارضة، الأمر الذي استتبع توسيع دائرة المفهوم ليصل حد ما يسميه "رود ليدل" بـ"الأصولية الإنسانية". ولم تعد الأصولية، حسب جيرارد بكير، تشير إلى ما يعتقد، ولكن إلى كيفية الاعتقاد.
إذن الأصولية نسق يستند على الجمود وعدم التسامح ورفض الآخر، واللجوء إلى العنف لتطبيق التعاليم أو تمرير الرؤية المنتسب إليها الأصوليون. وسياسيًا هي نمط من الأعمال السياسية والاجتماعية تعبر عن علاقة وثيقة بين عقائد المرء الأصولية، وبين سلوكه في الحقلين السياسي والاجتماعي من أجل تحقيق غرض ما: كإشاعة فكرة أو مفهوم، غرس في عقيدة ما في الأذهان، أو التضحية من أجل تحقيق غايات، هي باعتبار الدعاة جليلة ومطلقة ولا تقبل المساومة أو التسوية. ما يذهب بنا إلى الاتفاق مع التصورات التي ترى النازية أصولية تستند على تصورات "علمية" وفلسفية، وليست رؤية عقائدية، تؤمن بالتفوق العرقي للشعب الألماني، ورفض أدولف هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها فكرة دينية وحيلة يهودية مسيحية.
وكان من الملاحظ، أن المفهوم استخدم، خلال السنوات الماضية، للتوظيف في سياقات الحديث عن الإسلام، وما تنتجه حركات الأصولية الإسلامية من أعمال عنف ببلدان عربية وغير عربية عدّة، ورأت المسيحية أو هكذا حاولت تصور أن المواقف التي تستند إلى الكتاب المقدس، تنجو في كثير من الأحيان من وصفها بأنها "أصولية". وظل المصطلح يسم الخطابات الإسلامية، علاوة على ذلك؛ فإن منح الأصولية مصدرًا مسيحيًا يجعل المصطلح سيئ التركيب في وصف جوانب من الأصولية الإسلامية. كما حاولت "اليهودية"، أن تتبرأ أو تصور نفسها بعيدة عن المناحي الأصولية، ونشرت ميديا الكيان الصهيوني، بوصفه قلعة اليهودية/ الدولة اليهودية في العالم، صورة "حداثية" وتقدمية عن المعتقدات اليهودية، مركزة جلّ اشتغالاتها على وصم الإسلام والمسلمين بالسمات الأصولية، والراديكالية، واتهامهم بممارسة العنف ووحدهم دون غيرهم، وإن بدت لي اليهودية أم الأصوليات الثلاثة.
"الشَرك" نفسه وقعت فيه خطابات عربية، من بينها خطاب علي حرب، الذي رأى أن "خطيئة" المعتقد الاصطفائي التي قوامها احتكار المشروعية وممارسة الوكالة الحصرية على شؤون الأمة والبشرية جمعاء، من خلال الإدعاء بامتلاك مفاتيح الاستقامة والسعادة، وأسرار النمو والتقدم والرقي الحضاري، هي خطيئة تلتصق بعقلية المسلم دون غيره، فالمسلم، ووحده، عند علي حرب هو الذي يؤمن بنرجسية ذاته وأشرفية جماعته وحتمية رسالته وعالميتها، والمسلمون هم أهل الصراط المستقيم والنهج القويم، وهم أصحاب "اليقين الدوجماطيقي"، في تقديس نص كتاب، لا يأتيه الباطل من خلفه ولا أمامه، مسقطًا من الحسبان أن السمات الأصولية لم تنج منها ديانة، إبراهيمية أو غير إبراهيمة. علاوة على أن مصطلح الأصولية ذاته نشأ بالبداية لتوصيف حركة بروتستانتينية تعود جذورها إلى منتصف القرن التاسع عشر، دعت إلى التفسير الحرفي للكتاب المقدس والعمل على تنقية المجتمعات من المظاهر غير المتوافقة مع تعاليم الكتاب ووصاياه. ناهيك عن الممارسات التاريخية للأصولية المسيحية في العصور الوسطى، كالحروب الاستعمارية للشرق المغلفة بخطاب عقائدي والمعروفة باسم الحروب الصليبية في الأدبيات الغربية، وحروب الفرنجة بأدبيات المؤرخين العرب القدامى. كذلك محاكم التفتيش التي بدأت أوائل القرن الثالث عشر الميلادي 1233م، والحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك التي استمرت على مدار قرنين، وحديثًا هناك جيش الرب في أوغندا، كما تشهد أفريقيا الوسطى ممارسات أصولية وعنف دموي على أساس ديني من قبل السكان الكاثوليك.
نعود لنقطة علاقة الأصولية بالتراث، الإشكالية الرئيسية هي تحميل التراث بأكثر مما يحتمل، الجميع «تنويرين وسلفيين» يتعامل مع التراث ليقدم الأخير لنا "روشتة" Prescription تنويرية لحل مشكلاتنا، أو ليرسم لنا طريق الخلاص الفكري من الأزمات التي تتلاحق علينا.
ينقلنا ذلك الي كيفية قراءة التراث وماهي قواعد الاسترجاع والاستبعاد في التعامل معه.؟
لسنا في حاجة إلى التراث إلا لفهم التجارب السابقة، واستنباط الدروس من التجارب التاريخية، وهنا يتساوى تراثنا العربي وتراث باقي الإنسانية، فالتراث نتاج ممارسات الناس في ضوء سياقات اجتماعية واقتصادية، وعلينا أن ننتج بدورنا مفردات تعاملاتنا، وأن نبحث عن وصفات علاج الأزمات بمنطق العصر الراهن. وأعتقد أننا في حاجة إلى تحويل الموروث «الموتى الأحياء فينا» إلى مادة مُتحفية، هنا أعني الموروث على درجات تباينه، وهي الإشكالية التي غابت دومًا عن مشاريع النهضة العربية. على النقيض جاء المشروع الفكري العربيّ في القرنين الأخيرين متسمًا بوحدة العتبة التي انطلقت منها الفلسفة الإسلامية، وهي انطلاقة مركبة ومتداخلة بدرجة كبيرة، فهذا الطرح الفكري والثقافي الطارئ على البنية العقلية العربية، شقّ طريقه في مسار الإنتاج النظري والتطبيقي قبل أقل من قرنين، وازدهر بدرجة كبيرة في الربع الأول من القرن العشرين، متكئًا إلى آليات عقلانية ونقدية «غربية»، في إطار الإجابة على سؤال الهُوية والدفاع عن المنجز الفكري العربي في مواجهة تيارات الاستشراق - الغربية، المتعالقة مع موجة استعمارية واسعة تسيطر على الخارطة والأفق السياسي والاجتماعي للمنطقة.
أدى التناقض في النهاية إلى إنتاج مشروعات نقدية متذبذبة، أحيانًا ينتصر فيها الذاتي دعمًا للهُويّة الوطنيّة والاستقلال السياسي، وأحيانًا تعلو فيها آليات الفلسفة والنقد والتحليل، مدعومة بالأطر السيموطيقية والهرمنيوطيقية للاشتباك مع النصوص والخطابات، فينتصر الموضوعي مثيرًا أسئلة مركزية وكاشفًا عن إضاءات عضوية لمساحات من الالتباس، أو التلبيس، في التعامل مع التراث بمستوياته الإنتاجية والدلالية.