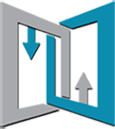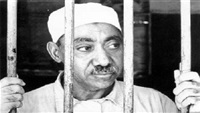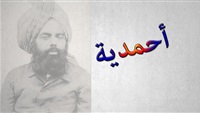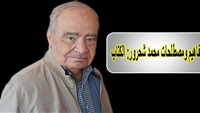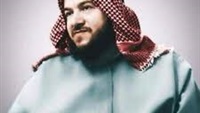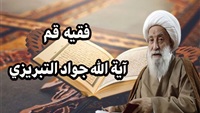بين النقد والادعاء: مأزق خطاب نقد التراث عند محمود جابر
الإثنين 15/سبتمبر/2025 - 06:05 ص
طباعة
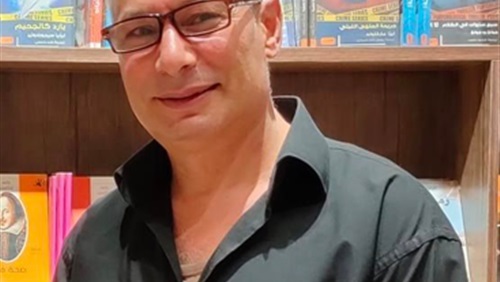 حسام الحداد
حسام الحداد
نشرت بوابة الحركات الإسلامية موضوعًا بعنوان: «دراسة جديدة لمحمود جابر حول أدعياء نقد التراث فراس السواح نموذجًا». وقد استوقفني في هذا الطرح عدد من الملاحظات على خطاب الأستاذ محمود جابر، أرجو أن يتسع صدره لها، وأن يتعامل معها بالجدية التي تليق بباحث ما زال يعكف على إنجاز دراسته. فالملاحظات لا تهدف إلى الجدل الشخصي، بل إلى إثراء النقاش وإتاحة أفق أوسع للحوار العلمي.
يقدّم محمود جابر في نصّه تقسيمًا صارمًا بين من يصفهم بـ«النقد العلمي المنضبط» ومن يسميهم «أدّعياء النقد» الذين ـ في رأيه ـ يعيدون تدوير أطروحات استشراقية قديمة بمنهج انتقائي ضعيف. هذه المقاربة لا تكتفي بوصف الحالة المعرفية، بل تصوغ خطابًا تمييزيًا يتبنّى آليات لغوية وأخلاقية لها تبعات على مستوى النقاش الفكري والسياسي. فالمسألة لا تتعلق بمجرّد تقييم أكاديمي للمنهج، بل بترتيب الحقل المعرفي على نحو يُقصي أطرافًا ويمنح الشرعية لآخرين.
هذا الترتيب يثير سؤالًا أساسيًا حول طبيعة «النقد» نفسه: هل هو ممارسة فكرية مفتوحة لاختبار المناهج والأفكار، أم أداة مؤسساتية لضبط المجال وإخضاعه لمعايير مسبقة؟ حين تُستخدم التسمية (من «نقد» إلى «ادعاء») كأداة لإغلاق الحوار، يتحول النقاش إلى فضاء مشوب بالوصم بدل أن يكون مجالًا للتفكير الحر. لذلك فإن تحليل خطاب جابر يتجاوز مضمون أحكامه إلى مساءلة بنيته وآثاره: كيف تُبنى الشرعية المعرفية؟ ومن يملك حق تحديد معاييرها؟
التسمية كأداة للرفض: من «نقد» إلى «ادعاء»
عندما يختار محمود جابر توصيف بعض الكتّاب بـ«أدّعياء نقد التراث»، فهو لا يكتفي بوضعهم في خانة الاختلاف المنهجي، بل يمنح الحكم بعدًا أخلاقيًا ومؤسسيًا في آن واحد. التسمية هنا ليست وصفًا بريئًا، بل أداة خطابية تعمل على نزع الشرعية من الفعل النقدي ذاته، وتحويله من ممارسة فكرية قابلة للنقاش إلى «ادعاء» فاقد للمصداقية. بهذا الشكل، يُغلق الباب أمام التعامل مع هذه القراءات كاجتهادات معرفية لها ما يُؤخذ منها وما يُردّ، ويُفتح بدلًا منه باب الشك في نواياها ومصداقيتها من الأساس.
هذا الاستخدام للتسمية يقوم على ما يمكن تسميته بـ«الوصم الخطابي»، إذ يجري استبدال النقاش العلمي التفصيلي بأداة بلاغية تختزل كل جهد فكري في خانة سلبية. فبدلًا من مساءلة منهج فراس السواح ـ مثلًا ـ وفق قواعد تحليلية واضحة (سلامة النقل، التوثيق، اتساق الحجة)، يتم الاكتفاء بوسم مشروعه كـ«ادعاء» يفتقر للمنهجية. وبهذا تتحول التسمية إلى بديل عن البرهنة، وتُستدعى كحاجز معرفي يسبق أي حوار متكافئ بين أطراف الجدال.
والتناقض الجوهري يكمن في أن جابر نفسه يدعو في مواضع أخرى إلى «الجرأة في طرح الأسئلة حول التراث»، لكنه يربط هذه الجرأة بشرط الانضباط في إطار معرفي صارم يحدده هو. فإذا جاءت الأسئلة من خارج هذا الإطار، سرعان ما يجري نزع صفة «النقد» عنها واستبدالها بصفة «الادعاء». وهنا يظهر التعارض بين الدعوة المعلَنة إلى الانفتاح النقدي، وبين الممارسة الفعلية التي تؤسس لخطاب إقصائي يضيّق مساحة الاختلاف المنهجي ويحوّله إلى وصم يقيني.
الحرص على «الصرامة» مع ثغرات في المنهجية الخطابية
يقدّم محمود جابر نفسه باعتباره حارسًا لمعيار «الصرامة العلمية» في دراسة التراث، فيرصد ما يراه ثغرات في كتابات بعض النقّاد، مثل غياب التوثيق المفصّل أو اعتمادهم على مصادر منتقاة بعناية لتأكيد فرضيات مسبقة. هذه الملاحظات في ظاهرها مشروعة، إذ لا خلاف على أن البحث الرصين يتطلب دقة في النقل، وإحالات واضحة، وتدرجًا منطقيًا في الاستدلال. غير أن النصّ يكتفي بإطلاق هذه الأحكام دون أن يقدّم آلية معيارية دقيقة تُبيّن متى يكون الاستشهاد ناقصًا، أو كيف يمكن التفريق بين الانتقاء الممنهج والاختيار المشروع للأمثلة التحليلية.
المفارقة أنّ جابر، في الوقت الذي يطالب فيه خصومه بالتوثيق المحكم والتحقق الصارم من المصادر، لا يطبّق المبدأ نفسه على خطابه النقدي. فهو يذهب إلى القول بأن النتيجة الطبيعية لكتابات فراس السواح وأمثاله هي «شيوع الشك العشوائي في التراث»، لكنه لا يدعم هذه النتيجة بأدلة إحصائية أو دراسات استقصائية توضّح حجم التأثير الفعلي لهذه الكتابات في وعي القرّاء. هنا تتحول دعوته إلى «الصرامة» إلى ممارسة خطابية انتقائية: تُلزم الآخر بالتدقيق التفصيلي، بينما يكتفي هو بعبارات تقريرية عامة.
هذا التناقض يكشف عن فجوة بين الادعاء والممارسة: فبينما يؤكّد جابر على حياد العلم ودقته كشرط لأي نقد جاد، ينزلق خطابه إلى التعميمات والانطباعات غير الموثقة. النتيجة أن خطابه يفقد شيئًا من مصداقيته، إذ يعيد إنتاج ما ينتقده: الاعتماد على لغة تقريرية بلا براهين كافية. بهذا المعنى، تصبح الصرامة التي ينادي بها مجرد شعار خطابي أكثر منها منهجًا معرفيًا يُحتكم إليه بموضوعية وشفافية.
الإسقاط الثنائي: النصّ المقدّس مقابل الأسطورة
يعتمد خطاب محمود جابر على ثنائية حادّة بين «النص المقدس» و«الأسطورة»، ويضع بعض النقّاد في خانة من يخلطون بينهما حين يطبّقون أدوات تحليلية مشتقة من دراسة الموروث الشفهي على القرآن الكريم. غير أنّ هذا الطرح يتجاهل أن أدوات التحليل الأسطوري لا تعني بالضرورة إنكار القدسية أو نفي الوحي، بل قد تُستخدم كمدخل لفهم البنية السردية أو الوظيفة الرمزية للنصوص. أي أنّ التعامل مع القرآن ضمن أفق المقارنة الأسطورية لا يساوي بالضرورة إنزاله إلى مرتبة «الحكاية الشعبية»، بل قد يكون محاولة لاستكشاف كيف استوعب النصّ خطابًا ثقافيًا سابقًا وأعاد صياغته بوصفه وحيًا مؤسِّسًا.
الإشكالية هنا أنّ جابر يقدّم هذا الخلط بوصفه خطأً منهجيًا قاطعًا، من دون التوقف عند التنوع في مناهج الدراسات النصّية الحديثة. فالمقاربات التاريخية والأنثروبولوجية واللغوية لا تتعامل مع النصوص المقدسة على أساس ثنائية جامدة: إمّا «وحي مطلق» أو «أسطورة بشرية»، بل ترى أن النصوص تحمل طبقات متعددة من المعنى، منها ما يتصل بقدسيتها عند المؤمنين، ومنها ما يتصل بوظيفتها الثقافية والاجتماعية والتاريخية. إنّ إنكار هذا التعدد هو بحد ذاته إسقاط منهجي من طرف جابر، لأنه يفترض أن أي قراءة خارج القالب التقليدي هي بالضرورة إلغاء لخصوصية النص.
والتناقض يتضح أكثر عندما نلاحظ أن جابر يطالب بتمييز صارم بين «النص الثابت» و«التأويل التاريخي»، لكنه يتجاهل أن المناهج التاريخية نفسها تمارس هذا التمييز بشكل مرن. فالمؤرخ أو الباحث في علوم الأديان لا ينكر الفرق بين النصوص المؤسسة والتفاسير اللاحقة، بل يحاول ربطها بسياقاتها لفهم عملية التلقي عبر الزمن. بعبارة أخرى، الخطاب الذي يرفض إسقاط أدوات الأسطورة على النصوص المقدسة، يسقط هو نفسه في ثنائية تبسيطية تختزل جدلًا معرفيًا واسعًا في خيارين متقابلين، وتغفل عن إمكانية الجمع بين التحليل العلمي واحترام خصوصية النصوص الدينية.
الاحتكام إلى «الهوية الثقافية» كحكم نهائي
يُكثِر محمود جابر من الدعوة إلى «احترام الهوية الثقافية» بوصفه شرطًا لأي ممارسة نقدية للتراث، لكن هذا الاحتكام المتكرر يحوّل الهوية إلى أداة إغلاق للجدل بدل أن تكون إطارًا موسّعًا له. فبمجرد استدعاء الهوية كمعيار نهائي، تصبح أي قراءة خارج النسق المألوف موضع شبهة، إذ يُعاد تأويلها سريعًا على أنها مساس بالثوابت أو محاولة لتقويض الانتماء الجمعي. بهذا الشكل، لا يُناقَش النص وفق أدواته أو حججه، بل وفق مدى توافقه مع تصوّر مُسبَق عن الهوية، وهو ما يحوّل الحقل العلمي إلى ساحة اصطفاف هويّاتي يغلب عليه الدفاع لا التحليل.
هنا يبرز التناقض في خطاب جابر بوضوح: فهو يطرح شعارًا جذابًا عن «نقد معرفي منهجي يوازن بين احترام الهوية والجرأة»، لكنه عمليًا يُقصي كل مقاربة لا تنطلق من تعريفه الخاص لهذه الهوية بوصفها «ادعاء» فاقدًا للشرعية. وبذلك يُفرَّغ الوعد بالجرأة من محتواه، لأن الجرأة الحقيقية لا يمكن أن تزدهر في ظل معايير مسبقة تُحدّد مسبقًا ما هو مقبول وما هو مرفوض. إنّ الهوية، إذا تحوّلت إلى أداة حكم نهائي، تقيّد إمكانات النقد بدل أن تؤطّره، وتخلق مفارقة خطيرة: خطاب يعلن انفتاحًا على النقد، لكنه يمارس في العمق إغلاقًا منهجيًا.
الاستعانة بالاستشهادات الغربية كحجة نزع الشرعية أو تأكيدها
يلفت محمود جابر الانتباه إلى لجوء بعض النقّاد، مثل فراس السواح، إلى مقولات استشراقية قديمة دون مراعاة ما طرأ عليها من مراجعات أو نقد في الدراسات الغربية الحديثة. من حيث المبدأ، هذه ملاحظة وجيهة؛ فالعلم لا يقف عند جيل معين، والاعتماد على أطروحات متقادمة دون متابعة تطورها قد يضعف أي مشروع نقدي. غير أن المشكلة تظهر حين تتحول هذه الإشارة إلى أداة بلاغية لتشويه الخصم، من دون تقديم أمثلة دقيقة أو تحليل موثق يثبت أن هؤلاء النقاد أهملوا فعلًا أحدث الدراسات. بهذا الشكل، ينزلق الخطاب من نقد المنهج إلى وصم صاحبه، فيتحول البحث المعرفي إلى معركة إسقاط شرعية.
ويتعاظم التناقض عندما يُدين جابر اعتماد خصومه على الاستشراق القديم، بينما لا يلتفت إلى أن خطابه نفسه قد يُعيد إنتاج بنية مشابهة من الاعتماد على مصادر ذات طابع أيديولوجي أو سياسي، سواء في الدفاع عن الهوية الثقافية أو في صياغة موقف «وطني» بديل. فكما يمكن أن يتحول الاستشراق إلى سلطة معرفية مهيمنة، يمكن أيضًا أن تتحول الهوية أو الخطاب الوطني إلى سلطة موازية تفرض معاييرها مسبقًا على البحث. بذلك يصبح نقد الاستشراق القديم مجرد وسيلة لإحلال مرجعية أخرى محلّه، من دون مساءلة حقيقية لبنية الخطاب ذاته وأدواته في إنتاج المعرفة.
الخطاب والتأطير السياسي (قراءة سريعة لخطاب «الوهابية في مصر» عند جابر)
يُلاحظ في خطاب جابر حول «الوهابية في مصر» أنّه يربط بين البنية الفكرية للحركة وبين ظروفها الاجتماعية والسياسية، من خلال التركيز على دور المال في التمدد، وعلى آليات التغلغل داخل المؤسسات الرسمية والدينية. هذا الربط يبدو مقبولًا في ذاته، لكنه يفتح إشكالية منهجية بالغة الأهمية، إذ يستدعي التمييز بين مستويين من التحليل: المستوى الفكري الخالص الذي يشتبك مع النصوص والخطابات والمقولات، والمستوى السياسي-الاجتماعي الذي يفسّر انتشار تلك الأفكار داخل الواقع. الجمع بين المستويين دون توضيح الأدوات أو إعلان الانحياز المنهجي يُضعف الحُجّة، ويجعل القارئ أمام نص يبدو وكأنه يقرأ الفكر من منظور سياسي صرف.
الإشكال الأعمق يتجلّى في التناقض بين الدعوة المتكررة لدى جابر إلى «تنزيه النقد» عن التسييس، وبين ممارسته العملية التي تنفتح على قراءة سياسية واسعة للتجربة الوهابية كطائفة تاريخية. ففي حين يطالب بصرامةٍ بعدم إدخال الحسابات السياسية في النقد الفكري، نجده يفسّر جذور الوهابية من خلال تحالفاتها التاريخية، وقدرتها على استخدام السلطة والثروة في بناء نفوذها. هذه المقاربة تضعف من نقاء المنهج المعلن، وتُظهر النص وكأنه يراوح بين خطابين: خطاب نقدي يزعم العلمية، وخطاب سياسي يوجّه النظر نحو أبعاد النفوذ والهيمنة.
هذا التوتر يجعل الخطاب أقرب إلى أداة للصراع مع الخصوم منه إلى دراسة أكاديمية متماسكة. إذ تبدو السياسة حاضرة عندما تخدم غرضًا في إدانة خصوم فكريين، لكنها تغيب أو تُخفّف عندما يتقاطع السياق مع مواقف يوافق عليها الكاتب أو يتسامح معها. بذلك يتحوّل النص إلى مساحة مزدوجة: من جهة يرفع شعار الموضوعية العلمية في نقد التراث، ومن جهة أخرى يمارس انتقائية سياسية في تفسير الظاهرة الدينية. هذه المفارقة تطرح سؤالًا حادًا حول مدى التزام الخطاب بالمنهج النقدي المتوازن، أم أنه مجرد إعادة إنتاج للانحياز السياسي في ثوب نقد فكري.
قراءة بديلة ومنهجية مقترحة
حين تتعدد المقاربات في قراءة النصوص الفكرية والدينية، يصبح من الضروري اقتراح بدائل منهجية تضمن التوازن بين الصرامة العلمية والانفتاح النقدي. فالتجربة البحثية المعاصرة تكشف أن كثيرًا من الجدل لا ينشأ من جوهر النصوص نفسها، بل من غياب قواعد واضحة في ممارسة النقد: إما بسبب التعميم دون إحالة دقيقة، أو بسبب الارتهان لمنهج واحد يقصي غيره، أو بسبب تجاهل الخلفيات الذاتية التي تؤطر عملية الفهم. لذلك، فإن أي مقاربة جادة تحتاج إلى تأسيس إطار نقدي بديل، يقوم على الشفافية في الاستدلال، والانفتاح على تعددية المناهج، والقدرة على ممارسة نقد الذات قبل نقد الآخر.
هذا الإطار لا يسعى إلى إلغاء المناهج السابقة أو نفيها، بل إلى تطويرها وتجاوز حدودها الضيقة، بحيث يكون النقد نفسه أفقًا للحوار لا ساحة للإقصاء. ومن هنا تبرز ثلاث ركائز أساسية مقترحة: الالتزام بالإنصاف الإحالي الذي يعيد الاعتبار للنصوص في تعقيدها، والانفتاح على تعددية المنهج بما يعكس ثراء الظاهرة موضوع البحث، وأخيرًا الانعطاف النقدي الذاتي الذي يحصّن الباحث من وهم الموضوعية المطلقة ويحوّل النقد إلى فعل تواصلي منفتح.
أولًا: الالتزام بالإنصاف الإحالي
النقد الأكاديمي لفِرَق أو مفكرين يتطلب استنادًا صريحًا إلى نصوصهم الأصلية، وليس الاكتفاء بتعميمات أو أحكام تقريرية. فعندما يعرض الباحث مقطعًا نصيًا دقيقًا، ثم يقدّم اعتراضه عليه مدعومًا بالتحليل، يصبح القارئ قادرًا على متابعة مسار الاستدلال وتقييمه بموضوعية. بهذا الشكل لا يتحول النقد إلى خطاب اتهامي أو وصفي سطحي، بل إلى ممارسة علمية تمنح الخصم حقه في أن يُقرأ من خلال نصوصه قبل أن يُدان أو يُرفض.
كما أن الإحالة الواضحة إلى المصادر تحمي الباحث من الوقوع في فخ التوظيف الانتقائي، إذ تجبره على مواجهة النصوص في تعقيدها وتناقضاتها. وهذا بدوره يفتح المجال لتعدد القراءات ويمنع احتكار التفسير. بهذا المعنى يصبح النقد أقرب إلى حوار علمي قائم على عرض الأدلة ومناقشتها، لا مجرد إصدار أحكام نهائية مسبقة.
ثانيًا: الانفتاح على تعددية المنهج
البحث في ظواهر فكرية معقدة – مثل التيارات الدينية أو التراثية – لا يمكن أن يُختزل في منظور واحد. لذلك، فإن الجمع بين مناهج متعدّدة (التاريخية التي تفسّر السياقات، اللغوية التي تفكّك البنية الخطابية، السيميائية التي تدرس الرموز، والمقارنة التي تضع النصوص ضمن أفق أوسع) يمنح التحليل عمقًا واتساعًا. هذا التعدد لا يعني التشتت، بل التكامل الذي يسمح بتكوين صورة أشمل عن الظاهرة.
غير أن تعددية المناهج تقتضي أيضًا ضبطًا للموضوعية، أي أن يظل الحكم النقدي مرتبطًا بحدود الأدلة المتاحة. فإذا أظهر المنهج التاريخي جانبًا من التحالفات السياسية، فيجب أن يُترك المجال للمنهج اللغوي أو السيميائي ليكشف جوانب أخرى، دون أن تُختزل النتائج في تفسير واحد. بهذا التوازن، يتحقق الإنصاف المعرفي الذي يعترف بتعدد أبعاد الظاهرة بدلًا من اختزالها في بُعد واحد يخدم موقفًا محددًا.
ثالثًا: الانعطاف النقدي الذاتي
لا يمكن لأي باحث أن يتخلّص تمامًا من افتراضاته المسبقة، سواء كانت معرفية أو سياسية أو ثقافية. لذلك يصبح من الأهمية بمكان أن يُعرّف الباحث منذ البداية بمرجعياته وانحيازاته، حتى يتمكن القارئ من تقييم مدى تأثير هذه الخلفيات على النتائج المطروحة. الاعتراف بالذات هنا ليس ضعفًا، بل شرطًا من شروط المصداقية العلمية.
هذا الانعطاف النقدي الذاتي يُقلّل من مخاطر الإقصاء الخطابي، لأنه يُبرز أن الحكم الصادر ليس حقيقة مطلقة، بل قراءة مشروطة بزاوية نظر معينة. ومن ثمّ، يتحول النص البحثي من خطاب أحادي يفرض نفسه على المتلقي، إلى مساحة حوارية تُتيح للآخرين إعادة القراءة من مواقع مختلفة. بذلك يصبح النقد ممارسة معرفية منفتحة، لا مجرد أداة للهيمنة أو الإلغاء.
الخاتمة
يبقى الهدف الذي يطرحه محمود جابر، وهو رفع مستوى نقد التراث إلى درجة أعلى من الصرامة العلمية، مطلبًا مشروعًا وضروريًا. غير أنّ الوسائل الخطابية التي يعتمدها لتحقيق هذا الهدف قد تعكس تناقضًا مع جوهره؛ فبدل أن تؤسس لجدل مفتوح قائم على الشفافية والبرهنة، تتحول أحيانًا إلى أدوات إقصاء أو إلى أحكام تقريرية تضعف صدقية الموقف نفسه. فالمعضلة ليست في الدعوة إلى الانضباط العلمي، بل في تحويل الانضباط إلى معيار مُحتكر لا يخضع للنقاش.
إنّ النقد الفكري الرصين لا يبدأ بنزع الشرعية عن الآخر عبر توصيفه كـ«ادعاء»، بل بطرح أسئلة دقيقة على نصوصه ومقارباته. بذلك وحده يتحول النقاش من مواجهة خطابية إلى حوار معرفي يختبر الأدلة والمعايير بشكل متكافئ. أي محاولة لإغلاق هذا الأفق لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الانقسامات، في حين أن الحاجة الملحّة اليوم هي إلى فتح مسارات للتعددية المنهجية والاعتراف بأن النقد فعل حواري لا وصاية معرفية.