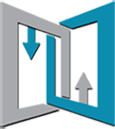اختطاف "الوسطية": قراءة في سيميائية التطرف وإعادة تدوير المصطلحات
الأحد 11/يناير/2026 - 02:56 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
تطل علينا افتتاحية صحيفة "النبأ" في عددها (529) الصادر مساء الخميس 8 يناير 2026، بشن غارة فكرية منظمة على أحد أقدس مفاهيم الإسلام المعاصر وأكثرها محورية: "الوسطية". ففي اللحظة التي يسعى فيها الوعي الإسلامي العام لاستعادة هذا المصطلح كجسر للتعايش والاستقرار، يحاول التنظيم عبر هذا النص تحويله إلى "خندق" للصدام المسلح وأداة لإقصاء المخالفين. إن هذا الخطاب يتجاوز كونه وعظاً دينياً تقليدياً، ليقف كوثيقة سياسية ونفسية شديدة الخطورة، تعكس محاولة التنظيم اليائسة لترميم شرعيته المتآكلة عبر "سرقة" المصطلحات الجاذبة وإعادة حشوها بمضامين قتالية.
سنتناول في هذا التحليل النقدي تفكيك خمسة محاور استراتيجية وردت في الافتتاحية؛ بدءاً من "الهندسة العكسية" التي قلبت موازين الوسطية من الاعتدال إلى الصدام، ومروراً بآلية "الاستقطاب بالمرجعيات" التي اختطفت هيبة الأئمة كدروع فكرية، وصولاً إلى "السيكولوجيا الدفاعية" التي تبني نخبويّة زائفة للمتطرف المنعزل. كما سنسلط الضوء على "الأبعاد الجيوسياسية" الكامنة خلف الهجوم على الدولة الوطنية، لننتهي برصد الآثار التدميرية لهذا الخطاب في تحفيز ظاهرة "التطرف المنفرد" أو ما يُعرف بالذئاب المنفردة.
قلب الموازين: هندسة "الوسطية الصدامية"
يمارس التنظيم في الافتتاحية ما يمكن تسميته بـ"الهندسة العكسية" للمفاهيم الشرعية؛ حيث يعمد إلى تفكيك الدلالة المستقرة للوسطية باعتبارها نقطة الاتزان بين طرفي الغلو والتقصير، ليعيد تركيبها كمرادف للتشدد المحض. في هذا السياق، تصبح "الوسطية" لديهم ليست بحثاً عن الاعتدال، بل هي الانحياز الكامل لجانب واحد وتسميته "وسطاً" بقرار أيديولوجي، مما يلغي طبيعة المصطلح القائمة على الموازنة، ويحوله إلى غطاء لغوي يمرر من خلاله أكثر الأفكار راديكالية تحت مسمى "العدل".
تظهر المفارقة المنطقية الصارخة في محاولة النص الربط بين "الوسطية" وبين مفاهيم مثل "الشدة والغلظة على الكافرين" و"مفارقة الرفيق وقلاه". هنا يحدث صدام بنيوي؛ فالوسطية تاريخياً وفطرياً تعبر عن "المركز" الذي يجذب الأطراف نحو التلاقي، بينما يضعها التنظيم في "الأطراف القصوى" للصراع. هذا التلاعب يجعل من "الوسط" مكاناً لا يسكنه إلا المقاتل الصدام، مما يعني إخراج الغالبية العظمى من الأمة الإسلامية من دائرة الوسطية وإلقاءهم في دوائر الانحراف، بمجرد ميلهم نحو السلم أو التعايش.
بدلاً من أن تكون الوسطية "مساحة مشتركة" تسمح بالاستيعاب والاحتواء وتأليف القلوب، يحولها النص إلى "أداة إقصاء" حادة. لقد جعل التنظيم من مفهوم الوسطية معياراً لفحص الولاء والبراء؛ فمن وافق رؤيتهم الصدامية فهو "الوسطي العدل"، ومن بحث عن نقاط التقاء مع العالم أو دعا إلى "واقعية وتوازن" فهو "مفرّط ومهين للدين". بهذه الطريقة، يتم عزل المصطلح عن وظيفته الاجتماعية والروحية، ليصبح سلاحاً يُشهر في وجه المخالفين لتصنيفهم كأهل "شهوات وشبهات".
يعتمد النص في هندسته لهذه "الوسطية المشوهة" على بتر النصوص التراثية عن سياقها المقاصدي. فعندما يستشهد بـ "العدل" عند ابن جرير أو ابن كثير، فإنه يختزل معنى العدل في "المفاصلة القتالية" فقط، متجاهلاً أن العدل في التفسير واللغة يشمل القسط، الرحمة، والمساواة. هذا الاستلاب يهدف إلى إيهام القارئ بأن "الوسطية القتالية" هي المفهوم الأصيل الذي ضاع وسط دعوات "الوسطية الحديثة"، وهو تزييف معرفي يخلط بين الأحكام الاستثنائية (في حالة الحرب) وبين الأصل العام للشريعة (الرحمة والعالمية).
إن الغرض النهائي من هذه الهندسة اللغوية هو حرمان "الاعتدال الحقيقي" من مشروعيته الدينية. فالتنظيم يدرك أن مصطلح "الوسطية" يحظى بقبول واسع وجاذبية فطرية لدى المسلمين، لذا هو لا يهاجم المصطلح بل "يحتله". من خلال جعل الوسطية مرادفاً لـ "القبض على الجمر" والشدة، يهدف التنظيم إلى جعل الشاب المتدين يشعر بالذنب إذا ما مال للسلم، ويقنعه بأن "الاعتدال" الذي تروج له المؤسسات الدينية الرسمية هو في الحقيقة "تبديل للدين"، وبذلك يغلق عليه كافة منافذ التفكير العقلاني خارج إطار المنظومة القتالية.
الاستقطاب بالمرجعيات: "الدروع البشرية الفكرية"
يعمد النص إلى ممارسة نوع من "السطو الفكري" على قامات علمية تحظى بإجماع شعبي وعقدي واسع، مثل الإمام الطبري وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية. الهدف من حشد هذه الأسماء ليس البحث العلمي المجرد، بل استخدام "هيبة" هؤلاء الأئمة كدروع بشرية فكرية تحمي أطروحات التنظيم من النقد. فبمجرد إقحام اسم ابن تيمية في سياق الحديث عن "الشدة" أو "الوسطية المحرفة"، يُخلق لدى القارئ البسيط انطباع زائف بأن ما يقوله التنظيم هو محض اتباع للسلف، مما يعطل ملكة النقد لديه ويجعل الاعتراض على التنظيم يبدو وكأنه اعتراض على أئمة الإسلام أنفسهم.
يمارس التنظيم "اجتزاءً متعسفاً" للنصوص التراثية، حيث يستل الجمل التي صيغت في سياقات حروب دفاعية أو جدالات عقدية محددة، ليجعل منها "قوانين كونية" عابرة للزمان والمكان. النص يصمت تماماً عن الظروف التاريخية التي كُتبت فيها تلك التفاسير، ويتجاهل أن هؤلاء الأئمة كانوا يكتبون لدولة قائمة ومجتمعات مستقرة، ولم يكونوا يؤسسون لعصابات عابرة للحدود. هذا البتر يحول التراث من "منهج حياة" متكامل إلى "قصاصات قتالية" تُستخدم لشرعنة واقع التنظيم الدموي.
تتجلى قمة التضليل في استحضار وجه واحد لشيخ الإسلام ابن تيمية وإخفاء وجوهه الأخرى؛ فابن تيمية الذي يستشهدون به في "الغلظة" هو نفسه صاحب التأصيلات العبقرية في "العذر بالجهل" و"درء الحدود بالشبهات" وفقه "الموازنة بين المصالح والمفاسد". هذه القواعد التأصيلية هي "الألغام الفكرية" التي لو فُعلت لهدمت فكر التنظيم من أساسه، لأنها تمنع التكفير العشوائي وتحرم الدخول في حروب عبثية تهلك الأنفس وتفسد المجتمعات. لكن التنظيم يبقي هذه الجوانب "مسكوتاً عنها" لضمان بقاء أتباعه في حالة من الجهل المركب بمرجعياتهم.
يتعامل التنظيم مع التراث الإسلامي بوصفه "مستودعاً للذخيرة" لا منارة للهداية البشرية. هو لا يقرأ لابن القيم أو البغوي ليفهم مقاصد الله في خلقه أو ليرتقي بسلوكه الروحي، بل يبحث في كتبهم عن "مسوغات ذبح" أو "مبررات تكفير". هذا التحول الوظيفي للتراث ينقل الكتب الصفراء من أرفف المكتبات العامة لخدمة البناء الروحي، إلى خنادق القتال لخدمة التدمير المادي، مما يمثل أكبر عملية تشويه لتاريخ الفكر الإسلامي التعددي.
بينما يدعي التنظيم التمسك بوسطية السلف، نجد أن ممارساته التي يبررها بهذه النصوص تصطدم مباشرة مع "الكليات الخمس" (حفظ النفس، الدين، العقل، النسل، والمال). إن استخدام نصوص "الوسطية والعدل" لتبرير هدم العمران وترويع الآمنين وقتل المسلم لأخيه هو قلب للمقصد الشرعي رأساً على عقب. فبينما جاءت الشريعة لحفظ هذه الضرورات، يستخدم التنظيم "هيبة المرجعيات" لانتهاكها، مما يجعل "الوسطية" التي يطرحها مجرد غطاء أيديولوجي لمشروع "عدمي" لا يقيم وزناً للدين ولا للإنسان.
السيكولوجيا الدفاعية: "صناعة نخبويّة الغرباء"
يعكس النص حالة ذهنية متقدمة من "سيكولوجيا القلعة المحاصرة"، حيث يشعر الأتباع بأن العالم أجمع قد تألب ضدهم. في ظل هذا الشعور بالاختناق والمطاردة، لا يقدم الخطاب حلولاً واقعية، بل يقدم "هوية دفاعية" صلبة. فبدلاً من مراجعة أسباب الرفض الشعبي الواسع لمشروعهم، يهرب التنظيم بالأتباع إلى الأمام، مصوراً هذا الرفض كدليل نبوة وعلامة على صحة الطريق، محولاً الحصار المادي إلى حصانة روحية زائفة تحمي الفرد من الاعتراف بالفشل.
إن استحضار مقولة ابن مسعود "الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك" في هذا السياق ليس دعوة للتحقق العلمي، بل هو "ترياق نفسي" صُمم بدقة لمواجهة العزلة القاتلة التي يعيشها الفرد المتطرف. هذه الجملة تعمل كمخدر موضعي يمنع "الانهيار المعنوي"؛ فهي توهم الفرد بأنه لا يحتاج إلى مجتمع أو حاضنة شعبية، بل إن "وحدته" هي قمة الصواب. هذا التحريف يحمي العضو من الشعور بالنبذ، ويجعل من انقطاع صلته بالواقع والناس فضيلة كبرى يثاب عليها.
يمارس التنظيم عملية "قلب للمكانة الاجتماعية"؛ فبدلاً من أن يرى العضو نفسه "منبوذاً" أو "خارجاً عن القانون"، يمنحه النص لقب "النخبة المختارة" أو "الغرباء" الذين يصلحون ما أفسد الناس. هذا الانتقال من "قاع المنظومة الاجتماعية" إلى "قمة الهرم الأخلاقي" يمنح الفرد شعوراً هائلاً بالقوة والتفوق. إنها عملية تعويض نفسية تملأ فراغ الفشل الشخصي أو الميداني بشعور زائف بالعظمة، مما يجعل الفرد متمسكاً بالتنظيم كونه المصدر الوحيد الذي يمنحه قيمة لمعناه الوجودي.
يستخدم النص "ملة إبراهيم" و"العداء مع الكافرين" كأدوات لخلق حالة من "الاستعلاء الإيماني". هذا الاستعلاء يعمل كآلية دفاعية لإنكار الواقع الميداني المرير؛ فمهما كانت الهزائم العسكرية قاسية، يظل العضو مقتنعاً بأنه "الأعلى" بفضل عقيدته. هذا التصور يمنع العقل من تحليل المعطيات الواقعية، حيث يتم تفسير كل فشل مادي على أنه "ابتلاء" يرفع الدرجات، وكل نجاح للخصوم على أنه "استدراج" من الله لهم، وبذلك تنغلق الدائرة النفسية تماماً أمام أي محاولة للمراجعة أو الندم.
لكي تكتمل صورة "النخبة"، لا بد من خلق صورة "عدو محتقر". يعمد النص إلى وصف المخالفين بـ"المنافقين" و"أدعياء الضلال"، مما يسهل على الأتباع قطع الروابط العاطفية مع مجتمعاتهم وأسرهم. عندما توصف مشاعر الشفقة أو الرغبة في التعايش بأنها "وحي شياطين"، يصبح التشدد والغلظة هما البرهان الوحيد على الإيمان. هذا الضغط النفسي يضمن ولاءً مطلقاً ويمنع "السيولة" في المواقف، محولاً الأتباع إلى كتل صماء لا تستجيب إلا لصوت القائد أو النص الذي يكرس تفوقها الموهوم.
السياق الجيوسياسي: الهجوم على "الدولة الوطنية"
خلف الستار العقدي الكثيف، يشن المقال هجوماً سياسياً شرساً يستهدف نماذج الاستقرار الناشئة في المنطقة. العدو الحقيقي في هذا النص ليس "العدو البعيد" المتمثل في الغرب، بل هو "العدو القريب" المتمثل في المؤسسات الدينية الرسمية التي تتبنى "الوسطية" كمنهاج للدولة الوطنية. يستشعر التنظيم أن نجاح الحكومات في تقديم نموذج إسلامي يجمع بين الحفاظ على الهوية وبين المدنية والتعايش يمثل "تهديداً وجودياً" له، لأنه يسحب البساط من تحت خطاب المظلومية والصدام الذي يقتات عليه.
يستخدم النص مصطلحات مثل "أرباب الدساتير" و"المناهج الأرضية" ليؤصل لرفض فكرة الدولة الوطنية من جذورها. هو يحاول إقناع القارئ بأن أي تنظيم سياسي لا يقوم على رؤيته المتطرفة هو "شرك وتنديد"، مصوراً القوانين المدنية التي تنظم حياة الناس على أنها منافس لشرع الله. هذا الهجوم يهدف إلى خلق فجوة شعورية بين المواطن ودولته، بحيث يرى في الاستقرار القانوني والدستوري "انحرافاً" وفي الفوضى "تمسكاً بالوحي"، مما يخدم استراتيجية التنظيم في إدامة مناطق "الفراغ الأمني".
يسعى المقال لتسفيه مفاهيم مثل "الواقعية" و"التوازن" و"التعايش"، واصفاً إياها بأنها "التقاء مع الباطل في وسط الطريق". هذا الخطاب هو رد فعل مباشر على النجاحات الدبلوماسية والقوى الناعمة للدول الإسلامية التي استطاعت بناء جسور مع العالم. من خلال تصوير الدبلوماسية كنوع من "التفريط في الولاء والبراء"، يحاول التنظيم محاصرة العقل المسلم داخل دوامة من العداء المستمر مع الجميع، مانعاً أي إمكانية للاستقرار الإقليمي الذي يعتمد على المصالح المتبادلة والاحترام الدولي.
يدرك التنظيم أن بقاءه مرهون بوجود حالة من "الاستلاب" لدى الشعوب تجاه حكوماتها، ولذلك يهاجم بشدة مفهوم "السواد الأعظم". عبر تقزيم قيمة الأكثرية ووصفها بأنها "مذمومة في القرآن"، هو يحاول نزع الشرعية الشعبية عن أي نظام سياسي مستقر. هذا الطرح يهدف إلى تحويل "الأغلبية الصامتة" التي تبحث عن الأمان والتنمية إلى هدف للتحقير، مقابل تمجيد "الأقلية المقاتلة"، مما يكرس حالة من الانقسام المجتمعي الذي يسهل من خلاله اختراق المجتمعات وتجنيد المحبطين فيها.
يربط النص بين الاستقرار المادي (الأمن، الاقتصاد، التعايش) وبين "إعطاء الدنيّة في الدين". إنها محاولة لإقناع الشباب بأن ثمن السلام الاجتماعي هو خسارة الآخرة، وأن "الوسطية" المقبولة عند الله هي التي تستجلب سخط العالم وتؤدي للحروب. هذا الربط الخطير يهدف إلى إفشال مشاريع التنمية والازدهار في المنطقة العربية والإسلامية، وتصوير الفقر والدمار الناتج عن الصدام على أنه "ابتلاء المتمسكين بدينهم القابضين على الجمر"، وبذلك يتم تبرير الفشل التنموي للتنظيم وتحويله إلى انتصار عقدي موهوم.
الآثار والتداعيات: صناعة "التطرف المنفرد"
يمثل هذا الخطاب الوقود المثالي لظاهرة "الذئاب المنفردة" عبر تفكيك المفهوم التقليدي للجماعة وربطه بالفردانية المطلقة. حين ينزع النص صفة "الوسطية" عن المجموع العام للأمة ويحصرها في "صاحب الحق وإن كان وحده"، فإنه يمنح الفرد المنعزل تفويضاً شرعياً كاملاً للعمل بمعزل عن أي هيكل تنظيمي أو مرجعية مجتمعية. هذا التأصيل يلغي الحاجة لـ "بيعة" معلنة أو ارتباط مكاني، مما يجعل كل قارئ لهذا النص مشروعاً لمنظمة إرهابية تمشي على قدمين، قوامها فرد واحد يرى نفسه الأمة بأكملها.
يخلق النص حالة من "اليقين العدمي" لدى المستهدف؛ حيث يتم إقناعه بأن انحراف العالم أجمع هو برهان على صحة منهجه المنفرد. هذا النوع من الخطاب يلغي حواجز التردد الأخلاقي؛ فالفرد الذي يرى نفسه "الوسطي الوحيد" وسط ركام من "المفرطين" و"المنافقين"، يكتسب حصانة ضد الشعور بالذنب تجاه مجتمعه. هذا الانفصال الوجداني هو المحرك الأساسي للعمليات المنفردة، حيث يتحول الجار أو القريب أو ابن الوطن في نظر هذا الفرد إلى "هدف شرعي" يقتضي الإجهاز عليه حمايةً لـ "بيضة الدين" الموهومة.
من أخطر تداعيات هذا النص هو تحريض الأفراد على تجاوز المؤسسات الدينية والعلماء المعتبرين. من خلال وصف هؤلاء العلماء بـ"أدعياء الضلال" و"المحرفين"، يغلق التنظيم منافذ النصيحة والإرشاد، ويجعل من "فهم الفرد" للوحي هو المرجعية الوحيدة والنهائية. هذا التمرد المعرفي يدفع الشاب المتطرف إلى استقاء أحكامه من افتتاحية صحيفة أو مقطع فيديو، متوائماً مع قناعاته الشخصية الممزوجة بالرغبة في الانتقام، مما ينتج أفعالاً عنيفة غير متوقعة ولا تخضع لمنطق سياسي أو عسكري واضح.
يحول الخطاب العنف من وسيلة إلى "غاية" تثبت تميز الفرد ووسطيته الحقة. فعندما يقرن النص الوسطية بـ"الشدة والغلظة"، فإنه يغري الفرد بأن ممارسة العنف هي "بوابة العبور" لنادي النخبة المختارة. بالنسبة لشاب يعاني من التهميش أو أزمة هوية، يصبح القيام بفعل عنيف منفرد هو الطريقة الوحيدة "للإعلان عن الذات" وإثبات أنه ليس مجرد رقم في السواد الأعظم المذموم، بل هو "الغريب" الذي صدع بالحق وسط الركام.
تكمن الخطورة الاستراتيجية لهذا الخطاب في كونه يتجاوز الحدود الجغرافية والقدرات العسكرية للتنظيم على الأرض. فبينما يمكن سحق التنظيم ككيان عسكري، فإن هذا "الفيروس الفكري" الذي يقدس الانفراد ويشرعن الانعزال يبقى نشطاً في الفضاء الرقمي. إن التأثير البعيد المدى هو خلق حالة من الاستنزاف الأمني العالمي، حيث تصبح مواجهة الإرهاب مواجهة مع "أفكار" تسكن رؤوساً منعزلة، وليست مواجهة مع جيوش نظامية، مما يتطلب استراتيجيات أمنية وفكرية أكثر تعقيداً تعتمد على تفكيك هذه السرديات النفسية قبل أن تتحول إلى رصاصات ومتفجرات.
الخاتمة
بناءً على ما تقدم، نخلص إلى أن افتتاحية "النبأ" (529) تمثل حالة من "الانتحار الفكري" للتنظيم؛ حيث لم يعد يمتلك القدرة على الإقناع الفطري، مما اضطره للاقتيات على "تزييف المصطلحات" ومحاولة تدمير معانيها السامية. إن هذا النص يؤكد أن المعركة القادمة مع التطرف هي معركة "سيميائية ولغوية" بامتياز، تهدف إلى استلاب العقل المسلم عبر إيهامه بأن التشدد هو "الوسطية" وأن الانعزال هو "الحق"، وهي مغالطة كبرى تقلب جوهر الرسالة المحمدية التي جاءت "رحمة للعالمين" لتحولها إلى "نقمة" تستهدف الهدم لا البناء.
إن مواجهة هذا المد الفكري لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية أو العسكرية، بل تتطلب استراتيجية شاملة تقوم على كشف هذا "التدليس اللغوي" وتفكيك بنية الخطاب المتطرف أمام الأجيال الشابة. إن الضرورة تقتضي إعادة ربط هذه الأجيال بمرجعياتها الأصيلة والمقاصدية التي ترى في الحياة عمارة، وفي الدين يسراً، وفي الوسطية جسراً متيناً للتواصل الإنساني لا جداراً أصم للاعتزال والقتل؛ فالوسطية الحقة هي التي تصون "الكليات الخمس" وتحفظ كرامة الإنسان، وليست تلك التي تتخذ من دماء المسلمين وتماسك أوطانهم قرباناً لأوهام "النخبوية المنفردة".