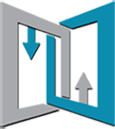دراسة: كاهن كاثوليكي يقيم إصلاح مارتن لوثر بعد 500 عام
الأربعاء 18/أكتوبر/2017 - 02:57 م
طباعة

يوم 31 أكتوبر 2017 تتذكر الكنيسة البروتستانتية، كما والعالم، مرور 500 سنة على حركة الإصلاح التي بدأها مارتن لوثر على أعمال الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت، وبهذه المناسبة كتب الاب ايمانويل بدر الكاهن الكاثوليكي المقيم بالمانيا دراسة مطولة واضح من بداية سطورها الموقف الموقف المنحاز ضد البروتستانت وقد نشر موقع ابونا الكاثوليكي هذه الدراسة المهمة والمواكبة لحدث الاصلاح هذا الحدث، الذي تغرق الكنيسة البروتستانتية بتحضير الإحتفالات به منذ 2008 أي عشر سنوات قبل حلوله. عما ستطلع به هذه الإحتفالات من نتائج وتوقعات بالنسبة للوحدة المنشودة، هذا ما سيطلعنا به الأب بدر عن أرضية بداية الإصلاح، التي سهّلت الطريق للإنقسام بمساعدة الإقطاعيين الذين وجدوا المناسبة للثورة على سلطة الكنيسة بدعم لوثر لهم، والذي كانت أزعجته مشكلة ما يسمّى بصكوك الغفران وعدم فهمه لها، وكيف تمت وإلى أين وصلت، وبالتالي سيحدثنا كذلك عن إمكانية توقعات الرجوع إلى الوحدة وما هي متطلباتها إذا كتب لها النصيب أن تتم.
حركة الإصلاح ولوثر قبل 500 عامًا (1517– 2017)
قبل 500 سنة دخلت الكنيسة حقبة تاريخية جديدة. فهي ولو كانت مؤسسة إلهية أي "أبواب الجحيم لن تقوى عليها"، تحتاج ككل مؤسسة يديرها بشر من وقت إلى آخر لهواء جديد، بحاجة من وقت إلى آخر إلى تجديد لغتها ومحتوى تعليمها لتتماشى مع العصر.
من لا يذكر فكرة البابا القديس يوحنا الثالث والعشرين عام 1958 حينما أعلن رغبته في عقد مجمع مسكوني جديد؟ فلكي يُشوّق الناس إلى هذه الفكرة، وقف أمام شباك مكتبه والجماهير متجمّعة أمامه في ساحة القديس بطرس، ثم فتح دفّتي شباك مكتبه معلنًا: البيت يحتاج من وقت لآخر لهواء جديد، وهذا يعني تهوية جديدة. كذلك الكنيسة فهي بحاجة لهواء الروح القدس لتجديدها، لذا عزمتُ أن أدعو كرادلة وأساقفة الكنيسة لعقد مجمع مسكوني لتجديد الهواء فيها.... لو حدثت هذه الأطروفة في القرن السادس عشر لما حدث هذا الانشقاق الذي تتألم منه الكنيسة منذ 500 سنة.
المشابهات تخدع أحيانًا، لكن لا بد من ذكرها. فهل هذا ما عناه لوثر قبل 500 سنة حينما علّق على باب الكنيسة التي اعتمد فيها منشوره المؤلف من 95 بندًا فنّد فيها الأغلاط في الكنيسة والتي تحتاج للإصلاح لتبقى هي الكنيسة التي أسّسها المسيح وأوكلها لخليفته بطرس؟ هل كان محتوى بنوده هذه رمزًا للهواء الجديد الذي عناه يوحنا الثالث والعشرون؟ لا نريد أن نتسرّع ونعطي جوابًا مستعجلا بل نكتفي بالقول: يوحنا الثالث والعشرون عنى تجديد، أما لوثر فعنى الإصلاح، وشتّان ما بين الإثنين. فالتجديد والإصلاح مصطلحان يختلفان اختلاف الضوء عن الظلام أو الحق عن الباطل. التجديد هو غير الإصلاح، والإصلاح هو غير التجديد، كما سنرى لاحقًا. التجديد ضرورة لكن الواسطة والأسلوب بل والطريقة تختلف كلّيًا عن واسطة وأسلوب وطريقة الإصلاح.
جاءت مبادرة حركة الإصلاح، التي نريد أن نتكلم عنها في هذا المقال، من راهب ألماني اسمه على كل لسان، يدعى مارتين لوثر. كان راهبًا من رهبنة الأغسطينيين. كان متعلمًا وفي بداية حياته الرهبانية راهبًا ورعًا تقيّا إلى أن وقع في أزمة روحيّة، يمر فيها كل متعبّد تقي، يشعر بضعفه أمام الهدف الراقي الذي يضعه الكتاب المقدس أمامنا وعدم إمكانية تحقيقه بالطبيعة البشرية، المجبولة بالخطيئة التي نلد فيها.
هذا الضعف وعدم إمكانية تطبيقه العملي في حياته، والذي شعر به أثناء تأمله بالكتاب المقدس ومقارنته بتعليم الكنيسة العقائدي القاسي، أشغل لوثر وأقلق مضجعه وراحته، أوّلا سرّا ثم أصبح الأساس في برنامج الإصلاح الذي قاده فيما بعد بلا هوادة ولا تردد. إن سرّ وحلّ مشكلة الخلاص كان عقدة لم يستطع لوثر لا حلّها ولا فهمها بسب صرامة تعليم الكنيسة بهذا الخصوص، إذ هي كانت تعلن وتعلّم أنها وحدها المسؤولة عن الخلاص حتى بالتهديد والتخويف. لذا كان شغلها الشاغل مسألة الحل من الخطايا والإعفاء من عقوباتها وربطها بصكوك غفران (نشبّهها بدفع الفائدة على دين أخذناه) راحت تبيعها للخطأة، الذين كانوا يشترونها بكثرة، لراحة نفوسهم وضميرهم. من هنا كان احتجاج لوثر على هذه الصكوك إذ قد فهم منها أن الخلاص يباع ويشترى، وأنها تذكرة عبور مباشر إلى السّماء. وهذا ما أحدث بلبلة في احتجاجه وتمرّده على هذه الصكوك وهاجمها بشكل خاص في بنوده الـ32، 36، و52.
لقد شعر لوثر، كإنسان بضعفه أمام التجارب وعدم مقدرة الطبيعة البشريّة في مقاومة الشهوات، التي ترافق كلّ إنسان، فالإنسان ليس ملاكًا على الأرض، فكان لا ينام الليل خوفًا من العقاب الإلهي لسقوطه في الخطيئة، كأنّ الله شرطي لا أب رحيم. وفي خضم هذه المخاوف والأحزان التي كانت تشغل وقته وتفكيره، راح يفتّش، كمدرّس للكتاب المقدس في جامعة مسقط رأسه Wittemberg عن حلّ فيها، حتّى وقع على الآيات الفاصلة في رسالة بولس إلى أهل روما: التي وجد فيها كل الحلول -على طريقته طبعًا- التي كانت أقلقت مضجعه وضميره ولاحقته بمخاوف دائمة وذلك في آيات الفصول 1، 3، 4، 5، خاصة هذه الآيات:
- إني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوّة الله للخلاص (روم 1: 17).
- إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبرّرين مجّانًا بنعمة الفداء بيسوع المسيح (روم. 3 :24)
- الإيمان بالله يُحسب لنا بِرّاً... أمّا الّذي يعمل فلا تُحسب له الأجرة على سبيل نعمة (روم. 4: 3-4)... على سبيل النّعمة لا على سبيل الناموس يكون الوعد وطيدا (4: 16)
- فإذ قد تبرّرنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الّذي به أيضا قد صار لنا الدّخول بالإيمان، إلى هذه النّعمة الّتي نحن فيها مقيمون (روم 5: 1-2).
من الثابت أن لوثر كان راهبًا تقيًا وصادقًا مع نفسه مما جعله يصبح أيضًا باحثًا جادًّا، يفتّش في نفسه أو في ما تعلّم عن حلٍّ لقضيّة التبرير وإراحة الضمير. وكمؤمن، راح يفتش عن حلول في الكتاب المقدّس إلى أن عثر على تلميحات لها في الرسالة المذكورة. همه الوحيد كان: كيف نلاقي أبًا رحيمًا، لا خوف منه، رغم ما نقترف أمامه من سيئات، بسبب ضعفنا البشري والطبيعي أمام إغراءات المجرّب. معلنًا أنّ الخلاص هو هدية محضة من الله لا استحقاق لنا فيه.
إن معرفته للكتاب المقدس لم تكن بمستوى اليوم، إذ الكتاب المقدس ما كان قد خضع بعد، للدراسات والانتقادات والبحوثات العلمية التي نعرفها اليوم، ولم يكن بين يديه أي شروحات أو تفسيرات ترفض أو تقبل رأيه الذي انفرد به في ذلك الوقت. فكان الكتاب المقدس بالنسبة للوثر المرجع الأول والأهم لعلمه اللاهوتي والأخلاقي. ولمحبته للكتاب المقدس فقد جعله المرجع الأول والأخير لِما راوده من خوف أمام الله على خطاياه. لقد أعطى كل القوة لكلمة الله وأبطل بذلك مفعول تعليم الكنيسة وشروحات اللاهوتيين قبله. وهو الذي أوجد مرجعيات الخلاص الأربعة المطلقة: فقط الله Solus Deus، فقط الكتاب sola Scripta، فقط الإيمان sola fide، وفقط النعمة sola Gratia. فالتبرير له إذن هو للفكر أكثر منه للعمل. إذ الله لا ينظر إلى ما نعمل. فأعمالنا باطلة لا قيمة لها أمام نعمته المجانية التي منها يأتي خلاصنا.
من خلال قراءته لرسائل بولس بتمعّن، وعثوره على هذه المرجعيات، اقتنع أنه وجد حلّا لقضية التبرير وبالتالي لراحة الضمير، التي كان يفتش عنها، بالاقتناع التام أن الخلاص هو من الله دون أي شرط أو قيد علينا (الإيمان وحده هو سبب خلاصنا). لكن يبدو أنه لم يقرأ ما كتب يعقوب الرسول (2: 14): الإيمان بدون الأعمال ميت أي ليس من خلاص بدون الجهد الفردي.
هنا لا بد من الرجوع بالفكر إلى القرون الوسطى والسؤال، ما كانت أهمية التوبة وسر الاعتراف اللذين كانا من أوّل مقوِّمات الحياة الدينية والشغل الشاغل للأتقياء والمتدينين في ذلك الزمان. من هذا نكتشف أنه كان لمعنى الخلاص والحياة الأبدية مكان في القلوب والكل كان يسعى للوصول إلى أعلى درجة من القداسة طيلة أيام حياته، حتى يظهر نقيا أمام الوجه الإلهي بعد الموت. هذا وللوصول إلى القداسة كان سر الاعتراف يتصدى صدارة الممارسات التي توصل إليها. لقد مرّت قرون طويلة حتى تخلّص الناس من كابوس الذهاب الإجباري إلى كرسي الاعتراف، مثلا قبل تناول القربان المقدس أو الاعتراف الأسبوعي الإلزامي في المدارس الداخلية أو الإكليريكيات والرهبانيات.
فقبل أن نلاحق الجدال بين لوثر والكنيسة الكاثوليكية في هذه النقطة، ليسمح لي القارئ بإعطاء رأيي الشخصي عنها. الاعتراف طبعًا ضروري، لكن لا يجب فرض ممارسته خاصة الأسبوعية الإجبارية بالرعب والتخويف، كما عرفناه في صبانا حتى ثورة الشبيبة على القوانين الضيقة والمحافِظّة في أواخر الستينات من القرن العشري المنصرم. تقول الدراسات إن ما من قرن مثل القرن العشرين الماضي عرف أعلى ممارسة لسر الاعتراف. ومن جرّاء ذلك دخل هذا السر اليوم في أكبر أزمة عرفها التاريخ أيضًا حيث عاد كأنه مُلغى، حتى إن كثيرين يقولون إن كراسي الاعتراف في الكنائس قد أصبحت من أحلى المساكن والملاجئ للعنكبوتات. إنني أشبه ضرورة ممارسة الاعتراف بضرورة الذهاب إلى الطبيب وحاجتي له. فأنا عارف أنني إذا ما أصابني مرض ثقيل، فمن المفضّل والمستحسن الذهاب لعيادة الطبيب. أما إذا ما زلت أتمتع بصحة جيدة فأنا لست بحاجة للذهاب إلى الطبيب.
والسؤال الواقعي طبعًا هو: لماذا أذهب؟ لكن هناك أيضا احتياطات صحيّة لا بد من الانتباه لها، مثلا اليوم مع تقدّم الطب والتنبؤات بتحاشي الأمراض الطبيعية، قبل حلولها ينُصح بزيارة وقائية سنوية محبذة للفحص ضد السرطان أو الإصابة بالبروستاتا أو غيرها من الأمراض المنتشرة، فهذه ممارسة طوعية أيضا وغير إلزامية. لكن أن أذهب أسبوعيًا لزيارة الطبيب فهذه أعتبرها مهزلة لي وللطبيب بالذات. مثل آخر واقعي: هل عليّ أن أرمي كل ما عندي من أثاث نظيف في الغسالة وأغسله كل أسبوع؟ بالطبع لا، لكن من المحبّذ نشر الأثاث بين الحين والآخر تحت حر الشمس لتخليصه من الرطوبة.
هذه كانت قوانين الكنيسة في القرون الوسطى. فلكي يؤمّن الإنسان الخلاص في الآخرة كان أمامه ثلاث طرق شائعة: أوّلها الاعتراف المتكرّر عن كلِّ سيئة أو توبيخ ضمير، يليها إعطاء الحسنات، وثالثها هو كسب الغفرانات حتى عن الجرائم الكبيرة. وهنا يحق لنا القول إنَّ الكنيسة من جهة أفرطت مع الوقت في منحها، ومن جهة ثانية أفرط الناس في استعمال الوسائل هذه لكسب الغفرانات.
حركة الإصلاح ولوثر، بعد 500 عام: مسألة الغفرانات
مما لا شك فيه أنَّه كان لهذه الطرق الثلاثة تلميحات في الكتاب المقدس، منها نص يعقوب الرسول: "الإيمان بدون الأعمال لا ينفع" (يعقوب 1: 21). ويكمل يعقوب الحديث عن إيمان إبراهيم الذي قدّم ابنه اسحق ويقول: "إبراهيم لم يتبرر بالإيمان وحده بل وبالعمل" (يعقوب 1: 22). أو وضع الأيدي على المريض والصلاة من أجله، فتغفر له ذنوبه. أما لوثر فما كان مقتنعًا من تلك النصوص، إذ مهما عمل من الصالحات، ما كان يجد راحة الضمير بل يخطئ مرارًا وتكرارًا، كما ألمح بولس عن نفسه "لست أعمل ما أريد... لست أفعل الصالح الذي أريد بل الخطيئة الساكنة فيّ" (روما 7: 15 و19)... "الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون" (غلاطية 5: 17). وبما أنه من جرّاء ذلك كان عائشًا برفقة وخز الضمير الدائم، فقد شعر لوثر، كراهب ومتعلم أنّ عليه وجود حلٍّ ملائم.
الكنيسة كانت تقول الاعتراف هو حجر الزاوية للتوبة والسير على طريق الخلاص، وأما لوثر فقد قال التوبة (أي الندامة بدون اعتراف) هي طريق الخلاص. مظهرًا اشمئزازًا كبير أمام استعمال صكوك الغفران، إذ هو فهمها كمسألة مساومة مع الله، السماء تباع وتشترى. وطبعا ما كان هذا واردًا لا من الكنيسة ولا من الذين أدمنوا على بيعها. بل هو لوثر، الذي –ليسمح لنا القارئ والسامع أن نقول، كما وصفه الكثيرون من مؤرخي وباحثي حياته- كان يتألم من أزمة نفسية بسبب عدم مقدرته عن ارتكاب الخطيئة، التي ككل واحد منا، يقع فيها. هو اهتم كثيرًا بوجود طريقة للتبرير منها والكنيسة كانت عندها طريقتها. هو قال الإيمان والتوبة المعطيان لنا من الله يكفيان للخلاص. أما الكنيسة، معتمدة على ما جاء في الكتاب، فقالت الإيمان وحده بدون أعمال لا يكفي بل يجب الإيمان والإعتراف والتعويض. لوثر فهم ذلك خطأ، كما سنرى عندما يأتي الحديث عن تفسيرها ومعناها، الذي عنته الكنيسة منذ البداية.
مما يجب ذكره، وكثيرون لا يعرفونه في حقبة القرن والنصف قبل لوثر ومعه، أن الأديرة، سواء للنساء أو الرجال، كانت بسب المجاعات المتفشية في ذلك الزمان، ملجأ لما هب ودب من طبقات الشعب، فأصبحت حياة الكثيرين من رهبان وراهبات (الّذين لجأوا إلى الأديرة بدوافع دنيوية أكثر ممّا هي دينية روحية) علمانية بحت لا تتفق والتعليمات الروحية والتَّقّوِيَّة المطلوبة من المكرسين وقوانين الأديرة، فصارت كل قوانين الحياة الرهبانية مهددة بالزوال. من هنا جاء مجمع بازل Basel في النمسا عام 1430 الذي أمر بالرجوع إلى القوانين التاريخية التي بنيت عليها الحياة الرهبانية والحفاظ عليها حتى بالضغط والقوة. لكن وبالرغم من ذلك لم تنجح الكنيسة بإرجاع الحياة الرهبانية إلى نصابها. من هنا الانتقادات الكبيرة ضد الكنيسة بسبب انفلات وانحلال الأخلاق في الأديرة، كما لو كانت الكنيسة مسببتها بمعنى أنها هي التي تسمح بها رسميًا. من هنا إصرار الكنيسة على العائشين في الأديرة ممارسة الإعتراف بلا هوادة.
أضف إلى ذلك فقد انتشرت المدن الكبرى في أوساط أوروبا، لكنها بقيت كلها تحت حكم الأمراء والإقطاعيين المستغلين لثروات البلاد وحدهم، معتبرين الجميع كعمال لهم. فكانت أول حركة صدام بين الإقطاعيين والكنيسة، إذ راحت سلطتها تتقلّص في المجتمع المدني والسياسي. أضف إلى ذلك أن العديد من الأديرة وبيوت الرهبانات قد أصبحت مستقلة، لها أملاكها الإقطاعية أيضًا، تتنعم بامتيازات، فلا فرائض مادية عليها ولا ضرائب، بل أحيانًا كان على الفلاحين منح الأديرة قسمًا من منتوجاتهم كتقادم العُشُر المذكورة في التوراة. ثم جاء بيع الغفرانات المستقل، الذي راح يدر عليهم بالمدخول الزائد. هذا ولا ننسى أن محاكم التفتيش، والتي راح ضحيتها الأعداد الكبيرة غدرًا وبلا رحمة أو هوادة، كانت بأيدي الإكليروس، علمًا بأن العيشة في الأديرة ما كانت خفية على هؤلاء الضحايا ولا هي مثالية. لكن قل لي من كان يقدر أو يتجاسر على انتقادها؟ نعم كل هذه التيارات تلاحقت وتناحرت وتنافست في نفس الوقت والكنيسة لم تستطع أن تسيطر عليها بالسرعة التي بها انتشرت. لنقل كانت فترة فساد في الأوساط الكنسية لا بد من محاربتها وإرجاع الحياة الرهبانية إلى أساسها.
نعم كادت الأمور، إن لم تكن قد أفلتت تمامًا من يد الكنيسة، بحاجة إلى خطوة جريئة ووضع حدّ لهذه التعديات المفرطة. هذا وقد أتت خطوات بهذا الصدد ومن جهات مختلفة. فبينما كان الانحلال يتغلغل علنًا في قلب الكنيسة، تواجدت جماعات كثيرة تعيش وتدافع عن حياة التقوى، التي ضاع احترامها وتقديرها في الكنيسة. كما وأصدرت تلك الجماعات كتب تقوية كثيرة راح الكثيرون يقرؤونها ويمارسون إرشاداتها ومحتواها. بل قامت أيضًا حركات دينية غيورة خارج الأديرة منافسة ترأسها شخصيات علمانية لم تكن حاصلة على موافقة الكنيسة أو أساقفتها، الذين كانت السيادة الدينية والمدنية أيضًا بيدهم. لكن بتلك الطريقة الغير واقعة تحت سلطتهم كانت كميات كبيرة من حسنات الغفارين لا تقع في أيدي المسؤولين في الكنيسة والرهبانات ممّا أغاضها على هذه الحركات العلمانية في داخلها. فكان الخلاف إذن واقع لا محالة، عاجلا أم آجلا.
ماذا يكمن وراء سر الغفرانات وكيف نفهمها؟
مما لا شك فيه أننا اليوم نعلم أنه كان وراء هذا التعليم دعائيون متخصصون، عرفوا كيف ينشرون ويقنعون الناس البسطاء بأن صك الحسنة أو صك الغفران هو كرت الدخول إلى الجنة بلا معيق. برأيي لا يجوز رمي اللوم على الإنسان البسيط الذي ما كان لا لاهوتيًا ولا دينيًا متنوّرًا مثل اليوم، لكنه كان يقبل ويُمارس على بساطته ما تقدم له الكنيسة أو العاملين فيها من أوامر وتعليمات، إذ الدخول إلى السماء لا يباع ولا يُشترى بل هو مكافأة على توبة فعالة واستحقاقات شخصية أمام الرحمة الإلهية. أمّا السؤال المحيّر فهو: ما هي مسألة الغفرانات، التي سبّبت النزاع الكبير بين لوثر والكنيسة إلى حدّ الثورة عليها والانشقاق عنها؟ كيف تفسّر الكنيسة الكاثوليكية مفهومها لهذا الخلاف الذي هي سبّبته؟ وهل للغفرانات ذكر في الكتاب المقدّس؟
الكنيسة تُعلّم أنّ الخطيئة ليست فقط إهانة للذات أو لشخص آخر، وإنما هي أيضًا إهانة للقانون العام الذي يجب التعويض عنه بقصاص معيّن. السؤال هو: أين وكيف يتم التعويض عنه؟ لقد فتّشت الكنيسة عن مرادفات في الكتاب المقدس تعني التنقية اللاحقة لذنب ما، وأعطتها كلمة المطهر، وباللاتيني Purgatorium، ومعناها مكان التطهير أو التنظيف المؤقّت، كالإقامة المؤقتة في سجن. وهي ليست درجة قبل الدّخول إلى جهنّم النّار، كما افتكره الوثر أوّلاً، تُمكِّن الكنيسة من دفع جزية عنهم لئلا يدخلوا جهنم، وإنّما هي درجة قبل الدّخول إلى السّماء. جهنّم هي مكان إقامة مؤبّدة لمن ارتكب الجرائم الكبيرة ومات في خطيئته بدون إظهار أي ندم أو توبة، فلا يوجد قدامها إذن غرفة استقبال أو انتظار أو تطهير وتنظيف من الخطيئة وإنقاذه من العبور إليها، وإنما العبور رأسًا إلى العذاب الأبدي "في النار التي لا تنطفئ" كما قال المسيح. بينما المطهر فهو مكان منفى مؤقّت، يقيم فيه مَن مات تائبًا لكنّه لم يصل إلى درجة القداسة التي تمكّنه من الدخول إلى السماء ومشاهدة الله حالاً، إذ لا يزال قانون الجناية العام لم يأخذ بعد حقه ممن أخطأ وتعدى على هذا القانون. فأثناء الحرمان من مشاهدة الله المؤقت هذا، يمكن للكنيسة التي أعطاها المسيح سلطة الحل والربط: "من غفرتم خطاياهم تُغفر لهم، ومن أمسكتم خطاياهم تُمسك لهم" (يو 20: 23)، أن تستعمل هذه السلطة وتجد طرقًا لا طريقًا واحدًا تساعد فيها النفوس المتوفية المتبقية عليها بعض عواقب الخطيئة لتُعَجِّل من دخولها إلى الحضن الإلهي. من ضمن تلك الطرق، إلى جانب الصلاة من أجل الأموات "لأن الصلاة تمحو الخطايا وتطهر الذنوب" كما ورد في يعقوب الرسول (5: 15)، جاءت مسألة الغفرانات والصكوك التي لم يفهمها الكثيرون فحدثت عليها البلبلة المعروفة. وبالتأكيد نقول، لو فهم أصحاب القرار والنزاع وقتها فكرة الكنيسة، لما وصلت الحالة إلى ذاك الموقف المتعنّد ولا حصل هذا الانفصال المرير.
بهذا علّمت الكنيسة أن هناك بين جهنم والسماء مكان ثالث يدعى المطهر (أي مكان التنظيف والتطهير) لم تعترف به الكنيسة البروتستانتية حيث تعتقد أنه بعد الموت هناك فقط إمكانيات لا ثالث لهما: إما الهلاك في جهنم وإما الخلاص في السماء. ومنذ ذلك الوقت، برفضها للإعتراف بهذا المكان الثالث، فقد أصبح هذا الموضوع موضوع انتقاد وتهجّم محبّذ منها ضد تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة، وذلك للسبب البسيط أنها أساءت فهمه ومحتواه.
من هنا، بما أن للكنيسة البروتستانتية لا تقبل بوجود المطهر فهي تعتقد أيضًا أنه لا أنه عمل تكفيري، مهما كان رفيعًا، بوسعه وحده تطهير ما يحدث من شر أمام الله ويُمكِّن من مشاهدته. وأما الكنيسة الكاثوليكية فهي متمسّكة بتعليمها بوجود المطهر وبإمكانية تقصير وقت التكفير أو الإقامة المؤقتة فيه وذلك بتأدية عمل إحسان مقبول باسم وبالنيابة عن هذه النفوس.
هكذا نشأت فكرة كتابة صلوات تقية، من تلاها باستمرار راحت الكنيسة تحدد المدة التي يمكن أن تقصّرها لمن تتلى على نيّته، أو التبرّع بمبلغ من المال لمشروع حسن أو نقل الميراث على اسم الكنيسة أو الأديرة. بدل هذه الأعمال الخيرية علّمت الكنيسة أنه يمكن من ورائها كسب غفران والتعويض عن سيئات المائت وتقصير مدة إقامته في المطهر وحرمانه من الانضمام إلى جماعة المخلّصين وتعجيل دخوله إلى السماء.
إنّ البابا بكونه نائب المسيح يقدر أن ينهل من كنز الكنيسة، أي ما عمل يسوع لخلاص العالم، لاستغلاله لخلاص النفوس. لقد جاءت مثل تلك التبرعات وتوريث الكنيسة على الأملاك لأعمال مفيدة للخير العام، كانت الكنيسة بأشد الحاجة إليها، منها بداية أو إتمام بناية الكاتدرائيات في ذلك الزمان ومن ضمنها كنيسة القديس بطرس. فحينما أعلن البابا هذه الإمكانية بين السنين 1512-1515 كان لوثر عن طريق الصدفة متواجدًا في روما للتباحث في مهام للرهبانيات، ويقول هو نفسه أنه أجهد نفسه للقيام بصلوات وأفعال تقوية لكسب الغفران، الذي كان لا يزال يعترف به، وخلاص أجداده الذين كانوا قد توفّوا قبل مدة قريبة. لكن في هذا الوقت كانت صكوك الغفرانات والحسنات التعويضية قد وصلت أوجها، خاصة وأن جهات وفئات كثيرة في الكنيسة كانت تمارسها، كما ذكرنا أعلاه.
وأثناء حديثه وجداله مع البابا حول هذه الصكوك والغفارين المتداولة توسعت نقاط الخلاف عن المضمون واختلفت الآراء بل وتباعدت عن بعضها فرجع لوثر إلى ديره حاملاً في قلبه وفي نفسه خيبة أمل تغلي غضبًا وحقدًا على الكنيسة وإدارتها وتعليمها. إذ في مسار الحديث فهم لوثر -بفهمه الشخصي لتعليم الكنيسة- أن الاعتراف وإعطاء الحسنات مقابل صكوك غفران الخطايا، هي تذكرة سفر كفيلة لدخول السماء أوتوماتيكيًا، أو أيضًا النجاة من جهنم، وما كان ذاك المقصود. ورغم ذلك أصبح هذا الاعتقاد من أهم أسباب النّزاع مع روما ممّا أدّى بالتالي إلى حرمان لوثر، ذاك العقاب الكنسي الذي هو آخر ما تلجأ إليه الكنيسة لمعاقبة شخص يثور عليها أو يعلّم تعليمًا مُغالطًا لمحتوى قوانين الإيمان. فكانت النتيجة عكسية أنه ثار على الكنيسة والبابا ونعته بالمسيح الكاذب ونادى بالتمرّد والاحتجاج على أوامره، من هنا كلمة البروتستانت Protestant أي المحتج وهكذا تُعرف الكنيسة البروتستانتية بهذا الإسم منذ 500 سنة، وفي آخر المطاف تمّ انقسام الكنيسة في الغرب إلى كاثوليكية وبروتستانتية.
حركة الإصلاح بعد 500 عام: أسباب الخلاف بين لوثر والكنيسة الكاثوليكية
حدث ذلك الخلاف للأسف لأن التوعية الدينية والعلم العميق بالأمور اللاهوتية كما هو اليوم، كان الشواذ وليس القاعدة. إذن كان بالإمكان تحاشي هذا الانشقاق الذي تتألم منه كنيسة يسوع منذ 500 سنة، لو أجهد لوثر نفسه وفهم ما عنته الكنيسة في ذلك الوقت وبروحه. فكيف نفهم، كيف نفسّر موقف الكنيسة وما عنته بتعليمها عن الغفران، كما نصلي في قانون الإيمان "نؤمن بمغفرة الخطايا".
لقد حان الوقت أن نشرح ببساطة أسباب الخلاف بين لوثر والكنيسة، فأنا على يقين أن الأكثرية الساحقة لا علم لها بأسباب الانفصال، ولماذا انشقّت كنيسة المسيح الواحدة إلى كنيستين، وأصبحت دائرة الفصل بينهما من وسيعة وكبيرة إلى أوسع وأكبر خلال الـ500 سنة الماضية بسبب التعنّت البشري وعدم المقدرة على الاعتراف بالخطأ المؤلم.
الكنيسة الكاثوليكية قد اعترفت مرارًا وتكرارًا بأخطائها عن الماضي، خاصة البابوات يوحنا بولس الثاني وبندكتس السادس عشر وفرنسيس، وأمّا الكنيسة البروتستانتية فكأنها أولاً لم تسمع بهذه الإعترافات والإستعذارات عن أخطائها، وثانيًا كأنها لم تعِ حتى اليوم ما ارتكب مؤسّسها لوثر من تجاوزات بحق الكنيسة الكاثوليكية ورئيسها خليفة القديس بطرس الموكل من المسيح لإدارتها إلى انقضاء الدهر. فكما نعرف لم يصدر منها حتى اليوم أي كلمة اعتذار أو اعتراف بزلات مؤسسها. همّها الوحيد، عندما تطالب بالوحدة، هو نسيان الماضي أو وضع غطاء عليه، كأنّ لا خلاف قائم، دون إظهار عمل شجاعة والإعتذار، إذ الإعتذار هو بداية فتح الطريق لإمكانية الإشتراك في سرّ الإفخارستيا، أي الاحتفال بالقداس، كما كان مطلبهم الأوّل والأهم من البابا بندكتس السادس عشر عندما زار ألمانيا عام 2011 وخصص لزيارة المركز اللوثري في مسقط رأس لوثر في مدينة Wittemberg زيارة خاصة للتحدّث مع المسؤولين عن طريق متابعة الحوار، لكن ولأن البابا لم يستجب لمطلبهم بالاحتفال بقداس مشترك في سنة اليوبيل أي 2017 دون أي وعد منهم بالاعتراف بحقائق الإيمان الأخرى، التي لا تعترف بها الكنيسة البروتستانتية حتى اليوم، وهي أولوية البابا التي لولاها لتفرّعت الرئاسات وتبددت وحدة الإدارة والتعليم بصوت واحد، كما الحال في الكنيسة البروتستانتية. كلمات يسوع لبطرس واضحة: "أنت الصخر، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي (متى 18:16).
كيف يفهم البروتستانت هذا الموقع المهم من الإنجيل؟
أكثر البروتستانت يفهمون اختيار يسوع لبطرس كاختيار رئيس دولة، لمدّة معيّنة، وهنا مع بطرس فقط لمدّة حياته الأرضيّة. فالمسيح أراد خلافة مؤقّتة فقط لبطرس لا لخلفائه. أما وعد يسوع فهو للكنيسة عامة، التي ستقوم بعد بطرس حتى بدون بطرس. ولكن هل هذا فعلاً ما عناه المسيح؟ هناك قسم آخر يؤوّل فهم كلمة المسيح لبطرس، أنّ المسيح عنى بناء الكنيسة على إيمان بطرس فقط وليس على شخص بطرس. وذلك لأن بطرس كان دائمًا قائد المعترفين بحقيقة يسوع: "فلمن نذهب؟"، "أنت المسيح ابن الله"، "أنت عندك كلام الحق". فهذه كلّها تأويلات تُخطئ الهدف ولا تنفع الوحدة المنشودة. وإن تشتت الكنيسة البروتستانتية هو دلالة على عدم رئاسة واحدة فيها كما أرادها المسيح.
بما أن هذه العقيدة متنازع عليها أيضًا مع الكنائس الأرثوذكسية، فلقد سمح البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني بمناقشة هذا الموضوع وأعطى هو الفكرة أنه إذا أقرت جميع الكنائس بالإعتراف بالإيمان الواحد وجميع حقائق الدين، كما علّمها يسوع ونجدها في الأناجيل وطريقة وضعها في الواقع كما أظهرها لنا الرسل (نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية)، فلن يكون من مانع لاختيار بابا أيضًا من الكنائس الأرثوذكسية. فإلى أن تتفق جميع الكنائس بما فيها الكنيسة البروتستانتية بجميع الحقائق الدينية، ولا يبقى عليها أي نزاع، سوف تجري مياه كثيرة في الوديان قبل أن تتجمّع كلها في عرض المحيط الواحد.
من ينسى في هذا المجال منشور البابا بندكتس السادس عشر عام 2007 عن "من هي الكنيسة التي أسسها المسيح؟"، معطيًا الجواب: هي الكنيسة التي تعترف بجميع تعاليم المسيح الحاوية عليها الأناجيل. فمن ينكر حقيقة واحدة من هذه الحقائق الدينية، لا يحق له أن يسمي نفسه كنيسة المسيح، بل فرع منشق عنها. مما أزعل الرئاسة البروتستانتية (فهل كل الـ253 فرعًا، بتسمياتها العديد: شهود يهوه، المعمدانية، السبتية، اليوم الآخير... التي انشقت عن الكنيسة البروتستانتية كلها كنائس حقيقية أسسها المسيح؟).
ومن الحقائق التي جرى الحديث فيها بين البابا بندكتس والكنيسة البروتستانتية عام 2011 منها الاعتراف بسر الكهنوت الخاص، الذي أسسه المسيح وربط فيه إمكانية الاحتفال بسر القربان، أي القداس. ثم الإقرار بوجود سبع أسرار، لا إثنين فقط، وماذا نقول عن إكرام القديسين وعلى رأسهم أم المسيح، التي بعد ولادة يسوع لا مكان لها في الكنيسة البروتستانتية كأن شيئًا ما كان ولا دور لها في الحياة المسيحية. فهم متشبثون بكلمة الرسل: باسمه وحده (أي يسوع) يحدث الخلاص. هذا أيضًا ما تعترف به الكنيسة الكاثوليكية "أن يسوع هو الذي مات على الصليب ليخلصنا". لكن لا ننسى أن القديسين هم وسطاء بيننا وبين المسيح، مثل أي وسيط في حياتنا اليومية لنصل إلى مطلب معيّن. بدون القبول والاعتراف بهذه الحقائق الإيمانية لا أساس لمطالب الكنيسة البروتستانتية بالوحدة كما كانت قبل 500 سنة. فهذا من المستحيلات السبع.
الكنيسة البروتستانتية بوسعها هي ألا تفوّت المناسبة التي تريد الاحتفال بها في آخر أكتوبر من هذه السنة لتفهم الخطأ الذي ارتكبه مؤسسها فتعتذر عنه، كما اعتذرت الكنيسة الكاثوليكية عن تاريخها الذي ما كان دائمًا صحيحًا أو مشرّفًا لها. من تاب عن خطأ فكأنه لم يقترفه. فتكون مناسبة الاحتفال فتح صفحة جديدة في علاقة الكنائس وتقرّبها لبعضها، فتصبح الوحدة وشيكة بل وسهلة المنال. لكن بما أن البابا لم يستجب لطلب المسؤولين بإقامة الذبيحة المشتركة المنشودة بمناسبة اليوبيل، دون القبول بالاعتراف بالحقائق المذكورة، فقد خابت آمال الكنيسة البروتستانتية من هذه الزيارة ورأت في موقف البابا تسكير باب الحوار بوجهها، وأنه يُعيق بل يقود عجلة الحوار إلى الوراء لا إلى الأمام. كما قال المثل العامّي: ضربني وبكى سبقني واشتكى!
الكنيسة لا تعارض الاتفاق والمصالحة، بل هذا هو شغلها الشاغل كلّما دار الحديث حول توحيد الكنائس، لكن على الكنيسة البروتستانتية أن تقوم من جهتها بخطوة إيجابية، نفهم منها استعدادها للاعتذار عن الماضي واستعدادها للقبول بما حذفته من حقائق لاهوتية منذ انفصالها عن الكنيسة الكاثوليكية.
نحمد الله أنّ ما مارسته الكنيسة الكاثوليكية في هذا المجال بإعطاء صكوك، أُسيء فهمُها بتسميتها صكوك الغفران، قد انتهى وقتها من سنة 1550 ولو أن ذكراها لا تزال حيّة في العقول، خاصّة المعادية للكنيسة الكاثوليكيّة (حتّى عند الإسلام الذين لا علم لهم بالموضوع، إذ فهمهم قائم فقط على الناحية المادية بمعنى بيع أوراق وابتزاز المال من الناس، دون أن يعرفوا أن ذلك سوء فهم لتعليم ديني محض لا شبيه ولا ذكر له في ديانتهم). نعم تعليم وعمر الصّكوك ما كان طويلاً وقد زال، لكن ذكر الغفران السيء لا يزال ساري المفعول ويُدرّس في كلِّ كتب التاريخ بمفهومه الخاطئ، ويعتبر ممسكًا على الكنيسة الكاثوليكية. فما هو المفهوم من هذا التعبير الذي أحدث بلبلة كبيرة؟
الكنيسة الكاثوليكيّة تميز في تعليمها، وهو الصواب، بين الحق العام والحق الشخصي، وبلغة الدين هي تميّز بين الحكم الأبدي والحكم المؤقّت. فنتيجة للاعتراف الصادق بالخطيئة تُغفر لنا الخطيئة والعقاب المؤبّد الذي نستحقه (الحق الشخصي)، وأما عقاب الحق العام فيبقى أوّلا قائمًا. والّذي نستطيع مقارنته بالقانون الجنائي العام بعد ارتكاب جريمة ما، مثلا التسبب في حادث سير إثْرَ شرب الخمور، ينجم عنها موت شخص. فبوسع اهل المائت أن يغفروا للسكران فعلته ويُسقطوا حقهم بالمطالبة بمعاقبته كجاني، وأما قانون الجناية العام فله بند خاص بسبب التصرّف الخطأ (القانون العام)، إذ يأمر بملاحقة الجاني. فما يحدث بالاعتراف هو من هذا القبيل. عندما تتوفّر التّوبة الصّادقة، يغفر الله لنا الخطيئة وعواقبها المؤقتة لكي نبدأ من جديد حياة نظيفة جديدة، وهذا ممكن فقط في الديانة، وأما عواقب الشّر المؤبّدة فتبقى مسجلة في سجلّ العقوبات إلى أن يأخذ القانون مجراه فيها. هذا العقاب، وهو منع مشاهدة الله حالا بعد الموت، مدّتها تتراوح بكمية وعدد المخالفات. كانت الكنيسة تقدّره تقديرًا كالإقامة في سجن حسب ضخامة الخطيئة أو الجرم المرتكب بكذا سنة. هذه السنين يمكن تقصيرها للمائت الغائب عن طريق الأحياء بعمل خلاصي تكفيري على نية موتاهم، من ضمنه الحسنات بقيمة كذا والتنازل عن ملك بقيمة كذا وكذا... إذن يمكن القيام بعملٍ تعويضي تكفيري عن الشر المُقترف: مثلا صلاة ندامة لائقة، أو حسنة لفقير أو محتاج أو مشروع خيري، يُرضي الله فيعمل على تقصير مدة الحرمان من مشاهدته.
مسألة الغفران والإقامة في المطهر
إن ما أثار ثائرة لوثر هو أن الكردينال البريشت Albrecht المسؤول عن ابرشيتي ماينسMainz وماجدبورج Magdeburg، أكبر مدن ألمانيا في ذلك الوقت وأوسعهما نفوذا على المواطنين، كانتا تحت سيطرة الكنيسة الواسعة باثني عشر أبرشياتها تحت إدارة البريشت، الذي بحكم قرابته الدموية للقيصر فريدرش حاكم ماجدبورج، كان مساعد القيصر وثاني أقوى رجل بعده. ومن التاريخ نحن نعلم أنه منذ بداية المسيحية في ألمانيا على يد القيصر شارلمان الكبير المتوفى عام 814 وكل خلفائه اتفقوا على حماية روما عند الحاجة. فهم كانوا يعرفون بأن الكنيسة ليست على حق كامل في خلافها مع لوثر لكنهم تمسكوا بوعدهم في حماية روما لئلا يعطوا رجلا واحدًا، أعني لوثر، حقًا فتتكذّب الكنيسة كاملة وهذا ليس من صالح القياصرة. فبقوا واقفين إلى جانبها بمحاربة لوثر، إذا لم يكفر بمنشوره والرجوع إلى حضن الكنيسة. لكن لوثر بقي على عناده إذ كان هو أيضًا سيخسر الجماهير التي صفّت إلى جانبه وسارت من وراءه احتجاجا على روما.
وسط هذه القلاقل فقد سمح البريشت ببيع الغفرانات وذخائر القديسين اللامحدودة في السوق العلني وإعطائها قوة الشفاء من الأمراض، حيث لم تكن العناية الطبية معروفة ولا تقارن بحالنا اليوم، فكان التعبد لها كأنه زيارة طبيب اليوم وربط قوة الشفاء وغفران الخطايا بالتعبد لأصحابها، إذ كان الناس يعتقدون بأنه بسبب إيمان صاحبها بالله، فإنَّ قوة المسيح الشافية كامنة في هذه القطعة من الذخائر. أضف إلى ذلك موقف الكاهن الدومينيكاني يوهانّس تيتسل Johannes Tietzel المنسّق العام لبيع الغفرانات والدفاع عنها، فقد سبب خلافًا حادًا مع لوثر الذي اختلى وألّف منشوره المعروف بالـ95 اعتراضًا على الإجراءات التي تلطّخ بها تاريخ الكنيسة للأبد. والمؤرخون يقولون تعليق هذه الإعتراضات كان بداية الإنشقاق، وهو يوم 31/10/1517 ليلة جميع القديسين الذين كان لوثر قد كرّمهم وطلب شفاعتهم لسنين طويلة. وقد كان شاهدًا لتكريم الذخائر التي كانت بحوزة الحاكم في بلده في قصر Wittember حيث اختبأ لمدة طويلة فيه وحيث كانت ذخائر القديسين في عيد جميع القديسين تُعرض في كنيسة القصر مرة في السنة. علمًا بأنه كان ممكنًا تحاشي هذا الانشقاق لو كان الناس منفتحين ومثقفين مثلنا اليوم. لوثر أراد شرح المقصود من الغفرانات وكيف يجب فهمها، كما اعتقد هو بأنه يفهمها أحسن من مطران ماينسو ماجدبورج والكاهن الدومينكاني المذكورين أعلاه، إذ هي لاهوتيًا ما كانت مدروسة أو واضحة كما هي اليوم. لكن المذكورين رفضا اللقاء به بناءً على طلبه إذا لم يستنكر بنوده الـ95 ويسحبها من السوق، لكن هذا كان مستحيلا إذ كانت قد انتشرت على نطاق واسع بين الشعب وما عاد ممكنًا سحبها من أيديهم ونسيانها. وانتشارها الواسع جعله معروفًا عند الإقطاعيين أعداء الكنيسة فساندوه فما عاد التراجع ممكنًا وإلا فسيخسر مياه وجهه وسمعته. وهذا لم يقبل به. لقد ضحّى بمفعول التقوى والاعتراف راميًا باللوم على سلطة البابا التي بدت له أعلى من سلطة الكتاب المقدس التي تشبّث بها فلقى من يساندهحيث أثار بمنشوره المعادي وشروحاته المغلوطة غضب البسطاء، وهم الأكثرية، على الكنيسة فتقرّب إليه الإقطاعيون الّذين ما كانوا مسرورين من سلطة الكنيسة وفرض الضرائب عليهم، فساندوا لوثر وانضموا إليه في ثورته ضد الكنيسة، فصدرت المقولة العامة المعروفة: ديانة القيصر هي أيضا ديانة المواطن: Cujus Regio, ejus Religio ومنذ ذلك الوقت انقسمت ألمانيا دينيًا حسب سياسة حكامها ومناطقها.
وللسبب عينه فقد قامت أول حرب دينية ضد لوثر وأتباعه عام 1544، قادها القيصر شارل الخامس الموالي للبابا بولس الثالث الذي هو أيضا كان افتتح مجمع تريانت Trient عام (1545-1565) كحركة معاكسة لحركة لوثر الذي فيه أُقِرّت أسس الكنيسة الكاثوليكية القائمة على الأسرار وفهم الخطيئة الأصلية والخلاص والرئاسة الحقيقية في الكنيسة. شارل الخامس توصّل بالقوة لإرسال مساندين للوثر إلى المجمع ليرغمهم على التراجع عن الانشقاق، لكنهم أصرّوا حتى في المجمع على رفض الصلح وتركوا الاجتماعات، إذ قالوا أوامر البابا وسلطته واضحة في القرارات. لحقها تأسيس الطقس البروتستانتي للقداس وفرض اللباس أثناء الإحتفال المعروف بلا ملابس ليتورجية معينة. هذا ولا ننسى تأليف كتاب تعليم جديد من مساعده مالنكتن المعروف تحت اسم augsburg Cathechism الذي احتوى التعليم الجديد للكنيسة البروتستانتية، ولا يزال مثلا المرجع للحوار حتى اليوم مع الكنيسة الكاثوليكية. بهذا تمّ تأسيس الكنيسة البروتستانتية بدون رئاسة معينة تُرتّب البيت من الداخل، إذ بحسب لاهوت لوثر الكنيسة هي ليست كل الأعضاء المنتمين إليها والمعمّدين فيها، إنما هي جماعة المدعوين والمخلّصين بدون استحقاق منهم إلكن بإيمانهم ورحمة الله لهم. وهنا تظهر معاكسته لتعليمه، فهو من جهة لا يريد رئاسة عامة للكنيسة بينما يفرض رئاسة للرعية المحلية لتبشيرها وتأمين ارتباط مؤمنيها مع بعض. وللتوضيح يقول رئاسة الرعية هي ليست مرتبطة بأسرار الكنيسة، من هنا عدم وجود الكهنوت فيها. بل كل واحد معمّد ومثبّت ومتعلّم يمكنه أن يقوم بوظيفة الكاهن دون الرسامة الكهنوتية.
قال المثل: في الإعادة الإفادة. لقد تحدثنا الكفاية عن الخلاف بحسب مشكلة الغفرانات وللتعميق في هذا الموضوع هذا توسيع لفهمه وفهم الخلاف بين الكنيستين بشأنه.
إنّ فكرة الغفران حسب مفهوم وتعليم الكنيسة، أي أنه يمكن تقصير الإقامة في المطهر، ما كانت غريبة، بل عليها تلميحات عدة في الكتاب المقدس، كما ذكرنا أعلاه. في كتاب المكابين الثاني (44:12) جمع يهوذا النّبيل من كلّ واحد تقدمة من الفضّة وأرسلها إلى أورشليم، ليقدَّم بها ذبيحة عن الخطيئة. وكان ذلك من أحسن الصّنع وأتقاه، لاعتقاده قيامة الموتى. لأنّه لو لم يكن مترجّيًا قيامة الّذين سقطوا، لكانت صلاته من أجل الموتى باطلا وعبثًا، ولاعتباره أنّ الّذين رقدوا بالتّقوى، قد أُدِّخر لهم ثواب جميل.
ولها ذكر آخر في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتس (3: 12-15). في هذا النص تلميح عن الحكم النّهائي في محكمة الله، حيث تُحرق أعمال الإنسان وتَفنى، وأمّا الإنسان نفسه فبعد مروره بالنّار يخلص ويتنقّى كما الذهب يتنقى في النار. فماذا يعني بولس بهذا الكلام إذا لم يكن هناك ما تمّ الإجماع على تسميته بلغة الّلاهوت بالمطهر؟ وعمّا يقوم هذا القصاص الحارق، الّذي بنهايته يدخل صاحبه الحياة الأبدية طاهرًا لامعًا كالذهب؟
أليس الحديث هنا عن الغفران؟ وماذا يعني الغفران؟ الغفران هو ليس العفو عن الخطيئة، التي تُعفى بسر التوبة والاعتراف ("من غفرتم خطاياهم تُغفر لهم" متى 16: 19)، ولكن الإعفاء من عقاب الحق العام المستوجب عليها، الّذي يجب التكفير عنه إمّا في هذه الدّنيا أو في الإقامة المؤقّتة في المطهر. هذا وبحسب تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة يمكن الإعفاء من هذا العقاب بالتّعويض عنه بما تملك هذه الكنيسة من كنوز روحيّة هي موكلة عليها، وهي استحقاقات موت يسوع لخلاص الجميع: وأنا إذا ارتفعت جذبت إليَّ الجميع" (يو 12: 32) وتضحيات القدّيسين القيّمة، كما هو مذكور عند بولس في رسالته إلى أهل كولوسي 24:1 حيث يقول: "إنّي أُتمِّم في جسدي ما نقص في آلام المسيح". طبعًا القدّيسون خَلَصوا بنعمة المسيح واستحقاقات أعمالهم الصّالحة في خدمة المسيح والكنيسة، ولذا فعرفانا لأعمالهم تستعمل الكنيسة الفائض منها وتضعه أمام الله كجزية عن عقاب خطايا المتوفّين، مثلما تضع البنوك الفوائد الناتجة عن الأموال المودعة فيها لمشاريع اجتماعية مفيدة. إذ للكنيسة الصّلاحيّة الكاملة للرجوع إلى هذه الكنوز الإلهيّة وإمكانيّة استعمالها، إلى جانب صلوات المؤمنين وتضحياتهم المقبولة عند الله. فهذا ما نسمّيه بالغفرانات الّتي أقامت لوثر وأقعدته ضدّ الكنيسة وفضّل الثورة عليها بدل الاجتهاد والتّرويّ لفهم المقصود منها. وهذا خير برهان على ارتباط الأحياء بالأموات وإمكانيّة الاتصال بهم عن طريق المسيح المصلوب الواقف عن يمين الآب كنقطة وصل بيننا وبين من سبقونا إلى الفردوس الأبدي، وإلا فما معنى الإحتفال بقداديس للموتى والصّلاة من أجل خلاصهم بمفعول صلواتنا واستحقاقات القديسين وعلى رأسهم هو المسيح الذي مات لأجلهم واستحقاقات أمه العذراء بمشاركتها في عمل الفداء حيث أقامها يسوع تحت الصليب شفيعةً وأمّاً للجميع. وهنا لا بد من ذكر نقطة لاهوتية مهمة: أن المعمّدين، سواء الأحياء أو الذين رحلوا من هذا العالم، يكوّنون جسد المسيح السرّي الواحد، فهم بواسطة المسيح الواحد مرتبطون أيضًا مع الأحياء. إذن كلا الطرفين بإمكانهم الشفاعة لبعضهم بواسطة المسيح الجالس على العرش بينهم.
للأسف أن بداية هذا النزاع الداخلي أدّى به بالتالي إلى الانفصال عن الكنيسة بل إلى تأسيس كنيسة غير الكنيسة التي ولد فيها لوثر وتعمّد وترعرع فيها ونشر بنفسه أفكارها وتعاليمها لسنين طويلة قبل انفصاله عنها، حيث حذف منها ومن تعليمها الكثير مما كان آمن به ومارسه.
هذا من ناحية. ولربما تعود ثورته على الكنيسة لحالته النفسية، فهو وإن كان راهبًا، يقول المؤرّخون أنّه ما كان يتحلّى بطبيعة هادئة بل كان ثائرا متمرّدا ولغته غير مسالمة مع كل من كان يتعامل معهم، لا يسكت على ضيم ولا عن أمرٍ لا يعجبه في أجواء الكنيسة بتعليمها وقوانينها.
الشيء الوحيد الحسن، الذي يذكرونه عنه أنّه كان رجلا روحانيا يمضي الوقت الطويل في التأمل والصلاة، وأهم شيء أنه ما كان يرمي الكتاب المقدس من يده، مدمنًا على التفتيش فيها عن حلول مشاكل تقلق مضجعه وضميره المتألم من ارتكاب الخطايا، محاولا وجود سبب يبرر هذا الضعف فيه. كان يريد أن يفهم كيف أن الله رحيم وفي الوقت ذاته يقاصص من يرتكب الخطيئة. وهذا هو السبب الذي جعله يختار الرهبنة الأغسطينية (نسبة للقديس أغسطين) فهي رهبنة حسب تعبيره بنظامها الشديد بالانقطاع عن العالم والانشغال المتواصل بالتأمل والصلاة وإتمام أعمال تقوى، علاج للفراغ والوقوع في التجارب. وإن دعت الحاجة فقد كان يلتجئ إلى الصوم والصلاة لعدة أيام جالسًا أمام المصلوب يناجيه حتى لا يسمع ولا يسمح للتجارب أن تستولي على أفكاره. فكادت حياته تكون بين جدران الدير حياة ناسك روحاني، وهذه كانت حياة واسعة الانتشار في القرون الوسطى وفي زمان لوثر بالذات.
فهذا شيء يستأهل المديح عليه. نعم إنّ له الفضل وفيما بعد للكنيسة البروتستانتية الفضل الكبير لفتح العيون على أهمّية الكتاب المقدس لكل مسيحي إذ هي ليست كتابًا للماضي بل كل ما فيها واقعي ويرمز إلى حياتنا اليوم. ومن لا يذكر أنّ امتلاكها كان ممنوعًا خارج نطاق الإكليروس، بل لمسها فقط كمِثل لمس الأواني الذهبية الليتورجية كان يُعتبر خطيئة. لقد أخذ التاريخ وقتًا طويلاً من الكنيسة الكاثوليكية حتى تفهم أهمّية كلمة الله ونشرها بين الكل وبلغات الشعوب. نقطة الانطلاق الرسمية جاءت في قرارات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني (1962 -1965)، بعد قرار ما هو معروف "بكلمة الله" – Verbum Dei.
التحضيرات في الكنيسة البروتستانتية قائمة على قدم وساق منذ عام 2007 لتهيئة الاحتفالات الكبيرة والصغيرة بمرور 500 عام على ما يسمّونه "بيوبيل حركة الإصلاح" في الكنيسة. بينما الكنيسة الكاثوليكية لا يثيرها إلاّ الاحتجاج على الكلمة "إصلاح" فأي إصلاح هو ذاك الّذي ينتج عنه مثل هذا الانقسام الذي فرّق وما وحّد. إنّ الأصح هو كلمة "تجديد" التي جاءت على لسان البابا يوحنا الثالث والعشرين يوم أعلن عن نيته بالتئام مجمع مسكوني. والتجديد هو انفتاح وتقدّم ملائم على الأساس المتين الذي بناه المسيح، لأنَّ الكنيسة التي أسسها المسيح لا تحتاج إلى إصلاح، فلا شيء فيها غلط، بل نقول "تجديد" تمسّكا بالمقولة المعروفة "الكنيسة هي دائما قابلة للتجديد على الأساس المتين فيها"، حسب قرار المجامع المسكونية: Ecclesia estsemperreformanda. فنحن لسنا بحاجة للاحتفال بأي يوبيل تجديد، إذ دولاب التجديد لا يقف، وأمّا دولاب الإصلاح فثابت في محلّه منذ 500 عامًا، غير آبهٍ لما حدث حواليه من جديد منذ عام 1517. ففي عام 1517 ما كان من حركة إصلاح معروفة وما كان لوثر قد أعلن انفصاله عن الكنيسة، وما كان هو المسؤول لا عن تجديدها ولا عن إصلاحها. هو في تلك السّنة باشر احتجاجه أي Protest على بعض التّصرّفات المشكوك في ممارستها داخل الكنيسة، جاء ذكرها في المقالات السابقة بدون تمويه أو إبعاد المسؤولية عنها. لكن لا ننسى أنّ المسؤولين عن الكنيسة هم بشر أي يغلطون ويخطؤون. لذا فعندما يغلط هؤلاء ويخطؤوا لا يجوز لنا أن نقول إن الكنيسة غلطت أو أخطأت، فالكنيسة كما قال عنها مؤسسها المسيح "أبواب الجحيم لن تقوى عليها" (متى 16: 18).
لوثر طالب بعقد مجمع مسكوني لوضع حدّ لأخطاء في الكنيسة، منها مُحِقّة ومنها غير مُحِقّة. لكنَّ خطأه الكبير كان، أنه كان يريد إدخال إصلاحات إذ لم يكن يعرف كلمة الكنيسة وهي التجديد Aggiornamento، أي بلغة التكنولوجيا اليوم actualization التي أوجدها المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 -1965) وهذا يعني التمشي بلغة العصر لا خلق أي برواز قديم. وبلسان بابا المجمع القديس يوحنا الثالث والعشرين فقد أعطى هذه الكلمة أهميّة كبيرة. التجديد لا يعرف وقتًا محدّدًا فهو دائم النّمو الطبيعي من الدّاخل وحسب الظروف، بينما الإصلاح فهو جرم كبير بحق الكنيسة، إذ يعني أنها حادت عن الطّريق القويم ويجب العودة والرّجوع، كمن يخطئ في اختيار الطريق فلا يبق له إلا العودة إلى الاتجاه الصحيح. إذن الإعلان أن الكنيسة البروتستنتية تريد الاحتفال بذكرى الإصلاح هو خاطئ، إذ يعني فقط التذكير بأخطاء صدرت قبل 500 سنة دون تقديم أية وجهة نظر إيجابية للمستقبل. فلا ضرورة إذن للاحتفال بما يسمونه 500 عام يوبيل الإصلاح. إن كان هناك من سبب مقنع للاحتفال فهو للشكر على ما تمّ منذ 50 سنة بفضل انفتاح المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ألا وهو اكتشاف نقاط معينة متقاربة بين الكنيستين، حتى وصلنا اليوم إلى القول: إنَّ ما يوحّدنا هو أكثر بكثير مما يفصلنا عن بعضنا. علما بأن الانفصال لا يزال قائما والوصول إلى الوحدة التامة أمامه طرق وحوارات شائكة وطويلة الأمد. لكن، وهذا هو المهم، مهما وصلت المحادثات والحوارات إلى أيّ تقارب ولم يتم التقارب والقبول الكامل بتعليم الكنيسة، التي أسسها المسيح وتم الإجماع على تسميتها بالكنيسة الكاثوليكية Ecclesia catholica أي العامة، أي الاعتراف بأنه إلى جانب الكهنوت العام، الذي يقع تحته كل مسيحي ومعمّد وينال كل اهتمام الكنيسة البروتستانتية، هناك كهنوت خاص، غير مقبول في تعليم الكنيسة البروتستانتية، لأشخاص منتخبين، يمكّنهم من الاحتفالبسر الإفخارستيا وإقامة الذبيحة المشتركة. فما زالت الوحدة في الإيمان بهذه الحقائق مرفوضة من الكنيسة البروتستانتية، فلن نستطيع تسميتها وحدة. هذا ولو جرت صلوات مشتركة في ما نسميه بأسبوع الوحدة، وزيارات متبادلة من كنيسة إلى أخرى، فهذا ليس دليلا على ترسيخ الوحدة على أساسها المتين. بل هي تبقى ممارسات محلّية ومن باب المجاملات والاحترامات من الطرفين. تنتهي بانتهاء الاحتفال والصلاة. وليسمح لي القارئ بمقارنتها بواقع سياسي حاضر، وهو لقاءات الفلسطينيين مع الإسرائيليين بخصوص تأسيس دولة فلسطينية بدون نتيجة فعلية، فمن اجتماع إلى اجتماع، ومن لقاء إلى لقاء، وفي وسط الحديث ينتهي الوقت وينسى الطرفان أنهما ما توصلا لإقرار شيء فعلي، إذ النية غير متوفرة من جهة معينية.
إن خطوات التقارب مع الاتحاد اللوثري العام، التي سارت وتسير مع الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 1999 بالاعتراف بقضية التبرير كما كانت قبل 500 سنة هي مشجعة ولكنها أوّلا أحادية وليست جماعية، أي لا تتكلم باسم الكنيسة البروتستانتية إجمالا، وثانيًا القبول بعقيدة واحدة لا يعني الوحدة الكاملة بباقي العقائد المتنازع عليها.
كما ذكرت أعلاه إن الإحتفال بطقس مشترك بدون الاحتفال بسر الافخارستيا، كما يحدث هنا وهناك في حفلة زواجات مختلطة، وكما حدث في خدمة عبادة مشتركة في لوند في السويد التي زارها في العام الماضي بتاريخ 31 تشرين الأول 2016، بين قداسة البابا فرنسيس برئاسته ورئاسة رئيس الإتحاد اللوثرية العالمي المطران منيب يونان، لا تعني أيضًا الوحدة بالإيمان الكامل حتى تأتي بثمار ملموسة. فهي ليست باسم جميع الكنائس البروتستانتية، كما نتمنى أن تكون.
الكنيسة البروتستنتية، لكي تُخفي أخطاءها في المسيرة المسكونية، ترمي باللوم كله على الكنيسة الكاثوليكية، الّتي لا تسمح بالاحتفال المشترك في طقس القداس، دون عمل أي خطوة من جهتها لإعلان الإيمان بوجود المسيح في القربان وبأن من يحتفل بالقداس يجب أن يكون كاهنا خاصّا مرسوما من أيدي أسقف موكل من خليفة القديس بطرس. لكن بما أن الكنيسة البروتستنتية قد قطعت علاقتها مع البابا ومع ممثليه في العالم، فهذا يعني أنه لا سيامة أسقفية فيها، بيدها نفس السلطة المعطاة للأساقفة الكاثوليك لمواصلة الرسامة والرسالة الكهنوتية عندها، وأنه لا صلاحية فيها لإقامة ذبيحة القداس المعروفة منذ عهد الرسل بتحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه وبسلطته. إذن هذا هو ما يُفسّر رفض الكنيسة الكاثوليكية الاعتراف بمفهوم الكهنوت العام في الكنيسة البروتستانتية الحاصل عليه كل معمّد، كأنه البديل عن الكهنوت الخاص، والّذي هو من اختصاص المكرّسين من أسقف يمنحهم السلطة التيتمكّنهم من القيام بقداس حسب إرادة المسيح وسلطته، هو الذي قال: "اصنعوا هذا لذكري". إنه لسابق إلى أوانه أن نقول، إن الاحتفال بهذا اليوبيل قد يكون إنهاء الحوار والمحادثات للمستقبل بدل متابعته وتسييره إلى الهدف المنشود. بل لنقل لبداية حوار مشترك جادّ للتفاهم على نقاط الخلاف بين الكنيستين، وهي كثيرة. ويجب ألا ننسى، أن الحركة المسكونية ووحدة الكنائس رغم الاختلافات،تبقى على رأس الأولويات في الحوار المشترك. فكم تمنّى البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني أن يكون القرن الجديد، الذي نحن فيه، أي الحادي والعشرين، قرن الحوار بين الأديان؟
نأمل أن يعطي اهتمام الكنيسة البروتستنتية بالحدث الذي أبعدها قبل 500 سنة عن الكنيسة الأم، نقطة تحويلٍ فكري شجاع يدفعها إلى سلك طريق الحوار والتفاهم، والتخلي عن التّعصب والإتهامات أن الكنيسة الكاثوليكية هي التي لا تريد الحوار. نتمنى فتح مسار جدّيّ في التعامل مع بعض والتفرّغ لتحمل مسؤولية واضحة أمام مشاكل الساعة الملحّة، كاتخاذ موقف موحد ضد الإرهاب والتعصب الديني، تحمُّل المسؤولية أمام اللاجئين والمشردين، حماية الطبيعة، محاربة الفقر والأمراض الفتاكة. هذا ولا ننسى حاجة العالم إلى السلام لا إلى الحروب. فموقف الكنيستين وحينما تتكلمان باسم واحد سيكون فعالا أكثر للاحتجاج على المظالم والحروب. هذه كلها مشاكل لا تُحلّ من طرف واحد بل يدا بيد وبوسعها أن تساعد على التقارب والحوار الجدي وذلك بإظهار حسن نيّة وإيجاد عامل مشترك يلغي الخلافات أوّلا بأوّل. إذ كل كنيسة تحمل في داخلها إمكانية التقارب والفهم للآخر.
في اجتماع مهم حول التحضير والاحتفال بهذه المناسبة، وُجِّه سؤال إلى المحاضر في لجنة التحضير على مستوى الكنائس الأوروبية بهذا التذكار بما معناه: الانفصال حدث قبل 500 سنة وطيلة هذه المدة لم يحدث الكثير للتقارب وللوحدة الصحيحة المنشودة، والآن كل الحديث من اليمين إلى الشمال نأمل أن يجلب الاحتفال بهذه المناسبة التقارب والوحدة. فهل هذا ممكن أم علينا أن ننتظر 500 سنة أخرى أو حتى أكثر لنعود إلى الوحدة الأصلية؟ كان الجواب ذي حدّين: أعني من المجمع الفاتيكاني الثاني 1962-1965 ابتدأت حركة تقارب وحوار جديّة غير مرتبطة بزمن محدد، فبرز هنا وهناك تحرّك إيجابي، حتى رحنا نقول: إن ما يوحدنا هو أكثر مما يفصلنا عن بعض. وثانيا متى سيتم التفاهم وتتم الوحدة الكاملة، فهذا أمر يعلم به الله وحده وهو القدير على كل شيء وبوسعه إن عملنا ما في وسعنا أن يفاجئنا، إذ هو صاحب المفاجآت.
وهذا هو رد البابا فرنسيس على سؤال الصحفيين الذي رافقوه في الطائرة من فاطيما إلى الفاتيكان بعد الاحتفال باليوبيل المئوي لظهورات فاطمة يوم 13 أيار 2017. السؤال كان:
هل يمكن للبروتستانت والكاثوليك السير على طول الطريق معًا؟ هل يمكنهم حضور نفس الإفخارستية؟
جواب البابا كان: "لقد تم اتخاذ خطوات كبيرة إلى الأمام. دعونا نفكر في وثيقة التبرير؛ لم تتوقف المسيرة منذ ذلك الحين. لقد كانت الرحلة إلى السويد هامة جدًا. وفي الرحلة المسكونية، من السير معًا، مع الصلاة، مع الاستشهاد، مع أعمال الخير والرحمة. وهناك الكاريتاس الكاثوليك واللوثري اللذين اتفقا على العمل معًا. الله هو إله المفاجآت، يجب علينا ألا نتوقف أبدًا، يجب أن نصلي معًا، نقدم شهادتنا معًا، نقوم بأعمال الرحمة معًا، ونؤكد أن يسوع هو المخلص الوحيد وأن النعمة تأتي منه فقط. وسيواصل اللاهوتيون الدراسة؛ ونحن نتحرك قدمًا ونسير إلى الأمام".
ممّا لا شك فيه، أنه عندما نقارن علاقة الكنيسة مع المجتمعات العالمية إجمالاً والدّيانات الأخرى خاصة من عام 1960 قبل المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وفي سنة 2017 حيث ستحتفل الكنيسة البروتستنتية بيوبيلها الـ500 الذي تسميه يوبيل الإصلاح (هذا ولا أدري أيَّ الإصلاح)، لنجد أن الأوضاع اختلفت تمامًا. فلقد ساعد المجمع المسكوني بقراراته على فتح الباب بمصراعيه للتحدث وربط علاقات حوارية مع كل الثقافات والإيديولوجيات المعروفة. وأما مع الديانات الأخرى فقد أوجد المجمع كلمة الحوار المسكوني، الذي ما كان معروفًا وأبدل كلمة المنشقين السلبية بكلمة أتباع الدّيانات الأخرى وعاد الحديث عن الإيمان المشترك (الذي يفهمه كلٌّ على هواه). نعم، منذ المجمع الفاتيكاني الثاني ما عاد مكان للنزاع بل لمد اليد إلى الآخر. لقد اختلفت العلاقة بين الطرفين، حيث ابتدأت اللقاءات وجها لوجه وعلى طاولة مستديرة، أوّلا للمصالحة والتعارف على بعض، إذ مرّت عصورٌ ما بادل الأخ أخيه السلام. ثانيا لاكتشاف جذور الإيمان ونقاط ممارسات مشتركة بين الطرفين، كانت إمّا غير معروفة أو مرفوضة بسب الانشقاق، مثلا الزواجات المختلطة، صلوات أسبوع الوحدة. وثالثا والأهم هو اكتشاف النقاط اللاهوتية المتنازع عليها وتكليف لجان اختصاصية لحلُّها. وهذا طريق شائك وطويل لكنه غير مستحيل.
لا ننكر بأنه بسبب الانشقاق والمناوشات الطويلة بين الطرفين، فقد تطول الفترة المستقبلية قبل حلّ ما تمّ الخلاف عليه، خاصة فَهْمُ غلطات الماضي بعقلية اليوم والتشبّث بها. لكنا نقدر أن نقول إن ما توصّل الحوار إليه بين الكنيستين في حقبة الخمسين سنة ما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني لهو أكثر بكثير ممّا حدث في الـ500 سنة الماضية.
هذا لا يعني أن الخلاف بين الكنيستين بالهيّن وسينتهي قريبًا، بل إن موقف الكنيسة البروتستنتية بالنسبة لبعض العقائد الإيمانية من 500 سنة ما تغيّر وما تبدّل، وهو للأسف موقف رفض لما يخص بعض العقائد الدينية، كما ذكرنا في مقال سابق، منها القبول بأولوية خليفة المسيح وبالعقيدة اللاهوتية الدينية المرتبطة بهذا المركز، أي عصمة البابا من الخطأ عندما يدافع باسم الكنيسة عن الإيمان والأخلاق ووصايا الله. ثم الاعتراف بسرّي الكهنوت والإفخارستيا وبتولية العذراء وإكرام القديسين بل وشفاعتهم إلى جانب شفاعة المسيح، المخلص الوحيد. وهنا لا بد من التأكيد أن هناك كثيرين حتى في قلب الكنيسة البروتستانتية نفسها غير راضين عن موقف كنيستهم بهذا الشكل العدائي، ولنا في القس Andreas Theuerer الذي كان يعتني برعية بروتستانتية كبيرة في ميونيخ أحسن مُعبّر عن هذه المقولة. القس طُرد من كنيسته البروتستانتية لأنّه اكتشف عنادها في رفض هذه الحقائق الدينية الصحيحة، كما قال عنها، ولم يقدر أن يقتنع من اعتراضات كنيسته على تعاليم وعقائد الكنيسة الكاثوليكية التي قال عنها هي الأصح والأصدق والأقدم، إذ أجدادنا ونحن آمنا بها إيمانًا متينًا لأكثر من 1500 سنة، والآن فنحن نكذّب إيمان كل الأجيال السابقة حتى تاريخ الانفصال قبل 500 سنة. لقد أصدر كتابًا قيّمًا بعنوان "لماذا لا نصبح كاثوليك". فنّد فيه كل اعتراضات الكنيسة البروتستانتية الغير مُحقّة، حتى لا نقول الباطلة على الكنيسة الكاثوليكية. لذا حرمته كنيسته فتركها هو وعائلته وهو الآن يتهيأ بدراسة اللاهوت الكاثوليكي ويريد أن يصبح كاهنًا كاثوليكيًا بعد أن تأكد أن الكنيسة الكاثوليكية فاتحة ذراعيها له ولزوجته ورفيقة حياته أيضًا.
هنا وليسمح لي القارئ باقتطاف ونشر آخر أمنيات هذا القس، الذي قريبًا ما سيقبل السيامة الكهنوتية ويعيّن في رعية كاثوليكية في أبرشية ميونيخ. هذه كلماته وأمنياته في آخر كتابه كما قلت "لماذا لا نصبح كاثوليك"... "لماذا لا زلنا بروتستانت؟ يتساءل الكاتب المحتج على كنيسته البروتستانتيّة في منشور له عام 2008 كان أعلن البابا بندكتس السادس عشر أنه لا يحق لكنيسة، لا تقبل ولا تحوي كل تعاليم المسيح الموجودة في الكتاب المقدس، أن تسمي نفسها كنيسة. فقامت ضجّة كبيرة في الكنيسة البروتستانتية ونعتت البابا بالمتشدد والمتعصب وذي الأفكار الرجعية وأنه يسد طريق الحوار وإمكانية التوحيد معهم، إذ لا يعترف بهم ككنيسة وإنما ببدعة منشقة عن الكنيسة الأم. وأما جواب البابا فكان: الوحدة في الإيمان والحقائق هي قبل الوحدة في الطّقوس. ففي فهم الحقائق الدينية واللاهوتية لا مكان لنصف حقيقة والتغطية على النصف الثاني وكأنه غير ضروري. لذا لا ينفعنا، نحن البروتستانت أن نفتش دائماً عن أعذار لبقائنا بعيدين عن تعليم الكنيسة الكاثوليكية والتشهير بها كأنها لا تريد الوحدة معنا! بالإضافة إلى إدخال تعليمات عصرية تماشي الروح العصرية ولكن ليس الدينية، كرسامة نساء بدرجة الكهنوت أو الأسقفية، تحليل الإجهاض ومباركة الأزواج المثالية المشتركة. أضيف على ذلك موافقة الكنيسة البروتستانتية بالاعتراف بزواج الشاذين واعتبار زواجهم كامل الحقوق كالزواج الذي أقره الله للبشرية.
إن أمنية الكنيسة البروتستانتية أن تعود إلى ما قبل الانفصال وتعترف الكنيسة الكاثوليكية بها لتستطيع سنة 2017 بعد 500 سنة من الانشقاق أن تحتفل بإقامة الذّبيحة المقدسة وليس فقط "بطقس العشاء الأخير". على كنيستنا البروتستانتية أن تفهم أن أسباب عدم قبول الكنيسة الكاثوليكية بنا ككنيسة وبقبول سؤالنا للوحدة معها هي ليست غلطة من الكنيسة الكاثوليكية نفسها وإنما نحن المغلوطون والمحقوقون.
هذا ما نويت التنويه إليه في كتيبي هذا. إنني لمقتنع أن كل الخلافات والاختلافات حتى الدينية قابلة كلها للحل، لو أردنا نحن البروتستانت حلها وذلك برجوعنا عن بعض مطالبنا واعتراضاتنا الغير ثابتة على الكنيسة الكاثوليكية....
نعم لماذا لا نصبح كاثوليك؟ هذا في يدنا نحن وليس في يد الكاثوليك. فأنا أتساءل: أين هي الأغلاط الدينية في الكنيسة الكاثوليكية التي تمنعني من الدخول فيها والاشتراك في ذبيحةالقداس؟ كم هو جميل أن نقرأ رسالة بولس إلى أهل كورنتس (1 كور 1: 10-13) "أناشدكم، أيها الإخوة، باسم ربنا يسوع المسيح، أن تكونوا جميعاً على وفاق في الرأي، وألا يكون بينكم اختلافات، بل كونوا على وئام تام، لكم روح واحد وفكر واحد. فقد بلغني، أيها الإخوة، أن بينكم خلافات، أعني أن كل واحد منكم يقول: أنا لبولس، وأنا لأبولس، وأنا لصخر، وأنا للمسيح. أتُرى هل المسيح انقسم؟".
عام 1517 بدأ انفصالنا عن بعضنا لعدم فهمنا لقضية منح الغفران وإمكانية الخلاص بالإيمان وحده أو مقرونا بالأعمال؟ قضية الغفران حلّت نفسها من نفسها منذ أمد بعيد. وفي عام 1999 تفاهمت الكنيسة اللوثرية مع لجان في دائرة الإيمان على حل قضية الخلاص المتنازع عليها بيننا بحل مقنع للطرفين. فبهذا وضعنا أساسًا لإمكانية التباحث والحوار في حل قضية الخلاص وباقي النقاط المتنازع عليها. فما لنا واقفون جامدون في مكاننا؟ يوبيل الـ500 سنة على الانشقاق 2017 هو على الباب، فيؤسفني أن ألاحظ أن كنيستي البروتستانتية بدل أن تعقل وتبدأ بالاعتراف بالحقائق التي رفضتها واختلفت فيها مع الكنيسة الكاثوليكية، وعن غير حق، قد وضعت على برنامجها التحضيري إظهار التعصب الجديد ضد الكنيسة الكاثوليكية، كأن عليها هي أن تطلب الإعتذار منا. فلا أستغرب أن يزداد شق الانفصال والابتعاد عن الإيمان الكاثوليكي، الذي ينقصنا في كنيستنا.
إنني على يقين، لو أن لوثر عاصر الكنيسة الكاثوليكية كما هي اليوم، لما حرّك ساكنًا ولا انشقّ عنها بل لما استطاع جرّ مؤمن واحد للانشقاق! إن ما يفصلنا عن الكنيسة الكاثوليكية اليوم لا يستأهل لا التعنت ولا الموقف السلبي الموجود في كنيستنا. لا أحد يرضى أن نبقى متعادين منفصلين في الإيمان عن بعضنا في حقائق واضحة. فلو فهمنا الحقيقة لأخذنا المسؤولية على نفسنا ونادينا بأعلى حناجرنا: لا يوجد سبب أن نبقى بعيدين عن الاتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية وتحت قيادة راعيها البابا خليفة المسيح. وانني أذكّر بهذه المناسبة كلمة المسيح لبطرس: "وأمّا أنت فثبت إيمان إخوتك لقد صلّيت من أجلك، لئلا يضعف إيمانك" (لوقا 31:12). نعم نحن بحاجة إلى هذه التقوية والوقوف جنبًا إلى جنب لنشر ملكوت الله.
كفي أيتها الكنيسة البروتستانتية. 500 سنة انفصال كفى!
الوحدة لا تتم بالجدال اللغوي بل بالمحبة الأخوية وبالصلاة. "يا أبتي! اجعلهم واحدًا كما نحن واحد" (يو 17: 11). ليكون الجميع واحدًا، كما أنّك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضًا واحدًا كما نحن واحد" (يو 17: 21). هذه أمنيتنا. وهذا مطلب الله بالذات علينا ولنا ومنّا في هذه المناسبة.