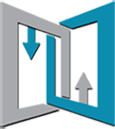الصراع على السلفية.. تحولات ما بعد «الربيع العربي»
الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:47 م
طباعة
 مصطفى حمزة
مصطفى حمزة
رغم الانتشار الواسع الذي حظيت به التيارات السلفية على تنوعها، ما بين علمية وسياسية وتربوية، وقدم هذه التيارات من الناحية التاريخية، فإن النُّخب السياسية مازالت تتعامل مع السلفيين كأنهم من «كوكب آخر»، دون النظر إلى تشعبات الحالة السلفية واتجاهاتها المختلفة، ومشاركاتها السياسية عقب الثورات العربية، التي غيرت خريطة اللاعبين السياسيين في المنطقة، وسمحت لتيارات ما يُعرف بــ«الإسلام الحركي»؛ للوصول إلى السلطة في بعض الدول، والمشاركة فيها في البعض الآخر.
وأوجد السلفيون لأنفسهم موطئ قدم داخل الملعب السياسي، في عدد من دول المشرق العربي (الخليج والعراق واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر)، بعد الثورات، مع ما ترتب على ذلك من ظهور حالة التشظي السلفي، التي استرعت اهتمام الباحث الأردني محمد أبورمان، ودفعته لتأليف كتاب بعنوان: (الصراع على السلفية.. قراءة في الأيديولوجيا والخلافات وخارطة الانتشار)، موضحًا الخلافات والاختلافات فيما بين المدارس السلفية المختلفة، حول عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، كالديمقراطية والانتخابات، وغيرهما؛ إذْ رصد مجموعة من التحولات التي ضربت الكيان السلفي؛ بسبب التغيرات السياسية الطارئة، التي نقلتهم فجأة من عزلتهم السلفية إلى قلب المشهد السياسي.
ورصد الكتاب، المكون من 5 فصول الصراع السلفي- السلفي في الدول المذكورة، بعد أن طرح نبذة تاريخية عن الاتجاهات السلفية في فصل تمهيدي، ثم خصص الفصل الأول للحديث عن الوجود السلفي في 4 دول خليجية، هي: السعودية والكويت والبحرين واليمن، ثم استعرض مسارات التشكل السلفي، في سوريا والعراق ولبنان والأردن، في الفصل الثاني من الكتاب، لينتقل إلى مصر والتحولات السلفية فيها بعد ما يعرف بـ«الربيع العربي»، في فصل مستقل؛ ليتطرق بعد ذلك لإشكالية الديمقراطية والعلمنة عند السلفيين في الفصل الرابع، مختتمًا كتابه بالفصل الخامس الذي تحدث عن هوية السلفيين بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وفق المؤلف، فإن السلفيين يعتبرون أنفسهم امتدادًا لأهل الحديث، الذين عاشوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ووقفوا في مواجهة الفرق والمدارس الإسلامية الأخرى، رغم حداثة مصطلح «السلفية» بمعناه المعاصر، وهي ليست مجرد اتجاه فكري «فقهيًّا وعقائديًّا»، فحسب، وإنما تمثل حالةً معاصرة لها حضورها الملحوظ في مختلف مناحي الحياة العربية.
أوضح الكتاب، الذي نشرته الشبكة العربية للأبحاث والنشر ببيروت، أن الحركات والاتجاهات السلفية متباينة فيما بينها حول مسألتين أساسيتين، هما: تعريف الواقع السياسي العربي المعاصر، فمنهم من تكفر الحكومات العربية، ومنهم من توجب طاعتها تقربًا إلى الله، وحركات أخرى تقف وسطًا بين هؤلاء وأولئك، وكذلك يختلفون فيما بينهم حول تحديد استراتيجية التغيير أو الإصلاح وأولوياته، ما بين من ترى ضرورة العمل المسلح، ومن ترفضه تمامًا، وتفضل العمل السياسي بدلًا منه، وأخرى تهتم بالتربية والدعوة، وتعتبرها الطريق الوحيدة للتغيير.
إلا أن المؤلف تجاهل التباينات الأخرى، لاسيما العقائدية والمنهجية والفقهية –غير السياسية- بين هذه التيارات السلفية، مثل التوحيد الذي يقسمه بعضهم إلى «ألوهية وربوبية وأسماء وصفات»، ويضيف إليها آخرون «توحيد الحاكمية»، وكذلك حكم الاختلاط بين الرجال والنساء، وسماع الأغاني والموسيقى، وإطلاق اللحية، ولبس النقاب، والموقف من المسيحيين، واكتفى بالإشارة إلى شيء منها في الفصل الأخير من الكتاب، الذي تحدث فيه عن تعدد الهويات السلفية.
ومع كل الاختلافات الموجودة بين السلفيين، إلا أن «أبورمان» أشار في الفصل التمهيدي من كتابه، إلى وجود هاجس تاريخي لايزال يخيم على عقولهم جميعًا، ألا وهو أن السلفي يعتبر نفسه «سادن الهوية» وحاميها والمحافظ عليها من الانحرافات، مَثَلُه في ذلك مَثَلُ السلف الصالح من الأنبياء والصحابة والتابعين من أبناء القرون الخيرية الثلاثة المفضلة (الأول والثاني والثالث الهجرية).
واعتمد المؤلف في الفصل ذاته، تقسيم الباحثين للسلفية إلى أربعة اتجاهات؛ هي: التقليدية، الجامية، الحركية، الجهادية، بداخل كل اتجاه منهم تيارات تتصارع فيما بينها على مشروعية وشرعية التمثيل، في كل من السعودية والكويت والبحرين واليمن ومصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن وفلسطين، مع الاحتفاظ بخصوصية كل منهم حسب الظروف السياسية والاجتماعية لكل من هذه الدول.
وميَّزَ الباحث السلفية الإصلاحية (إحدى المدارس القريبة من السلفية الحركية)، بالدعوة إلى التجديد، ونبذ التعصب المذهبي؛ إلا أن هذا من المشتركات التي تدعو إليها جميع المدارس السلفية بدءًا من «السلفية التاريخية» التقليدية، انتهاءً بالسلفية الجهادية، مرورًا بالسلفية العلمية والسياسية، حتى وإن اختلفت ممارساتهم على الأرض فيما يخص التقليد والتعصب لمشايخهم، بل إن عامة السلفيين لا يعتبرون قادة «السلفية الإصلاحية» -أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا- سلفيين.
وتناول الفصل الأوَّل من الكتاب، أثر التغيرات الإقليمية الجديدة المرتبطة بالثورات العربية على المدارس السلفيَّة؛ إذْ منحت السلفية الحركية زخمًا، ودفعتها نحو تطور أدوراها السياسيَّة، مقابل تراجع السلفية التقليدية والجامية «المدخلية»، التي وجدت كل منهما نفسها في مأزق فكري، مع عجز خطابهما السياسي عن الإجابة عن التساؤلات الرئيسية المصاحبة للبيئة الثورية الجديدة، إلا أن المؤلف ربط التنبؤ بمسارات وتطورات الاتجاهات السلفية، وفق محددات كل دولة وديناميكياتها الداخلية، التي فرضت –ولاتزال- نفسها على توجهات السلفيين ومواقفهم وتحولاتهم.
وتناول الفصل الثاني الصراع السلفي في دول عدّة، ففي سوريا تمددت السلفية الجهادية في ظل حالة الفوضى الداخلية والطائفية المذهبية التي تتغذى عليها هذه المدرسة، لاسيما في الأرياف والأطراف، مع صعوبة التنبؤ بالصورة النهائية للمشهد السلفي السوري، ومآلات الاتجاهات المتعددة هناك، أو السيناريوهات المستقبلية لها، على الأقل في الوقت الراهن، وهو الأمر نفسه الذي انسحب على العراق؛ بسبب تشابه حالة الفوضى بين البلدين، لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين، وصولًا لظهور تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يتبنى في الأساس أيديولوجية المدرسة السلفية الجهادية.
أما سلفية لبنان فتميزت -كنظيراتها في العالمين العربي والإسلامي- بالتصلب الإيديولوجي والنزعة المشيخية؛ ولذلك يصعب –وفق «أبورمان»- صهرها في إطار تنظيمي موحد، على اعتبار أنها تتسم بالتجزؤ والانقسام والخلاف والاختلاف، والانتقال والتحول بين السلفيات العديدة من السلمية إلى الجهادية ومن الموالاة إلى المعارضة.
حالة التمدد السلفي، المصحوب بالصراع على السلفية في المنطقة العربية كان واضحًا في الأردن، وهو ما تعكسه حالة الاستقطاب المستمرة بين طرفي السلفية (التقليدية والجهادية)، إذ تعد المملكة الأردنية معقلًا للتيارين، الأول يمثله الألباني وتلاميذه، والثاني يمثله أبومحمد المقدسي وأنصاره.
وشغلت خريطة الصراع على السلفية في الداخل المصري حيزًا كبيرًا من الكتاب، إذْ خصص لها المؤلف الفصل الثالث، للحديث عن «الجزر السلفية المتفرقة»، والتي تباينت أكثر مع تحولات ما بعد 25 من يناير 2011؛ ليتجه بعضها نحو الديمقراطية، بشكل يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا التحول تكتيكيًّا، أم استراتيجيًّا؟!.
وكشف هذا الفصل من الكتاب عن حجم الاختلافات البينية داخل التيارات السلفية، والتي طفت على السطح بعد الثورة، لينقسم السلفيون تجاهها إلى ثلاثة أقسام؛ الأول انخرط مع الثورة والعمل السياسي وتخلى عن مواقفه السابقة وإن شكليًّا فقط، ويمثله «السلفية القطبية» بزعامة التكفيري الهارب خارج مصر محمد عبدالمقصود، والثاني التزم بموقفه المعتزل للسياسة؛ عملًا بمقولة الألباني: «من السياسة ترك السياسة»، ويمثله تيار ما يعرف بـ«السلفية المدخلية»، بزعامة الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، وهشام البيلي، ومحمود الرضواني، وغيرهم.
أما الفريق الثالث، فحافظ على صمته باعتبار أن ما يحدث من الفتن الواجب اجتنابها، دون أن ينحاز لأحد الفريقين، تجنبًا للرهانات المترتبة على موقف كليهما، ومثال هذا الفريق، الداعية أبوإسحاق الحويني ومصطفى العدوي، وغيرهما، إلا أن بعضهم تراجع عن موقفه بعد نجاح الثورة، فيما حاول محمد حسان مسك العصا من المنتصف، ونظرت الدعوة السلفية بالإسكندرية إلى الثورة باعتبارها مؤامرة، على الرغم من أنها أكثر التيارات السلفية استفادة من الثورة حتى الآن، ولاتزال محافظة على بعض مكتسباتها السياسية والبرلمانية من خلال حزب النور، الذي أسس في يونيو 2011.
وأشار «أبورمان» في الفصل الثالث من كتابه إلى أن معركة «الصراع على الدستور» هي «العربة» التي ركبها السلفيون، في تسويغ الانتقال من رفض المشاركة السياسية والاستنكاف عن العمل الحزبي، إلى الدخول في قلب العملية السياسية والسجالات الدائرة، بذريعة حماية الهوية الإسلامية من جهة، والصراع مع التيارات التي تريد تغييرها من جهة أخرى، ومحاولة استثمار الديمقراطية للوصول إلى حلم تطبيق الشريعة الإسلاميَّة، عبر تفعيل المادة الثانية من الدستور، وعبر الوصول إلى الأغلبية في البرلمان المصري.
ويستمر الصراع على الدور السياسي للسلفيين في الوطن العربي - من خلال ما يطرحه الفصل الرابع - بين فرضيتين متضاربتين؛ الأولى تقوم على أن الأحزاب السلفية السياسية سوف تطور من خطابها الإيديولوجي والفكري، لتصبح أكثر براجماتية (نفعية) وواقعية، والثانية تتمثل في أنها ستأخذ طابعًا سلبيًّا من المشاركة السياسية، وتشكك في مدى التزام السلفيين بمبادئ الديمقراطية، إلا أن الباحث «أبورمان» لم يرجح أيًّا من الفرضيتين، نظرًا لعدم اكتمال التجربة التي لاتزال مستمرة حتى تأليف كتابه، رغم تأكيده على عدد من المسلمات التي تحكم الخطاب السلفي، من بينها الفصل بين الجانب الفلسفي للديمقراطية وآلياتها، بدعوى قبول الآليات مع رفض الفلسفة، فيقبلون بالصندوق كأداة للوصول إلى السلطة وتداولها، لكنهم لا يقبلون بالدولة المدنية أو العلمانية إذا جاء بها هذا الصندوق؛ ولذا أكد المؤلف صعوبة الفصل بين الفلسفة والآليات الديمقراطية.
وفي الفصل الأخير من الكتاب يتلخص الصراع على السلفية، في التنافس بين معتنقي التيارات المختلفة «ذات التوجه السلفي» والتسابق فيما بينهم لإثبات أولوية كل منهم بحمل الفهم الصحيح للإسلام، والذي يضع فريقه فقط ضمن دائرة «الفرقة الناجية»، و«الطائفة المنصورة»، كوريث شرعي لأهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى لو استدعى ذلك إخراج كل فريق «سلفي» للفريق الآخر «السلفي أيضًا» من دائرة السلفية، ورميه بالانتقال لداوائر أخرى مثل «أهل البدعة» أو «أهل الضلال»؛ ما يعمق حالة الصراع والتشظي السلفي المعاصرة، والتي تتزايد مع غموض مستقبل السلفيين بعد دخولهم حلبة الصراع السياسي في الوطن العربي، والذي لايزال قيد التجربة والتقييم.
وأوجد السلفيون لأنفسهم موطئ قدم داخل الملعب السياسي، في عدد من دول المشرق العربي (الخليج والعراق واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر)، بعد الثورات، مع ما ترتب على ذلك من ظهور حالة التشظي السلفي، التي استرعت اهتمام الباحث الأردني محمد أبورمان، ودفعته لتأليف كتاب بعنوان: (الصراع على السلفية.. قراءة في الأيديولوجيا والخلافات وخارطة الانتشار)، موضحًا الخلافات والاختلافات فيما بين المدارس السلفية المختلفة، حول عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، كالديمقراطية والانتخابات، وغيرهما؛ إذْ رصد مجموعة من التحولات التي ضربت الكيان السلفي؛ بسبب التغيرات السياسية الطارئة، التي نقلتهم فجأة من عزلتهم السلفية إلى قلب المشهد السياسي.
ورصد الكتاب، المكون من 5 فصول الصراع السلفي- السلفي في الدول المذكورة، بعد أن طرح نبذة تاريخية عن الاتجاهات السلفية في فصل تمهيدي، ثم خصص الفصل الأول للحديث عن الوجود السلفي في 4 دول خليجية، هي: السعودية والكويت والبحرين واليمن، ثم استعرض مسارات التشكل السلفي، في سوريا والعراق ولبنان والأردن، في الفصل الثاني من الكتاب، لينتقل إلى مصر والتحولات السلفية فيها بعد ما يعرف بـ«الربيع العربي»، في فصل مستقل؛ ليتطرق بعد ذلك لإشكالية الديمقراطية والعلمنة عند السلفيين في الفصل الرابع، مختتمًا كتابه بالفصل الخامس الذي تحدث عن هوية السلفيين بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وفق المؤلف، فإن السلفيين يعتبرون أنفسهم امتدادًا لأهل الحديث، الذين عاشوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ووقفوا في مواجهة الفرق والمدارس الإسلامية الأخرى، رغم حداثة مصطلح «السلفية» بمعناه المعاصر، وهي ليست مجرد اتجاه فكري «فقهيًّا وعقائديًّا»، فحسب، وإنما تمثل حالةً معاصرة لها حضورها الملحوظ في مختلف مناحي الحياة العربية.
أوضح الكتاب، الذي نشرته الشبكة العربية للأبحاث والنشر ببيروت، أن الحركات والاتجاهات السلفية متباينة فيما بينها حول مسألتين أساسيتين، هما: تعريف الواقع السياسي العربي المعاصر، فمنهم من تكفر الحكومات العربية، ومنهم من توجب طاعتها تقربًا إلى الله، وحركات أخرى تقف وسطًا بين هؤلاء وأولئك، وكذلك يختلفون فيما بينهم حول تحديد استراتيجية التغيير أو الإصلاح وأولوياته، ما بين من ترى ضرورة العمل المسلح، ومن ترفضه تمامًا، وتفضل العمل السياسي بدلًا منه، وأخرى تهتم بالتربية والدعوة، وتعتبرها الطريق الوحيدة للتغيير.
إلا أن المؤلف تجاهل التباينات الأخرى، لاسيما العقائدية والمنهجية والفقهية –غير السياسية- بين هذه التيارات السلفية، مثل التوحيد الذي يقسمه بعضهم إلى «ألوهية وربوبية وأسماء وصفات»، ويضيف إليها آخرون «توحيد الحاكمية»، وكذلك حكم الاختلاط بين الرجال والنساء، وسماع الأغاني والموسيقى، وإطلاق اللحية، ولبس النقاب، والموقف من المسيحيين، واكتفى بالإشارة إلى شيء منها في الفصل الأخير من الكتاب، الذي تحدث فيه عن تعدد الهويات السلفية.
ومع كل الاختلافات الموجودة بين السلفيين، إلا أن «أبورمان» أشار في الفصل التمهيدي من كتابه، إلى وجود هاجس تاريخي لايزال يخيم على عقولهم جميعًا، ألا وهو أن السلفي يعتبر نفسه «سادن الهوية» وحاميها والمحافظ عليها من الانحرافات، مَثَلُه في ذلك مَثَلُ السلف الصالح من الأنبياء والصحابة والتابعين من أبناء القرون الخيرية الثلاثة المفضلة (الأول والثاني والثالث الهجرية).
واعتمد المؤلف في الفصل ذاته، تقسيم الباحثين للسلفية إلى أربعة اتجاهات؛ هي: التقليدية، الجامية، الحركية، الجهادية، بداخل كل اتجاه منهم تيارات تتصارع فيما بينها على مشروعية وشرعية التمثيل، في كل من السعودية والكويت والبحرين واليمن ومصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن وفلسطين، مع الاحتفاظ بخصوصية كل منهم حسب الظروف السياسية والاجتماعية لكل من هذه الدول.
وميَّزَ الباحث السلفية الإصلاحية (إحدى المدارس القريبة من السلفية الحركية)، بالدعوة إلى التجديد، ونبذ التعصب المذهبي؛ إلا أن هذا من المشتركات التي تدعو إليها جميع المدارس السلفية بدءًا من «السلفية التاريخية» التقليدية، انتهاءً بالسلفية الجهادية، مرورًا بالسلفية العلمية والسياسية، حتى وإن اختلفت ممارساتهم على الأرض فيما يخص التقليد والتعصب لمشايخهم، بل إن عامة السلفيين لا يعتبرون قادة «السلفية الإصلاحية» -أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا- سلفيين.
وتناول الفصل الأوَّل من الكتاب، أثر التغيرات الإقليمية الجديدة المرتبطة بالثورات العربية على المدارس السلفيَّة؛ إذْ منحت السلفية الحركية زخمًا، ودفعتها نحو تطور أدوراها السياسيَّة، مقابل تراجع السلفية التقليدية والجامية «المدخلية»، التي وجدت كل منهما نفسها في مأزق فكري، مع عجز خطابهما السياسي عن الإجابة عن التساؤلات الرئيسية المصاحبة للبيئة الثورية الجديدة، إلا أن المؤلف ربط التنبؤ بمسارات وتطورات الاتجاهات السلفية، وفق محددات كل دولة وديناميكياتها الداخلية، التي فرضت –ولاتزال- نفسها على توجهات السلفيين ومواقفهم وتحولاتهم.
وتناول الفصل الثاني الصراع السلفي في دول عدّة، ففي سوريا تمددت السلفية الجهادية في ظل حالة الفوضى الداخلية والطائفية المذهبية التي تتغذى عليها هذه المدرسة، لاسيما في الأرياف والأطراف، مع صعوبة التنبؤ بالصورة النهائية للمشهد السلفي السوري، ومآلات الاتجاهات المتعددة هناك، أو السيناريوهات المستقبلية لها، على الأقل في الوقت الراهن، وهو الأمر نفسه الذي انسحب على العراق؛ بسبب تشابه حالة الفوضى بين البلدين، لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين، وصولًا لظهور تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يتبنى في الأساس أيديولوجية المدرسة السلفية الجهادية.
أما سلفية لبنان فتميزت -كنظيراتها في العالمين العربي والإسلامي- بالتصلب الإيديولوجي والنزعة المشيخية؛ ولذلك يصعب –وفق «أبورمان»- صهرها في إطار تنظيمي موحد، على اعتبار أنها تتسم بالتجزؤ والانقسام والخلاف والاختلاف، والانتقال والتحول بين السلفيات العديدة من السلمية إلى الجهادية ومن الموالاة إلى المعارضة.
حالة التمدد السلفي، المصحوب بالصراع على السلفية في المنطقة العربية كان واضحًا في الأردن، وهو ما تعكسه حالة الاستقطاب المستمرة بين طرفي السلفية (التقليدية والجهادية)، إذ تعد المملكة الأردنية معقلًا للتيارين، الأول يمثله الألباني وتلاميذه، والثاني يمثله أبومحمد المقدسي وأنصاره.
وشغلت خريطة الصراع على السلفية في الداخل المصري حيزًا كبيرًا من الكتاب، إذْ خصص لها المؤلف الفصل الثالث، للحديث عن «الجزر السلفية المتفرقة»، والتي تباينت أكثر مع تحولات ما بعد 25 من يناير 2011؛ ليتجه بعضها نحو الديمقراطية، بشكل يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا التحول تكتيكيًّا، أم استراتيجيًّا؟!.
وكشف هذا الفصل من الكتاب عن حجم الاختلافات البينية داخل التيارات السلفية، والتي طفت على السطح بعد الثورة، لينقسم السلفيون تجاهها إلى ثلاثة أقسام؛ الأول انخرط مع الثورة والعمل السياسي وتخلى عن مواقفه السابقة وإن شكليًّا فقط، ويمثله «السلفية القطبية» بزعامة التكفيري الهارب خارج مصر محمد عبدالمقصود، والثاني التزم بموقفه المعتزل للسياسة؛ عملًا بمقولة الألباني: «من السياسة ترك السياسة»، ويمثله تيار ما يعرف بـ«السلفية المدخلية»، بزعامة الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، وهشام البيلي، ومحمود الرضواني، وغيرهم.
أما الفريق الثالث، فحافظ على صمته باعتبار أن ما يحدث من الفتن الواجب اجتنابها، دون أن ينحاز لأحد الفريقين، تجنبًا للرهانات المترتبة على موقف كليهما، ومثال هذا الفريق، الداعية أبوإسحاق الحويني ومصطفى العدوي، وغيرهما، إلا أن بعضهم تراجع عن موقفه بعد نجاح الثورة، فيما حاول محمد حسان مسك العصا من المنتصف، ونظرت الدعوة السلفية بالإسكندرية إلى الثورة باعتبارها مؤامرة، على الرغم من أنها أكثر التيارات السلفية استفادة من الثورة حتى الآن، ولاتزال محافظة على بعض مكتسباتها السياسية والبرلمانية من خلال حزب النور، الذي أسس في يونيو 2011.
وأشار «أبورمان» في الفصل الثالث من كتابه إلى أن معركة «الصراع على الدستور» هي «العربة» التي ركبها السلفيون، في تسويغ الانتقال من رفض المشاركة السياسية والاستنكاف عن العمل الحزبي، إلى الدخول في قلب العملية السياسية والسجالات الدائرة، بذريعة حماية الهوية الإسلامية من جهة، والصراع مع التيارات التي تريد تغييرها من جهة أخرى، ومحاولة استثمار الديمقراطية للوصول إلى حلم تطبيق الشريعة الإسلاميَّة، عبر تفعيل المادة الثانية من الدستور، وعبر الوصول إلى الأغلبية في البرلمان المصري.
ويستمر الصراع على الدور السياسي للسلفيين في الوطن العربي - من خلال ما يطرحه الفصل الرابع - بين فرضيتين متضاربتين؛ الأولى تقوم على أن الأحزاب السلفية السياسية سوف تطور من خطابها الإيديولوجي والفكري، لتصبح أكثر براجماتية (نفعية) وواقعية، والثانية تتمثل في أنها ستأخذ طابعًا سلبيًّا من المشاركة السياسية، وتشكك في مدى التزام السلفيين بمبادئ الديمقراطية، إلا أن الباحث «أبورمان» لم يرجح أيًّا من الفرضيتين، نظرًا لعدم اكتمال التجربة التي لاتزال مستمرة حتى تأليف كتابه، رغم تأكيده على عدد من المسلمات التي تحكم الخطاب السلفي، من بينها الفصل بين الجانب الفلسفي للديمقراطية وآلياتها، بدعوى قبول الآليات مع رفض الفلسفة، فيقبلون بالصندوق كأداة للوصول إلى السلطة وتداولها، لكنهم لا يقبلون بالدولة المدنية أو العلمانية إذا جاء بها هذا الصندوق؛ ولذا أكد المؤلف صعوبة الفصل بين الفلسفة والآليات الديمقراطية.
وفي الفصل الأخير من الكتاب يتلخص الصراع على السلفية، في التنافس بين معتنقي التيارات المختلفة «ذات التوجه السلفي» والتسابق فيما بينهم لإثبات أولوية كل منهم بحمل الفهم الصحيح للإسلام، والذي يضع فريقه فقط ضمن دائرة «الفرقة الناجية»، و«الطائفة المنصورة»، كوريث شرعي لأهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى لو استدعى ذلك إخراج كل فريق «سلفي» للفريق الآخر «السلفي أيضًا» من دائرة السلفية، ورميه بالانتقال لداوائر أخرى مثل «أهل البدعة» أو «أهل الضلال»؛ ما يعمق حالة الصراع والتشظي السلفي المعاصرة، والتي تتزايد مع غموض مستقبل السلفيين بعد دخولهم حلبة الصراع السياسي في الوطن العربي، والذي لايزال قيد التجربة والتقييم.