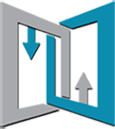ابن خلدون وميكيافيللي.. بين الدولة والدين
الأحد 14/أبريل/2019 - 02:21 م
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
يقدم الباحث المغربي عبد الرحيم العلام، دراسة مهمة تم نشرها في اكثر من مكان متخصص، آخرها مركز دراسات الوحدة العربية، يناقش فيها "سؤال الدولة والدين عند مكيافيلي وابن خلدون" رغم ما تبدو هذه المقارنة بين ابن خلدون (1332 – 1406) ومكيافيلي (1469 – 1527) غير ذات أهمية، وذلك بالنّظر إلى ما يمكن أن تتركه بعض مَواطن الاختلاف بينهما فكراً وحياة من إيحاء باستحالة المقارنة.
لكن حسب الكاتب فإن "ما يشترك فيه الرجلان هو أن كليهما هجرا اليوتوبيات، وانخرطا تفكيراً وممارسة في الواقع والسياسة العَمَلية. فإذا كان مكيافيلي قد شغل منصب سكرتير المستشارية الثانية لجمهورية «فلورنسا» لمدة ثلاثة عشر عاماً، فإن ابن خلدون، ورغم عدم تقلُّده المناصب السياسية، إلا أنه أدّى العديد من المهام السياسية الخارجية لبعض الأمراء، كما هاجر إلى مصر وشغل منصب القضاء المالكي بتكليف من سلطانها «الظاهر برقوق»، لمدة غير يسيرة. لقد أراد الرجلان أن يؤدّيا دوراً في السياسة العملية؛ وكلاهما فشل من وجهة نظر عبد الله العروي: «فعودة المديسيسيّين إلى فلورنسا، وبعد فاصل جمهوري قصير، أبعدت مكيافيلي عن جادات السلطة ومسالكها. عندها حاول أن يؤثر من بعيد في فعل الآخرين، لكن المديسيسيّين لم يفكروا إلا بإحراجه أمام أصدقائه السياسيين، فكلفوه بمهام ثانوية. وأراد ابن خلدون أن يوجه سياسة أمير بوجة، ثم قرر أن يربّي أمير غرناطة؛ وكل محاولة تؤول إلى السجن والفرار» (العروي، 1990: 8). كما اهتم مكيافيلي كثيراً بالقضايا العسكرية، وبذل كل ما بوسعه لكي تتخلّص فلورنسا من المرتزقة وتشكل جيشاً شعبياً، كان يظنه قادرا على التنظيم والقيادة ميدانياً، فإن ابن خلدون قد عمل، في خلال زمن معين، متطوّعاً لمصلحة السلاطين الحفصيين، لدى قبائل بني هلال التي كانت تخدم طوعاً كقوى مساعدة؛ واكتسب من ذلك خبرة في المسائل العسكرية كما كانت تُطرح في عصره (العروي، 1990: 8)
ويستطرد الكاتب "ولم يكن الاهتمام بالشأن العام هو ما جمع بين كاتبَيْنا فحسب، وإنما اشتركا أيضاً في خيبات الأمل المترتّبة عن ذلك، فعندما «أرغم مكيافيلي على تجميد نشاطه، واعياً تقريباً أن مِثاله الجمهوري كان مُمتنع التطبيق في إيطاليا محتلة، التفت نحو المرحلة المضيئة في التاريخ الإيطالي، مرحلة تأسيس روما مجلس الشيوخ والقناصل، لينهَل منها العبر الصالحة لكل الأزمنة. يقول إن «محاكاة أفعال الماضي الجميلة تبدو مستحيلة في نظر المحدثين، كما لو كانت السماء والشمس والعناصر والبشر قد غيرت نظامها وحركت قوتها، وكانت متباينة عما كانت عليه في الماضي». أما ابن خلدون فلقد انسحب «طوعاً وكُرها، من السياسة ليتفرّغ لدراسة التاريخ» (العروي، 1990: 9). هذا الانتقال من الفعل إلى التأمل، من السياسة إلى التاريخ، حسب العروي، هو الذي مهّد للرجلين الطريق لاكتشاف ميدان معرفي بِكر حتى ذلك الحين. يقول الفلورنسي: «عزمتُ على فتح طريق جديد»، ويقول المغاربي: «كشف الله لي [هذا العلم] دون عون أرسطو أو أي حكيم أعجمي» (العروي، 1990). ليس هذه هي النقط الوحيدة التي يشترك فيها العالمان، ولكن هناك العديد من مناحي التشابه بين حياتَي كل منهما، ولكن حسبنا هذه الإشارات المقتضبة ما دام التركيز منصباً على مضمون إنتاجهما العلمي لا على سيرتيْهما الذاتيتين".
وإذا كان واقع إيطاليا قد دفع بمكيافيلي إلى استهجان الحكم الديني، ووسَمه بكل النعوت السلبية، فإن واقع المسلمين الذي لا يقلُّ مأزوميةً عن واقع إيطاليا في تلك اللحظة، هو ما حفّز ابن خلدون على انتقاد واقع زمانه الذي تخلّت فيه «الدولة» عن الدعوة الدينية. حيث يَستعيدُ ابن خلدون التاريخ ويستقرئ المعيش كي يُدلّل على ما يذهب إليه؛ فمن التاريخ يستحضر تجربة الحُكم الرّاشدي ويعتبرها ذروة ما وصل إليه المسلمون، ثم ما لبثوا أن تهاووا نحو دول ظالمة لا تقيم للشرع قائمة، ثم إنهم بعد ذلك «انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين فنسوا السياسة ورجعوا إلى فقرهم، وجهلوا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة ببعدهم من الانقياد، وإعطاء النصفة، فتوحّشوا كما كانوا ولم يبق لهم من اسم المُلك إلا أنهم من جنس الخلفاء ومن جيلهم، ولما ذهب أمر الخلافة وامّحى رسمها انقطع الأمر جملة من أيديهم وغلب عليهم العجم دونهم، وأقاموا في بادية قفارهم لا يعرفون المُلك ولا سياسته، بل قد يجهل الكثير منهم أنهم قد كان لهم ملك في القديم» (ابن خلدون، 2004: 290 – 291). ومن المعيش ينقل ابن خلدون الحال الذي آلت إليه «الدولة الموحّدية» بعدما تقوّت وسادَت أيام استنادها إلى الدعوة الدينية للمهدي ابن تومرت وعبد المؤمن، حتى إنها تجلّدت على من هم أجلد منها وأصلب، لكنها لمّا تخلّت عن دعوتها الدينية هانت وسهُل الهوان عليها. فالسبب الأساسي إذاً، لمَهلكة المسلمين وتشتت حُكمهم راجع، حسب ابن خلدون، إلى كونهم لا يُقوّون عصبية الدم بالدعوة الدينية كي يتحول الكل إلى عصبية سياسية. هنا هل يَفترق ابن خلدون افتراقاً حَدّيًّا عمّا ذهب إليه مكيافيلي؟ وهل الأخير فعـلاً نصح الأمير بأن يُبعد نفسه ودولته عن العناية بالدين؟
الواقع، أنه لو اكتفينا بقراءة كتاب الأمير وهو الأشهَر، لكان بالإمكان القول، إنَّه لا مجال لالتقاء مكيافيلي بابن خلدون، ولأمكن التقرير بأن الأول ينصحُ الأمير بأن يتحرّر من الدين، بل عليه أن يعادي أي دعوة دينية، لكن إذا عدنا إلى كتابه المطارحات فإن الصورة ستختلف كليّاً، وستبرز عناصر التشابه بين الرجلين؛ فمكيافيلي على الرغم من رفضه الحكم الكنسي، إلا أنه لا يتحرّج من توظيف الدين لغايات المصلحة العامة، من قَبِيل إضفاء الطابع الديني على القوانين الوضعية، وإظهار الاعتناء بالدين وطقوسه، حتى من غير أن يكون الأمير مُعتنقاً أي دين. لقد مرّ معنا كيف أن مكيافيلي يُرجِع كل الفشل الذي يعتري الأمّة الإيطالية إلى الحكم الكنسي، وأن البابوية أفسدت الشعب من مختلف النواحي، بما في ذلك دفعه إلى هجر الدين المفروض عليه من قِبل رجال دين فاسدين. لكن هذا الموقف لم يمنع كاتب المطارحات من نُصح الأمراء والجمهوريات، إذا هُم رغبوا في النجاة من الاحتلال، بأن يحتفظوا «بنقاء طقوس الديّانة التي يؤمن الأمير أو الجمهورية بها، وأن يحلّوها محلّ الإجلال دائماً، إذ لا دليل أصدق على انحطاط أي بلد من البلاد، من رؤية العبادة السماوية وقد غدت موضع الإهمال وعدم الاكتراث» (مكيافيلي، 1982: 265).
وها هنا تتطابق الرؤية المكيافللية مع التصور الخلدوني لدور الدين في إرساء نُظم الحُكم، حيث لن يكون في عُرفهما الدين عائقا أمام وحدة الأمم وضامنا لقوتها، ما دام الدين تحت سيطرة السلطة، تخدمه ظاهراً لكي يخدمها باطناً. فاهتمام ابن خلدون بدور الدعوة الدينية في تعضيد المُلك وتقوية دولته، لا يبدو أنه من مُنطلق ديني شرعي فحسب، بل هو من وحي التجربة والمُمارسة، وآيُ ذلك أن صاحب المقدمة لا يَعتدّ بنوع معيّن من الحكم، بل فقط بمضمونه المستنِد على دعوة دينية قادرة على جلب المصالح ودرء المفاسد لـ «المُلك وللرعية». فهو وعلى الرغم من تحديده منصب الخليفة على أنه «نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا، به تُسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإماماً» (ابن خلدون، 2004: 366)، إلا أنه لا يَعتبِر ذلك من الأصول الدينية ولا من مَنصُوصاتها، وفي هذا يأتي ردُّه على من يدّعي النّص على الإمامة بأن ذلك محض شبهة؛ فــ «الإمامة في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الدين كما يزعمون وليس كذلك، وإنما هي من المصالح العامة المُفوّضَة إلى نظر الخلق ولو كانت من أركان الدين لكان شأنها شأن الصلاة» (ابن خلدون، 2004: 393)[3]. هي إذاً، المصالح وتقديرات الخَلق مَن تُؤسِّس للدولة وتُشرعن لأنواع الحكم، وهي نفسها «المبادئ» التي ينطلق منها مكيافيلي في دعوته الأمير إلى رعاية «الشؤون الدينية». إذ يتوجّب على حُكّام أي جمهورية أو مملكة، أن «يحافظوا على المبادئ الأساسية للديانة التي تصون وجودهم، وإذا ما عَمِلوا هذا، سَهُل عليهم أن يصونوا تَديّن دولتهم، مما يؤدي إلى الحفاظ عليها متحدة طيبة» (ابن خلدون، 2004: 266). ولم يكتفِ مكيافيلي بهذه الدعوة، بل نَصح الحكّام بأن يؤيّدوا كل ما يُسهِم في تحقيق هذه الغاية، حتى ولو كانوا غير مقتنعين بصحة غايتهم هذه.
وحسب الكاتب فإن الحُجج نفسها التي يستند إليها مكيافيلي في دفاعه عن إيجاد دين خادم للدولة، يُعبّر عنها ابن خلدون لكن بأسلوب مغاير، وبمنهج ينطلق من الواقع العربي في ارتباطه بالتاريخ، وبتأثرٍ كبير من تآليف ما يُطلق عليها الآداب السلطانية. فإذا كانت الأخيرة قد قدّمت لتوضيح تصوّراتها حُجَجاً مختلفة شرعية تارة وعقلية تارة أخرى، فإن ابن خلدون يُمعِن في الاهتمام بعنصر «العمران» والاجتماع والاقتصاد في تكوين الكيانات السياسية. فلأن الدولة عند ابن خلدون لا تنفصل عن المُلك أو السلطان (وهذا ما سيتمّ التفصيل فيه في الفقرة المخصصة للدولة)، فهي وثيقة الصلة بالشوكة والعصبية من جهة، والمال والعتاد، وإن كان شديد الإلحاح على أن العصبية لا تكفي وحدها لتبرير قيام هذه الدولة على الصعيد الأخلاقي، وذلك لأن «المُلك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية، واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه» (ابن خلدون، 2004: 313). ولأن العصبية بما هي فكرة مجردة قد تكون النقيض لمفهوم الخير العام المستمَدّ من الشريعة المُنزَّلة، فإن ابن خلدون يرى أنه: «لا إمكانية لنشوء الدول المستقِرة ما لم يَتضافر الخير العام والشريعة مع العصبية بشكل من الأشكال» (حوراني، 1968: 36، بتوسط من: هادي، 2008: 91). وينطلق ابن خلدون في تأكيده العوامل الدينية في نشوء الدول، من نظرته إلى أهمية العلاقة بين الدين والعصبية ونتائجها؛ فهذه العلاقة بنظره هي علاقة تآزر وتعاضد وتكامل، ما دام «الدين يزيد من قوة العصبية بالتخفيف من مظاهر التعصب، والعصبية من جهتها تمنح الدعوة الدينية قوة وفعالية» (الجابري، 1971: 288). وهنا يَحدُث نوع من التماهي بين تصورَي المطارحات والمقدمة، فالدولة الخلدونية تحتاج إلى الدعوة الدينية التي «تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها»، وسبب ذلك في نظر ابن خلدون عائدٌ إلى كون «الصّبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية (…) وأن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة كما قلناه (…) بمضاعفة الدين لقوتها ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوةً (…) فلما تخلّوا من تلك الصبغة الدينية (…) انتزعوه (الملك) منهم والله غالب على أمره» (ابن خلدون، 2004، ج 1، ص 314 – 315).
قد يبدو أن ابن خلدون يلحّ على دور الشريعة في تربية النفوس، وحَفْزها على قبول التحضّر، والمشاركة في العُمران ونبذ العنف، بينما لا يلجأ مكيافيلي إلى الدين إلا بهدف نفعي بصرف النظر عن أي دور تربوي يمكن أن يؤديه الدين. لكن هذا الاختلاف سيتبدّد إذا ما علمنا أن صاحب الأمير قام بمجموعة من «المراجعات» عند كتابته المطارحات، فهو لم يعد ينظر إلى التعليم الديني على أساس السلبية، أو بالأحرى، إن لومه للكنسية في هذه المسألة كان من مُنطلق أنها لم تُعلّم الناس الدين الصحيح، ولذلك يدعو إلى تعليم ديني ملائم وعلى قدر من الحيوية، حيث يجب أن يكون من النوع الصحيح. وقد رأى أن المسيحية لم تكن على المسار الصحيح، بعكس ما كان عليه الرومان، فقد حدّد دينهم الخير الأعلى للإنسان… مع الشهامة والقوة البدنية وكل شيء آخر يساعد على جعل البشر شجعاناً (هيتر، 2007: 90).
ويختتم الكاتب دراسته بقوله "إن الاتفاق الحاصل بين مكيافيلي وابن خلدون حول دور الدين في خدمة الدولة، والإسهام في توحيد الأمة وبقائها، واكبه اختلاف حول مآلات العلاقة بين الدين والسياسة. فلئن كان ابن خلدون هو الذي «جرّد القول في مسألة «انقلاب الخلافة الى ملك»، مستنداً في تحليلاته إلى نظريته في العصبية، وهو أيضاً الذي «بلور» الصيغة الفكرية التاريخية النهائية لمعاني الخلافة والإمامة والملك، معزّزاً نظرية «التطور» المبكّرة التي روّج لها أصحاب الحديث والسنّة، إذ حدّثوا كثيراً في حكم النبوة الذي ينتقل إلى حكم الخلافة، وفي حكم الخلافة الذي يتحوّل إلى الملك وفقاً لنظرة في تحول العصور والأزمنة وصيرورتها الثابتة من الخير إلى الشر» (جدعان، 1989: 378). فإن مكيافيلي قد أسهم في صياغة وِجهة نظر دُنيوية حديثة شاملة، يمكن من خلالها تقويم الحياة الإنسانية. ولا سيَّما أنه أعاد الاعتبار إلى الحقل السياسي المستقل؛ لأنه أمِل منه أن يقوم بتنظيم المجتمع المدني ويُجنّب إيطاليا سقوطاً آخر من دون أن يعني ذلك أن مكيافيلي استطاع التنظير لفضاءٍ علمانيّ كامل الأسس ما دام تشديده على أهمية السلطة السياسية، كان رهين مقولات متحدِّرة من الماضي، وفي هذا يَحدث توافق بين الطرحين الخلدوني والمكيافللي. فالدعوة الدينية، بالنسبة إلى صاحب المقدمة، تُساعد على تنقية العصبية من شرورها ومثالبها، وتُسهِم في خلق اللّحمة الضرورية للاجتماع البشري، وبالدين تَصفى النفس، وتَنصلِح أحوال الناس. أما عند مكيافيلي، فإن الدين أصبح عنصر قوة الدولة والأمير معاً في المطارحات، بعد أن كان سبب الفشل والانحطاط في كتاب الأمير. وهذا عائدٌ إلى المهامّ التي يمكن للدين أن يُؤدّيها؛ فإذا كان الدين في يد الكنيسة التي تمارِس من خلاله مهامّ زمنية، وتجعل منه سيفاً يسلَّط على المواطنين ويحرمهم من تقرير مصيرهم السياسي فهو منبوذ تنبغي مجابهته، أما إذا أسهم الدين في خدمة الدولة، وساعد على تقبّل فكرة القانون، فهو دين ينبغي رعايته وإحاطته بالعناية اللازمة حسب ما يذهب إليه مكيافيلي".
بيد أنه إذا كان مكيافيلي قد دشّن إلى جانب فلاسفة وعلماء آخرين عصر النهضة الأوروبية، بأن أسهمت أفكاره في تحرير الفضاء العلماني من سطوة رجال الدين، وانفكاك الدين من قبضة رجال السياسة، فإن محاولة ابن خلدون الرّامية إلى تنبيه أمته من الخطر الذي يحيط بها، بأن نبهّها إلى الأسباب التي تجعل من الأمة قريبة من الانحطاط إذا لم تستوعب التحولات الكثيرة التي يعرفها العمران والإنسان، ولا سيَّما في ما يتعلق بتطوير المنظومة الدينية وجعلها مواكبة للتحولات، قد شكّلت آخر صيحات العقل العربي الاستنهاضية لكي تتلوها حالة من الركود الطويل، تم خلالها تهميش العمل العقلي، ونُودي بوقف الاجتهاد وكأن على التاريخ أن يتوقف بموت المجتهدين الأوائل. هكذا، وبينما استفادت أوروبا من الاصلاح الديني والفلسفة السياسية اللتين كان مكيافيلي من أهم المساهمين فيهما، فإن دعوة ابن خلدون لم تكن إلا تأريخاً لواقع الانحطاط الذي لاحت مؤشراته.
وتبقى إشارة لا بد من التطرّق إليها في سياق بحث كل من مكيافيلي وابن خلدون، من حيث إن هذه الدراسة ليست سوى بحث أولي يَستدعي أبحاثاً وقراءات أخرى، فإذا كان محسن مهدي قد كشف عن الوجه الأرسطاليسي للخلدونية، ورام العروي بحث الوجه المكيافللي لابن خلدون كما قال هو نفسه في مقدمة كتابه الذي سبقت الاشارة إليه، فإن محاولتنا البحث عن عناصر الالتقاء والافتراق بين المكيافللية والخلدونية في ما يتعلق بالمسألة الدينية السياسية، ما هي إلى محاولة لاكتشاف الرجلين بمعزل عن سياقاتهما الدينية والسياسية، الأمر الذي لن يكتمل إلا إذا تم تطوير هذا الموضوع إلى كتاب يضمّ بين دفّتيه تفاصيل أكثر عن الموضوع، وهو ما نسعى إلى القيام به في القادم من عمر.
مع الإشارة الضرورية إلى أن استعادة النقاش حول فكر هذين المفكرين ليس من باب الترف الفكري، أو الرياضة الذهنية، بل إن راهننا في مَسيس الحاجة إلى التفكير مع مكيافيلي وابن خلدون، من غير الحاجة إلى المفاضلة بينهما، بل بهدف مزج مضامين إنتاجهما العلمي، والاستفادة ممّا راما التنبيه إليه وما توخّيا التأسيس له؛ فصاحب الأمير كان لحظة فارقة في التأسيس للحداثة السياسية، والمساهمة في التنظير لبناء الدولة الحديثة، والترويج لمنظور مغاير لعلاقة الدين بالسياسة، ما ساعد على إخراج التفكير الإنساني من انغلاقاته وتموقعاتها الميتافيزيقية. بينما تكفّل صاحب المقدمة بنقل التفكير الإسلامي من الطوبى إلى الواقع، ومن التحليق في سماء غير الممكن إلى حدود الإمكان، ومن إنكار تأثير العمران في الاجتماع البشري إلى الاعتراف بمحدودية الفكر داخل الواقع.
إذاً إنها محاولة استرجاعية تهدف إبراز حجم الفرص الضائعة التي كان من شأن اغتنامها أن يجنّب الواقع العربي – الاسلامي المعاصر تلك العودات المتكررة لطوبى تأبى أن تُصبح واقعاً، ويفوّت انتهاز الفراغات الفكرية التي تحاول الأيديولوجات المنغلقة مَلأها والاستحواذ على بياضاتها. فالاعتقاد بأن المجال التداولي العربي – الاسلامي مختلف من المجال التداولي المسيحي – الغربي، والتمترس وراء الخصوصية الضيقة، وتسفيه المسعى إلى الكونية، كل ذلك ينكسر على صخرة التاريخ وثقل الواقع. وآيُ ذلك أن المجتمعات العربية – الإسلامية عبرت من نفس الجسر الذي داست عليه أقدام المجتمعات المسيحية – الغربية، وهذا ما تبرزه القراءة المتمعّنة لكل من مكيافيلي وابن خلدون، وتؤكده الدراسات المقارنة لباقي متون كبار المصلحين المنظرين المنتمين للمنظومتين الغربية والاسلامية، ومثاله ما وقفنا عليه خلال مقاربتنا لمتنَي إتيان دي لابويس وعبد الرحمن الكواكبي، حيث لُوحظ أن الطروحات التي تُوصّف بعض الشعوب بأنها خاضعة بحكم الفطرة والدين والمناخ، تتّسم بتهافت أسسها، وغياب الاتساق عن نتائجها، لأن التاريخ أثبت أن جميع الشعوب خضعت للاستعباد وتحكمت فيها القابلية للطغيان، وفي المقابل تم تسجيل أن كل الشعوب تملّكت القدرة على الانفكاك من قواعدها، ولا يدخل في ذلك أنها شرقية أو غربية أو أن الاستبداد خاصية شرقية أو أن التحرر خاصية غربية؛ بل الجليّ هو أن الثقافة السياسية قابلة للتطور في هذا الاتجاه أو ذاك بفعل عوامل التنشئة وتنمية القدرات الإدراكية وسيادة العلم، ومكافحة الخرافة والجهل. والاستنتاج نفسه يمكن أن نخرج به من مساءلة الدين والدولة لدى كل من مكيافيلي وابن خلدون، إذ الدين عند هذين المفكرين قد يكون عنصر قوة تستند إليه الأمة وقد يكون عنصر هدم وتدمير يبطل كل تأسيسات العقل.