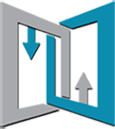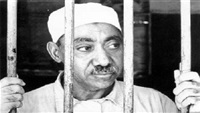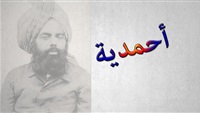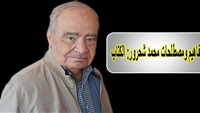من فلسطين إلى المناخ: تشتت الأجندة في الخطاب الإفتائي
الخميس 14/أغسطس/2025 - 05:13 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
يأتي البيان الختامي لمؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، كوثيقة تحمل طموحًا كبيرًا في إبراز الدور الديني والفكري للمؤسسة الإفتائية في قضايا العصر، من السياسة والبيئة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ورغم الزخم الخطابي الذي يطبع بنوده، فإن هذا الحضور القوي على مستوى الشعارات والرؤى لا يقابله وضوح مماثل في آليات التنفيذ، ما يجعل كثيرًا من التوصيات أقرب إلى إعلان النوايا منها إلى خطط عمل قابلة للقياس والمتابعة. ويبدو أن الهدف الأبرز للنص هو تعزيز الصورة الرمزية للمؤسسة بوصفها المرجعية الشرعية الأولى، في مواجهة التحديات الرقمية وتشتت الخطاب الديني المعاصر.
لكن التحليل يكشف أيضًا عن فجوة بين اتساع الأجندة المطروحة في البيان وبين قدرة المؤسسة على ملاحقتها بمواردها الحالية، فضلًا عن هيمنة الطابع الحراسي في الطرح على حساب المبادرة الإبداعية. فالتنوع المفرط في القضايا، من مركزية القضية الفلسطينية إلى حماية البيئة، يضفي شمولية شكلية لكنه قد يؤدي إلى تشتت الجهود. وإزاء ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام دار الإفتاء هو تحويل هذا الزخم الخطابي إلى برامج محددة بأهداف زمنية ومؤشرات أداء، بما يحافظ على قوة الرمزية ويعزز المردود العملي.
الطابع الخطابي أكثر من العملي
البيان الصادر عن المؤتمر يحمل طابعًا خطابيًا قويًا، إذ اعتمد على لغة حماسية ومؤثرة تهدف إلى إثارة الالتزام والوعي الديني لدى المستمعين والمتابعين. ومع ذلك، فإن هذا الطابع الحماسي لم يُصاحبه توضيح لكيفية تنفيذ التوصيات المطروحة على أرض الواقع. فالتكرار المستمر لمفردات مثل "تشجيع البحث العلمي" و"إطلاق برامج توعية" و"تعزيز التعاون" يعطي انطباعًا عامًّا بالإيجابية، لكنه لا يقدم خارطة طريق واضحة لتطبيق هذه التوصيات.
غياب التفاصيل التنفيذية يعني أن البيان يظل في إطار إعلان النوايا لا أكثر، حيث لا يذكر المؤشرات الزمنية التي يجب تحقيق الأهداف خلالها، ولا يحدد الجهات المسؤولة عن متابعة كل توصية. فعلى سبيل المثال، عند الدعوة لتطوير برامج بحثية أو دمج الذكاء الاصطناعي في الفتوى، لم يتم توضيح أي معايير للنجاح، أو موارد مادية وبشرية مطلوبة، أو خطط تدريبية للمفتين والمؤسسات العلمية.
كما أن البيان يفتقر إلى تحديد الشركاء المحتملين أو الآليات التي ستُستخدم لتفعيل هذه التوصيات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فعبارات مثل "تعميق التعاون مع المراكز البحثية والمنظمات الدولية" أو "إطلاق برامج توعية للجمهور" تبقى غامضة دون وجود خطة محددة لتنسيق الجهود أو قياس النتائج. هذا الغموض قد يضعف مصداقية التوصيات ويجعل تنفيذها أكثر صعوبة، خاصة في بيئة متعددة الأطراف كالمؤسسات الدينية والعلمية.
باختصار، يمكن القول إن البيان يُبرز القوة الرمزية للمؤتمر والمؤسسة الإفتائية، لكنه يعاني من فجوة بين الطموح والخطة العملية. الطابع الخطابي يخلق صورة مثالية للمؤسسة باعتبارها صانعة للقرار والرؤية، لكنه يترك التنفيذ على مستوى المبادرات والبرامج مفتوحًا للتأويل، مما قد يحد من فعالية التوصيات ويحولها إلى شعارات تتداول إعلاميًا أكثر من كونها أدوات قابلة للتطبيق والقياس.
تنوع المحاور إلى حد التشتت
يلاحظ في البيان أن قائمة التوصيات تتنقل بين موضوعات شديدة التباين، تبدأ من القضايا السياسية الكبرى مثل القضية الفلسطينية، مرورًا بقضايا الوحدة الإسلامية والعمل المشترك، ثم تنتقل إلى ملفات الفتوى الرقمية والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى قضايا البيئة والتغير المناخي. هذا التنوع الواسع في جدول الأولويات يعكس رغبة في شمولية الطرح وتقديم صورة للمؤسسة على أنها حاضرة في جميع القضايا التي تشغل الرأي العام الديني والعالمي.
ورغم أن هذا التنوع يمنح الانطباع بأن المؤسسة الإفتائية منفتحة على مختلف قضايا العصر، إلا أن غياب التخصيص والتركيز قد يؤدي إلى تشتت الجهود وفقدان الفعالية. فالمؤسسات، مهما كانت قوتها، تظل محدودة الموارد من حيث الخبرات البشرية، والقدرات المالية، وأدوات التنفيذ، ما يجعل متابعة جميع هذه الملفات بجدية متساوية أمرًا شبه مستحيل. وهذا التشتت قد يضعف أثر التوصيات على أرض الواقع، إذ تنقسم الموارد والطاقات على ملفات متعددة دون تحقيق اختراق حقيقي في أي منها.
إضافة إلى ذلك، فإن إدراج قضايا بعيدة نسبيًا عن المجال الإفتائي التقليدي، مثل التغير المناخي، يثير تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسة على الانتقال من المستوى الخطابي إلى المشاركة الفعلية في هذه الملفات. صحيح أن للخطاب الديني دورًا في إضفاء بعد أخلاقي على قضايا البيئة، لكن دون وجود شراكات وخبرات متخصصة، قد يبقى هذا الدور محصورًا في إطار التصريحات العامة، مما يفقده التأثير العملي.
هذا النمط من إدراج قضايا متنوعة في بيان واحد، رغم وجاهته في إظهار انفتاح المؤسسة على اتجاهات متعددة، قد يعطي أيضًا انطباعًا بـ"تكديس البنود" في محاولة لإرضاء مختلف الأطراف والجماهير. النتيجة أن البيان يبدو كوثيقة شاملة شكليًا، لكنه يفتقر إلى البنية الاستراتيجية التي تربط بين هذه القضايا، وتوضح أيها يمثل أولوية قصوى، وأيها يتطلب دعمًا رمزيًا فقط. وهنا يبرز التحدي الأكبر: صياغة رؤية متكاملة تحدد الأولويات بدلًا من الجمع الكمي للقضايا.
هيمنة البُعد الحِراسي (Protective)
تغلب على التوصيات الواردة في البيان لغة ذات طابع حِراسي أو وقائي، إذ يظهر بوضوح أن الهدف المركزي لكثير من البنود هو حماية المجتمع من الأخطار المحتملة أو القائمة. فنجد تركيزًا على حماية الشرع من الفتاوى غير المنضبطة، وحماية الأفراد من المحتوى الرقمي المتطرف، وصون الخصوصية في البيئة الرقمية، وحتى حماية البيئة من مخاطر التغير المناخي. هذا التوجه يعكس رؤية ترى المؤسسة الإفتائية في موقع الحارس الأمين على القيم والمجتمع، في مواجهة التحديات التي قد تهدد استقراره الفكري أو الأخلاقي أو البيئي.
من الناحية الإيجابية، هذه الرؤية الوقائية تدل على وعي واضح بمخاطر المرحلة، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، سواء على صعيد التكنولوجيا أو الخطاب الديني أو الأمن المجتمعي. فهي تؤكد إحساس المؤسسة بالمسؤولية، وحرصها على حماية النسيج الاجتماعي من التفكك، والحفاظ على المرجعيات الدينية الموثوقة، ومنع الانزلاق نحو خطاب الكراهية أو التطرف أو الفوضى الفقهية.
لكن على الجانب الآخر، يظل هذا الخطاب محصورًا في الإطار الدفاعي، بحيث ينصب الاهتمام على سد الثغرات ومواجهة المخاطر أكثر من الانطلاق نحو مشاريع إبداعية أو اجتهادات جريئة. غياب هذا البعد الابتكاري قد يؤدي إلى تجميد الحركة في منطقة رد الفعل، بدلًا من الانتقال إلى المبادرة وصناعة مسارات جديدة للتجديد الديني أو تطوير أدوات الإفتاء بما يتجاوز مجرد الحماية.
إن الاقتصار على الطابع الحراسي، رغم ضرورته في أوقات الأزمات، قد يُفقد المؤسسة القدرة على التأثير الإيجابي طويل المدى، لأن ضبط المخاطر وحده لا يكفي لضمان التقدم أو مواكبة المستجدات. فالمطلوب هو الجمع بين التحصين والتطوير، بحيث تصبح الحماية إطارًا داعمًا لابتكار حلول وأدوات جديدة، لا جدارًا يحيط بالمؤسسة ويحصرها في دور المراقب والمتصدي دون أن تكون فاعلًا رئيسيًا في تشكيل المستقبل.
الموقف من الذكاء الاصطناعي
يُظهر البيان موقفًا إيجابيًا من حيث المبدأ تجاه الذكاء الاصطناعي، فهو لا يتبنى موقفًا تقليديًا رافضًا للتقنية، بل ينظر إليها كأداة يمكن تسخيرها لخدمة الفتوى المعتبرة وضمان وصولها إلى الجمهور بصورة أكثر دقة وسرعة. كما يؤكد على ضرورة وضع أطر أخلاقية مستمدة من التصور الإسلامي، تتضمن قيم الأمانة والصدق ومراقبة الله، مما يعكس رغبة في تكييف التكنولوجيا الحديثة مع منظومة القيم الدينية بدلًا من الوقوف في مواجهة صدامية معها.
مع ذلك، فإن البيان يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بقدر من التبسيط، إذ لا يتطرق إلى الإشكالات التقنية العميقة التي ترافق هذه التكنولوجيا. فمثلاً، لم يتناول البيان مسألة تحيز الخوارزميات الذي قد يؤدي إلى إنتاج نتائج أو توصيات غير محايدة، ولا أشار إلى التحديات القانونية المرتبطة بـالملكية الفكرية، أو مدى إمكانية حماية البيانات والخصوصية في بيئة رقمية مفتوحة. هذه القضايا تمثل جزءًا جوهريًا من النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي، لكنها غابت عن التوصيات.
كما أن هناك فجوة واضحة بين الطموح المعلن والقدرة الفعلية للمؤسسات الإفتائية على إنتاج تقنيات منافسة للمنصات العالمية الكبرى. فالدعوة إلى تطوير برمجيات إفتائية أو تطبيقات ذكية لا تواكبها إشارة إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، أو البنية التحتية التقنية، أو الشراكات مع شركات التكنولوجيا التي يمكن أن تجعل هذه الرؤية قابلة للتحقيق. بدون هذه المقومات، قد تبقى المبادرات في حدود النوايا الحسنة أو التجارب المحدودة النطاق.
يمكن القول إن البيان يعوّل بدرجة كبيرة على البعد القيمي والنوايا الطيبة لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، أكثر مما يعوّل على التخطيط التقني الواقعي القادر على منافسة أدوات التكنولوجيا العالمية. وهذا يجعل التوصيات تبدو مثالية من الناحية الأخلاقية، لكنها غير مكتملة من حيث الجوانب العملية والتنفيذية. ولتحقيق التوازن، سيكون من الضروري أن تترافق الأطر الأخلاقية مع خطط تنفيذية دقيقة، تتضمن تدريب الكوادر، وتوفير التمويل، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع التقني المتقدم.
الجانب السياسي والفلسطيني
إدراج "مركزية القضية الفلسطينية" كبند أول في البيان الختامي يمنحها وزنًا رمزيًا بارزًا، ويؤكد حضورها كقضية محورية في الوعي العربي والإسلامي. هذا الترتيب يعكس البعد العروبي-الإسلامي للمؤتمر، ويضع المؤسسة الإفتائية في موقع الملتزم أخلاقيًا ودينيًا وسياسيًا بنصرة الشعب الفلسطيني، ويعيد التذكير بأن هذه القضية لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل قضية الأمة جمعاء.
مع ذلك، فإن الخطاب المستخدم ظل أسير الصياغات التقليدية التي تركز على الدعم الإنساني والسياسي العام، والدعوة لتكثيف الجهود الدولية والإغاثية، من دون تقديم رؤية عملية جديدة تتجاوز هذا الإطار المعتاد. فلم يتطرق البيان إلى أدوات مبتكرة يمكن للمؤسسة الدينية تبنيها أو تفعيلها في دعم القضية، مثل المبادرات الرقمية للتوعية، أو حملات الإفتاء الموجهة ضد الممارسات المنافية للقوانين الدولية، أو توظيف الشبكات العالمية للمؤسسات الإفتائية في التأثير على الرأي العام العالمي.
كما أن البند المتعلق بفلسطين جاء منفصلًا عن بقية القضايا التي طرحها البيان، ولم يُدمج في سياق أشمل يربط بين النضال الفلسطيني والتحولات التقنية أو القضايا البيئية أو الجهود الفكرية التي نوقشت لاحقًا. هذا الفصل السياقي جعل القضية الفلسطينية تظهر كملف قائم بذاته، بدلًا من أن تكون محورًا يمكن من خلاله بناء روابط موضوعية مع القضايا الأخرى، كاستخدام التكنولوجيا لتعزيز الوعي العالمي، أو الاستفادة من الخطاب البيئي في إدانة الممارسات المدمرة للأراضي الفلسطينية.
إن إبقاء القضية الفلسطينية في إطارها التقليدي، دون تطوير أدوات أو ربطها بمنظومة القضايا العالمية التي يتناولها البيان، قد يقلل من فرص توسيع قاعدة التضامن الدولي أو دمجها في أجندات أوسع. فالقوة الحقيقية للبند كانت ستتضاعف لو قُدِّم ضمن استراتيجية شاملة تجعل من فلسطين محورًا للتلاقي بين البعد الديني والإنساني والتقني، بما يمنح القضية زخمًا أكبر في المحافل العالمية.
المناخ وإدماج القضايا العالمية
إدراج قضية المناخ في البيان الختامي للمؤتمر يعد خطوة ذكية من الناحية الرمزية والسياسية، إذ ينسجم مع الأجندة العالمية للمنظمات الدولية ويعكس انفتاح المؤسسات الإفتائية على قضايا كونية تتجاوز الشأن الديني البحت. هذا التوجه يمكن أن يسهم في تحسين صورة المؤسسة الإفتائية عالميًا، وإبراز البعد الأخلاقي للإسلام في حماية البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي.
مع ذلك، يظل هذا البند في صورته الحالية أقرب إلى إعلان النوايا منه إلى خطة عمل متكاملة، إذ يفتقر إلى تحديد آليات واضحة يمكن من خلالها للمؤسسات الإفتائية أن تتحول من موقع المؤيد الخطابي إلى الفاعل الميداني. فالمناخ قضية معقدة، تتطلب معرفة علمية متخصصة، وخبرات تقنية، وشبكات تعاون مع جهات بيئية محلية ودولية، وهي عناصر لا تبدو حاضرة بشكل كافٍ في البنية الحالية للمؤسسات الإفتائية.
إن إدخال قضية المناخ ضمن جدول أعمال الإفتاء لن يكون مثمرًا إلا إذا ارتبط ببرامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئات الإفتائية، تُمكّنهم من فهم التحديات البيئية بلغة علمية، وتحويل المبادئ الشرعية المتعلقة بحماية الأرض إلى سياسات عملية قابلة للتنفيذ. كذلك، فإن إقامة شراكات مع خبراء البيئة والمراكز البحثية سيكون أمرًا حاسمًا لضمان أن تكون الفتاوى البيئية دقيقة ومبنية على معطيات علمية موثوقة.
في غياب هذا الربط بين الخطاب البيئي والقدرة المؤسسية على الفعل، قد يظل إدراج المناخ في البيان مجرد لفتة إيجابية بلا أثر ملموس، أو بندًا معزولًا عن بقية التوصيات. أما إذا جرى تطويره ضمن إطار مؤسسي متكامل، فسيكون بإمكان المؤسسات الإفتائية أن تقدم مساهمة فريدة، تجمع بين الشرعية الدينية والوعي العلمي، وتفتح آفاق تعاون جديدة مع المنظمات البيئية الدولية.
إشكالية قابلية القياس
إحدى الإشكاليات الجوهرية في البيان هي غياب مؤشرات أداء واضحة (KPIs) أو أهداف كمية يمكن قياسها، وهو ما يجعل عملية تقييم التوصيات لاحقًا شبه مستحيلة. فالتوصيات صيغت في شكل أهداف عامة مثل "تعزيز التعاون" أو "إطلاق برامج توعية" دون تحديد حجم هذا التعاون، أو عدد البرامج المستهدفة، أو المدة الزمنية اللازمة لتحقيقها.
غياب الإطار الزمني يزيد من هشاشة الالتزامات الواردة في البيان، إذ يمكن تأجيل التنفيذ إلى أجل غير مسمى دون اعتبار ذلك إخلالًا بالوعود. فالتجارب المؤسسية الناجحة عالميًا تؤكد أن تحديد جداول زمنية واقعية ومعلنة هو شرط أساسي لتحويل التوصيات من نصوص خطابية إلى خطط عمل فعلية.
كما أن عدم وجود آليات متابعة أو تقارير دورية لمراجعة ما تم إنجازه يفتح الباب أمام بقاء هذه البنود في دائرة "الخطاب الرسمي" دون أي أثر عملي على الأرض. حتى لو كانت النوايا صادقة، فإن غياب أدوات القياس يعني أن أي تقدم أو إخفاق لن يكون موثقًا أو محل تقييم موضوعي.
لو أراد المؤتمر تعزيز مصداقيته، لكان من الأفضل إرفاق البيان بملحق يحدد لكل توصية مؤشرات أداء، ونقاط تحقق (milestones)، وآلية للمراجعة السنوية أو نصف السنوية. بذلك يمكن تحويل البيان من مجرد إعلان نوايا إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يسمح للمجتمع المحلي والدولي بمساءلة الجهات المعنية عن التزامها.
البعد الرمزي للمؤسسة الإفتائية
البيان يولي اهتمامًا متكررًا لتأكيد أن المؤسسات الإفتائية الرسمية تمثل المرجعية الشرعية الوحيدة المعتمدة في الشأن الديني، خصوصًا في إصدار الفتاوى. هذا التأكيد المتكرر لا يبدو عابرًا، بل يعكس إدراكًا واضحًا للتحديات التي تواجه هذه المؤسسات في عصر التدفق الرقمي للمعلومات، حيث أصبح المحتوى الديني متاحًا للجميع دون ضوابط أو مراجعة مؤسسية.
هذا التركيز يعكس كذلك صراعًا ضمنيًا على الشرعية الدينية بين النموذج التقليدي القائم على المؤسسات الرسمية ذات الهرمية والانضباط، وبين الفضاء الرقمي اللامركزي الذي يتيح لأي فرد أو مجموعة نشر الفتاوى والمضامين الدينية بسهولة وبلا حواجز. في هذا السياق، يبدو أن البيان يحاول إعادة ترسيم حدود السلطة الدينية لصالح المؤسسات القائمة.
الصراع على المرجعية ليس أمرًا جديدًا، لكنه اكتسب زخمًا غير مسبوق خلال العقدين الأخيرين بفعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو والبودكاست، التي سمحت بظهور مؤثرين دينيين مستقلين يتجاوز تأثيرهم في بعض الأحيان حدود تأثير المؤسسات الرسمية. البيان، إذًا، هو محاولة للرد على هذا التحدي عبر تثبيت سلطة المؤسسة التقليدية في الوعي العام.
مع ذلك، يظل نجاح هذا التوجه مرهونًا بقدرة المؤسسات الإفتائية على مواكبة الأدوات الرقمية ذاتها التي تنافسها، وتقديم محتوى ديني موثوق وجاذب في نفس الوقت. فالتأكيد الخطابي على المرجعية وحده لا يكفي إذا لم يُدعَم بآليات حضور قوية على المنصات الرقمية، وتطوير قنوات تفاعلية تحافظ على الصلة المباشرة مع الجمهور.
الخلاصة
البيان يحاول أن يظهر المؤسسة الإفتائية كجهة عصرية، منفتحة، جامعة بين الأصالة والمعاصرة، قادرة على خوض معارك الهوية، وحماية المجتمع، والمشاركة في القضايا العالمية.
لكن على المستوى العملي، لا تزال هناك فجوة بين الخطاب الشامل والقدرة المؤسسية الفعلية، خاصة في ملفات التكنولوجيا المتقدمة والمناخ.
القوة الكبرى للنص تكمن في شرعنة التفاعل مع القضايا الحديثة، أما نقطة ضعفه فهي غياب الخطة التنفيذية القابلة للقياس.