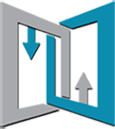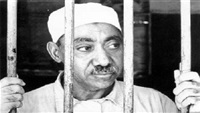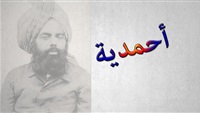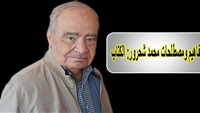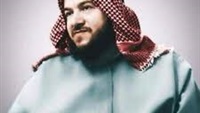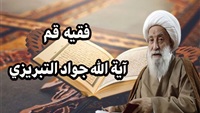من الإعلام إلى الميدان.. داعش وإعادة هندسة وعي المتلقي
الأحد 28/سبتمبر/2025 - 01:14 م
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
في عددها الأخير (514) الصادر يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، قدّمت صحيفة النبأ، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش، نصًا افتتاحيًا يسعى إلى تأطير المشهد الدولي الراهن ضمن رؤية جهادية صلبة. القراءة التي تقترحها الصحيفة تتجاوز مجرد التعليق على الأحداث السياسية، إذ تربط بين القمم الدبلوماسية والتحالفات الدولية والنقاشات حول فلسطين والتطبيع، لتعرضها جميعًا كأدلة قاطعة على ما تصفه بـ«المؤامرة اليهودية-الصليبية» ضد الإسلام. هذا الخطاب لا يكتفي بوصف الوقائع، بل يعمل على إعادة صياغتها داخل ثنائية صارمة: التمسك بالتوحيد ورفض الطواغيت من جهة، والخيانة والموالاة من جهة أخرى.
ما يميز هذه الافتتاحية ليس فقط مضمونها العقدي أو لغتها التعبوية، بل توقيتها وسياقها السياسي. فالعدد يأتي في ذروة حراك دبلوماسي إقليمي ودولي، حيث تحاول أطراف متعددة إعادة رسم خرائط النفوذ والتحالفات. في هذا المناخ المشحون، يسعى تنظيم داعش إلى إعادة التموضع عبر نص يعرض نفسه باعتباره البوصلة الحقيقية لفهم الأحداث، في محاولة لتعويض ضعفه الميداني بقوة رمزية وخطابية. وهكذا تتحول الافتتاحية إلى ما يشبه منصة دعائية إستراتيجية، تستثمر حالة الارتباك العام لتوجيه جمهورها نحو مشروع ديني-سياسي مغلق.
السياق الزمني والسياسي للصدور
الساحة الدولية التي صدرت فيها الافتتاحية لم تكن فراغًا بل مسرحٌ دبلوماسي محتدم: قمم ومؤتمرات تتعاقب، تحالفات إقليمية ودولية تعيد رسم أولوياتها، ونقاش متصاعد حول ملفي فلسطين وإقامة علاقات بعض الدول مع إسرائيل. في هذا المناخ، لم تعد الأحداث الرسمية مجرد أخبار تُنقل؛ بل تحوّلت إلى مؤشرات تُقرأ وتُفسَّر على نحو يغيّر من ثقلها السياسي. ومن هنا يظهر معنى توقيت صدور الافتتاحية: نصّ يصدر داخل موجة دبلوماسية عالية الشدة ليستهدف القلب العاطفي والسياسي لجمهوره.
الافتتاحية لا تقف عند مستوى التعليق على حدث أو إدانة سياسية؛ بل تُعيد تركيب الوقائع داخل سردية واحدة ثابتة، تصف كل خطوة دبلوماسية بأنها خيط في مؤامرة «كونية» ضد المسلمين. هذا التأطير يقوم على اختزال التعقيدات السياسية إلى ثنائية قاطعة — نحن في مواجهة «الطاغوت» والعدو — ما يجعل من كل حدث دولي دليلًا على خيانةٍ أو تآمرٍ، بدلاً من أن يكون مناسبةً للحوار أو النقاش السياسي. بهذا الأسلوب، تتحول التفاصيل إلى رموز، والرموز إلى دوافع للفعل.
وظيفة الافتتاحية إذن تتجاوز التعبئة اللحظية؛ فهي عملية تحويل ممنهجة للغضب والارتباك السياسي إلى مشروع سياسي-ديني محدّد: تُحوّل الغضب الشعبي من موقع انفعالي مبعثر إلى مسار تنظيمي واضح يُشرعن العنف ويرسّخ الهوية الجماعية المضادة. بهذا المعنى تصبح المادة الإعلامية أداةً استراتيجية، لا مجرد مادة نثرية، تستهدف إعادة توجيه البوصلة المعنوية لدى المتلقين وتمنحهم خارطة عمل أخلاقية وسياسية تبرر مقاطعة المؤسسات الرسمية وأحيانًا الدعوة للعنف كخيار «وحيد» مُشرّع.
لمعرفة أوسع عن نمط صدورها وتوزيعها وأرقامها الأسبوعية، يمكن العودة إلى أرشيف المنصات والمواقع التي تنشر نسخ «النبأ»؛ فمتابعة تكرار الرسائل الزمنية والمكانية تكشف عن إيقاع حملاتها الدعائية وكيف تُزامنها مع مواعيد الاجتماعات الدولية والحساسيات الإقليمية. قراءة هذا الأرشيف بنهج زمن-سياقي تمنح المحلّل قدرة أفضل على تمييز بين موقفٍ تكتيكي ومشروع طويل الأمد، وتُمكّنه من اقتراح استجابات إعلامية وسياسية مضادة تستهدف فكّ الاستقطاب وإعادة فتح قنوات الحوار المدني.
الرسائل الصريحة والرسائل المسكوت عنها
الصريح في الافتتاحية واضح ومباشر: دعوة صارخة للتمسّك بالتوحيد ونداء لكفر «الطواغيت» ورفض كل مسار دبلوماسي أو أي محاولة للمصالحة تُسقَط في فئة «التطبيع» الخائن. النص يضع معيارًا ثنائياً لا يقبل الوساطة — إما التوحيد المطلق والانخراط في مشروعه، أو الخيانة والموالاة للطواغيت—، وبذلك يحرم أي وسيلة تفاوضية أو سياسية شرعيةً أخلاقية في نظر جمهوره المستهدف.
أما ما لم يُقل فهو أكثر خطورة لأن صمته مقصود ويخدم أهدافًا استراتيجية: تحويل أزمة سياسية-قومية — كالملف الفلسطيني — إلى صراع وجودي وإيديولوجي مطلق. بهذا النقل النوعي من بعد سياسي إلى أفق ميتافيزيقي، يُشرعن النص العنف باعتباره الخيار الوحيد المقبول عقائدياً، ويغدو الجدل السياسي العادي ترفًا لا قيمة له أمام «ثنائية الحق والباطل» التي يرسخها الخطاب.
الافتتاحية أيضًا تعمل على تجريد الخصوم المحليين — من حكّام ومؤسسات وأحزاب — من أي شرعية دينية أو أخلاقية، وتبذل جهدًا لبناء أرضية فقهية وأخلاقية لتبرير مواجهة شاملة ضدهم. تحويل موقع الحكومة أو النخب السياسية من فاعلين سياسيين إلى «عناصر طاغوتية» يسهّل دعوات التكفير والعزل ويخفض الحواجز النفسية أمام العنف الموجَّه نحو مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.
أخيرًا، يستغل النص مشاعر التيه والارتباك لدى جمهور واسع: بدلاً من معالجة الأسباب المادية للحيرة — مثل الفقر والبطالة والهزائم السياسية — يقدم خطابًا هويّياً جامدًا يبرئ التنظيمات الجهادية من أي مسؤولية عن إخفاقاتها العملية أو العقلانية. هذا الصمت المتعمد عن الأسباب البنيوية يحوّل سؤال «ماذا نفعل؟» من نقاش عملي وسياسي إلى اختبار أخلاقي-عبادي وحيد: اقتصر على التوحيد وانتهت المسألة.
الأسلوب البلاغي والتقنيات الإقناعية
الافتتاحية تلجأ إلى أدوات بلاغية معروفة وذات فاعلية عالية في صناعة الانتماء والحشد: ثنائية قطعية تحول المسار السياسي إلى اختبار إيماني — إيمان/كفر، توحيد/طاغوت — مع استدعاء مُتكرر للآيات والأحاديث لتشييد هالة شرعية حول الموقف. هذا التزوير المعنوي يحول الاختيارات السياسية إلى محكّات عقدية لا تُقاس بموازين المصالح أو الحسابات السياسية، بل باعتبارات دينية مطلقة تُحرّم أي مناقشة أو تدرّج في المواقف.
كما تعتمد الافتتاحية على توظيف قوي لمشاعر الخوف والغضب؛ تصوير متواصل لـ«المؤامرة» يرفع من منسوب الطوارئ الدينية ويبرر قبول تدابير استثنائية أخلاقياً. لغة الخوف هنا لا تعمل بمعزل عن الخطاب العقدي، بل تتكامل معه: قدسية الموقف تُغلف الغضب، والغضب يُحوّل الخشية إلى طاقة دافعة للتضحية والانخراط العملي، ما يجعل القارئ أكثر تقبُّلاً لتبني مواقف متطرفة تبدو له «واجبًا» أكثر من كونها خيارًا سياسياً.
ثمة تقنية بلاغية محورية أخرى في النص وهي «تجريد العدو» ووصم كلِّ خصم داخلي بالتواطؤ مع اليهود والنصارى؛ أسلوب يلغِي الفروق السياسية والاجتماعية داخل المجتمع ويحوّل الخصومة إلى صراع وجودي. هذه التجريدات تُسهِم في شل أي حوار داخلي وتبني هوية جماعية تقوم على العداء الشامل، ما يفتح الباب أمام تبرير إجراءات قاسية ضد مؤسسات وحركات مدنية وحتى أفراد يُصنّفون تلقائياً كخصوم لا أهلية لهم للتمثيل أو الحوار.
من الناحية العلمية والاجتماعية، لا تزال هذه الصور والأنماط الدعائية فعّالة في إنتاج سرديات توحيد العدو واستقطاب قطاعات مهمّشة أو ثائرة. المواد الإعلامية التي تُجسّد الموت والرعب أو تقدّس الصراع تُساهم في تشكيل هويات عنيفة وتقلّل من قدرات المناقشة العقلانية للخيارات السياسية. لذلك فإن المواجهة الإعلامية والفكرية ينبغي أن تركز على كسر هذه ثوابت البلاغة الجهادية — تفكيك الثنائيات، فضح آليات التجريد، وإعادة ربط السخط الاجتماعي بأسبابه البنيوية لا بتأويلات دينية مطلقة.
الدلالات الاستراتيجية: لماذا هذه الافتتاحية الآن؟
الافتتاحية تصدر اليوم لأنّ التنظيم يسعى لتثبيت حضورٍ إعلامي مكثف يعوض عن الضغوط الميدانية والسياسية التي يتعرّض لها؛ هي محاولة لإعادة تفعيل رمزيته عبر نصٍّ مركزي يُعيد توزيع المعاني حول الوقائع الدولية، لا سيما القمم والتحالفات التي تشكل خلفية صدورها. بنشر هذا النوع من الافتتاحيات في توقيت دبلوماسي ضاغط، يبني التنظيم سردية مفادها أنّه صاحب البوصلة الأخلاقية والمرجعية الحقيقية للمسلمين، وأن كل ما عداها مجرد تمظهرات زائفة تُدار من قبل أعداءٍ خارجيين وداخليين.
ثانيًا، تعمل الافتتاحية على قلب الأجندة من فضاء السياسة إلى فضاء العقيدة: تحويل كل نقاش سياسي أو قرار دبلوماسي إلى اختبار إيماني يقضي على أصعدة التدرج والمفاوضة. بهذا التحويل تُحجم قدرة الجمهور على التفكير الاستراتيجي أو البحث عن حلول مدنية عملية، لأن أي خيار خارج «الخريطة العقدية» يصير تلقائيًا خيانةً أو ارتدادًا. النتيجة العملية هي تضييق هامش التفكير العام وتحويل النقاش العمومي إلى اختبار ولاء لا إلى حقل مصالح متنافسة يُعالج بالتفاوض.
ثالثًا، تستهدف الافتتاحية "حالة الحيرة" لدى فئات واسعة وتحوّلها إلى فرصة تعبئوية: بدل أن تقدم تفسيرات واقعية أو برامج عملية لمعالجة أسباب التيه—كالبطالة، الفشل السياسي، أو انعدام الثقة بالمؤسسات—تعرض هوية موحّدة وواجبًا دينيًا يلمّ شتات المتلقين ويحوّل اليأس إلى طاقة استجابة طائفية. هذه الآلية فعّالة جدًّا في تحويل انفعالات الشارع إلى إطار معنوي مبسّط يمدّ التنظيم بقدرة على استقطاب عناصر عاطفية وسياسية في آن واحد.
أخيرًا، من منظور المراقب الاستراتيجي، لم تعد إصدارات «النبأ» مجرد مواد دعائية عارضة، بل أدوات مدمجة في منظومة الحشد المعنوي والتوجيه العملياتي والتجنيدي: تُعدّ لخطابٍ موحد يُسهل توجيه الرسائل إلى خلايا ومساحات جغرافية متنوعة، وتُستخدم كمؤشر لزمنية العمليات وتوقيتها الفكري. لذلك فإن قراءة توقيت وتكرار هذه الافتتاحيات في الأرشيف الصحفي والتوثيقي لا تزال من أهم مفاتيح فهم إستراتيجيات التنظيم في ربط الخطاب بالعمل الميداني.
الأثر المحلي والإقليمي والدولي المحتمل
محليًا، تُسهم هذه الافتتاحية في تعميق الانقسام داخل المجتمعات التي يتواجد فيها تنظيم الدولة أو جماعات مماثلة: الخطاب لا يكتفي بتحويل الخلاف السياسي إلى صراع أخلاقي، بل يقدّم مبرّرات شرعية لتجند أفراد معزولين أو خلايا محلية ضد مؤسسات الدولة أو خصومهم الموصوفين بـ«الطواغيت». عمليًا، تنتقل هذه الدعوات بسرعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعض الخطب المسجديّة المواجهة، وقنوات تضامن عابرة للحدود، فتتكثف دعوات العزل والتشدد وتُغلق المساحات المدنية والوسطية التي يمكن أن تستوعب السخط الشعبي وتحيله إلى مطالب اجتماعية وسياسية قابلة للحلّ.
إقليميًا، يربط الخطاب بين ملفات متباينة — فلسطين، سوريا، ملف التطبيع، وأزمات داخلية في دول عربية — ليحاول خلق إجماعٍ معادٍ ضد نظم إقليمية ودولية محددة، ما يعرقل مسارات الوساطة والدبلوماسية في المنطقة. هذا الربط الموحّد يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي: فبدلاً من تعامل كل أزمة على مسارها السياسي الخاص، يتحول كل حدث إلى جزء من «مؤامرة» شاملة، ما يجعل منصات الوساطة أكثر هشاشة أمام اتهامات الخيانة ويصعّب بناء تفاهمات إقليمية مرنة.
دوليًا، عندما تُجرد الصراع إلى ثنائية وجودية، تصبح استجابات المجتمع الدولي مكبلة بين خيارين متطرفين: إما قمع أمني صارم يركّز على الحلول الأمنية والتشدد في الإجراءات، أو محاولة معالجة أيديولوجية واجتماعية عميقة تتطلب وقتًا وموارد وتعاونًا متعدد الأطراف. كثير من تقارير أنماط التطرف الحديثة تشير إلى انتقال عمليات التجنيد نحو فئات شابة ومعزولة، ما يُظهر أن مجرد الضغط الأمني دون إستراتيجية مجتمعية مفصّلة سيقود في الغالب إلى تعاظم شبكات مظللة وتنقّل طرق التجنيد إلى فضاءات رقمية أكثر غموضًا وصعوبة في المتابعة.
ختامًا، الأثر المحتمل لهذه الرسائل يتجاوز الأثر اللحظي للدعاية؛ فهو يعيد تشكيل بيئة المخاطبة الاجتماعية والسياسية: يضع علامات استقطاب جديدة، يرفع من تكلفة الوساطة، ويضغط على استراتيجيات الوقاية الدولية لتتحول من مواجهة تقليدية للجماعات المسلحة إلى جهود متكاملة تجمع الأمن مع التحصين الاجتماعي والتواصل المدني. قراءة هذه الديناميات ضرورة لفهم كيف تتحول بيانات إعلامية إلى عوامل تغيير حقيقية على الأرض.
أثر الافتتاحية على نمو التطرف (ماذا تفعل عمليا؟)
الافتتاحية تعمل أولًا على تعزيز سردية شرعية تحوّل مواقف سياسية معقدة إلى أحكام عقدية واضحة. باستدعائها المتكرر للآيات والأحاديث وتوظيفها كأدلة فقهية، تمنح النص نفسه هالة من الشرعية أمام جمهور معيّن، فيسهّل ذلك شرعنة العنف وتحويل قادة محليين وأمَراء فكرٍ إلى مرجعيات دينية تبرّر التحرك المسلّح. عمليًا، يؤدي هذا إلى ولادة خطاب «مقدّس» يبرّر الاعتداءات ويطوّع الدين كسياق شرعي للعمل السياسي العنيف.
ثانيًا، تساهم الافتتاحية في تأجيج العداء للمؤسسات المدنية عبر وصم الحكّام والفاعلين المدنيين بأنهم «طواغيت» أو خونة، ما ينهك الثقة بين المجتمع والدولة ويُضعف الحِزَم المدنية والوسطية. النتيجة المباشرة هي إضعاف آليات الوساطة الاجتماعية، وفتح سوق توظيف عاطفي للأفراد المعزولين الذين يجدون في التعبئة الجماعية مخرجا لمشاعر الغضب، فتتحول حالات فردية من الاستياء إلى حركات عنف محلية موجهة ضد مؤسسات عامة وخدمات مدنية.
ثالثًا، تقوم الافتتاحية بـتسطيح البدائل السياسية، فتمحو المساحات الوسيطة — مطالب إصلاحية أو نضالات مدنية أو مبادرات سلام — وتعرض أمام المتلقي خيارين فقط: الانخراط في المعارضة الجهادية أو الخضوع الكلّي. هذا الاستقطاب الثنائي يترك فراغًا استراتيجياً كبيرًا أمام الشباب والطبقات المهمّشة، فمن يشعر بالعجز أو الخذلان يجد في الخيار المتطرف تجاوبًا سريعًا وبديلاً عمليًا، ما يسرّع من وتيرة التطرف ويقلّل من فرص استعادة المسارات المدنية التدريجية.
رابعًا، تُترجم هذه الآليات إلى مسرّعات للتجنيد كما تُظهر تقارير المراقبة؛ فالخطاب الذي يركّب أزمة هوية مع أزمات اقتصادية واجتماعية يوفر مادة خام للتجنيد الرقمي والميداني. عمليًا، تستفيد الجماعات المتطرفة من الإحساس بالظلم والانفصال لتجنيد فئات شابة ومعزولة، بينما تعمل مواد مثل الافتتاحية على ترسيخ قواعد فكرية تجعل من الانضمام عملية ذات ما يُشبه «حُجية» دينية وأخلاقية، وليس مجرد خيار سياسي يائس.
ماذا يكشف الخطاب عن استراتيجية التنظيم الطويلة الأمد؟
الافتتاحية تكشف بوضوح عن بعدٍ إيديولوجي مركزي في استراتيجية التنظيم الطويلة الأمد: إنها ليست نصًا دعائيًا عابرًا بل مشروعٌ لإعادة تأسيس شرعية فكرية حول مفاهيم التوحيد والكفر بالطواغيت. عبر استدعاء النصوص الدينية وتوظيف ثنائيات أخلاقية قاطعة، يسعى التنظيم إلى ترسيخ قاعدة معرفية تدعم روايته وتحوّل الخلاف السياسي إلى معضلة عقائدية، ما يجعل من المناقشة السياسية المعتادة غير مجدية أمام متطلبات الولاء العقدي.
في الوقت نفسه تؤدي الافتتاحية وظيفة تعبوية واضحة؛ فهي تحوّل حالة الارتباك السياسي وانتشار الإحباط الاجتماعي إلى التزام فردي وجماهيري محدد يخدم أهداف التنظيم. هذا التحويل يمدُّ التنظيم بقدرة على تعبئة متلقين متفرقين، ويحوّلهم إلى عقد اتصال شبكية — أفراد فعالين إعلامياً وعملياتياً — قادرين على نقل السردية ونشرها محليًا وإقليمياً مهما ضعفت قدرات التنظيم الميدانية التقليدية.
الثنائية بين البعد الإيديولوجي والبعد التعبوي تمنح التنظيم مرونة استراتيجية على المدى الطويل: حافظ على تأثيره الرمزي واستثمار شعوري في اللحظات الحرجة، واستبدل التحرك الميداني المباشر بنشر أفكار وقِيَم تُبقي قاعدته منتبهة ومتحركة. النتيجة عمليةٌ مزدوجة: بقاء معنوي مستدام، وتوسيع لدوائر التجنيد والتأثير عبر شبكات متناثرة، ما يصعّب مهمة المواجهة الأمنية والعلاج الاجتماعي-الإيديولوجي إذا لم تُتبَع باستراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن، التعليم، والاندماج المدني.
توصيات عملية لجهات الإعلام، المجتمع المدني وصانعي السياسات
أولى التوصيات تتمثل في المواجهة عبر التحليل لا عبر التحريم فقط. الاكتفاء بإصدار فتاوى تحظر الخطاب المتطرف أو بقرارات أمنية لا يكفي، فالمطلوب هو تفكيك النصوص الدعائية من الداخل، وشرح بنيتها وأساليبها للرأي العام. هذا التفكيك يتيح إنتاج روايات بديلة أكثر تبسيطًا ووضوحًا، تصل إلى الجمهور المستهدف وتفقد الخطاب المتطرف قدرته على احتكار المعنى الديني أو السياسي. الإعلام يمكن أن يلعب هنا دورًا أساسيًا بتقديم شروح نقدية مقنعة دون الدخول في سجالات وعظية جامدة.
التوصية الثانية تتعلق بضرورة إعادة تأهيل المساحات الوسطية في المجتمع. الجماعات المتطرفة تنمو عادة في البيئات التي يغيب فيها الأمل أو تضعف فيها جسور الثقة مع الدولة. لذا يصبح من الضروري دعم مبادرات مجتمعية تُعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والخدمات والفرص الاقتصادية. حين يجد المواطن مسارًا عمليًا لتحقيق مطالبه، تتقلص قدرة الخطاب المتطرف على جذبه نحو بدائل عنيفة أو مطلقة. هذه المبادرات يمكن أن تكون على شكل مشروعات محلية صغيرة، أو برامج وطنية أوسع تستعيد فكرة العقد الاجتماعي.
أما التوصية الثالثة فهي برامج الاستجابة المبكرة للشباب. فالشريحة الأكثر عرضة للتأثر بالخطابات الجهادية هي الفئات الشابة التي تبحث عن معنى ودور. إدخال تعليم نقدي للإعلام والخطاب الديني في المدارس والجامعات، إلى جانب دعم مبادرات للصحة النفسية ومنصات تتيح نقاشًا سياسيًا مشروعًا، يوفّر للشباب أدوات لقراءة الرسائل المتطرفة بعين ناقدة. بذلك يتحول الشباب من متلقين محتملين إلى رافضين نشطين للروايات العنيفة.
وأخيرًا، هناك حاجة ملحّة إلى تعاون دولي متعدد الأبعاد يجمع بين العمل الأمني والقانوني وبين البرامج الاجتماعية والفكرية المصممة محليًا. فمواجهة خطاب عالمي مثل خطاب تنظيم الدولة لا يمكن أن تنجح إلا عبر استراتيجيات شاملة تتعقب ليس فقط الرسائل الصريحة، بل أيضًا ما يتم السكوت عنه أو تلميحه، مثل استغلال مشاعر «التيه» أو غياب المؤسسات. تقارير المراكز المتخصصة تؤكد أن هذا النهج المتوازن بين الأمن والسياسة الاجتماعية هو الأكثر فعالية في الحد من التطرف وتجفيف منابعه.
الخاتمة:
تكشف القراءة النقدية لهذه الافتتاحية أن النص ليس مجرد محاولة لتحفيز جمهور متعاطف، بل هو مشروع أوسع يسعى إلى إعادة تعريف الصراع السياسي والاجتماعي بوصفه معركة وجودية بين «الإيمان والكفر». خطورة هذا الخطاب أنه لا يكتفي بتأجيج الانقسام، بل يُحوِّل علامات الإحباط والفشل السياسي والاقتصادي إلى مبررات عقائدية تُشرعن العنف وتغلق أبواب الحوار المدني. ومن هنا فإن تأثيره لا يُقاس بعدد القراء أو المتابعين، بل بمدى نجاحه في إعادة هندسة وعي شريحة من الجمهور على أسس صلبة يصعب تفكيكها لاحقًا.
المواجهة الفعّالة لهذا النوع من الخطاب لا يمكن أن تقتصر على المعالجات الأمنية أو التحذيرات الدينية التقليدية. المطلوب هو نهج متعدد الأبعاد يجمع بين التحليل الفكري لتفكيك الرسائل، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمعالجة الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة، إضافة إلى سياسات تعليمية وإعلامية تبني قدرة نقدية لدى الشباب. عندها فقط يمكن تقليص المساحة التي يتحرك فيها الخطاب الدعائي، وتحويل الأزمات من مادة للتطرف إلى فرصة لإعادة بناء الثقة والاندماج المدني.