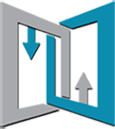الاول من نوعه في تاريخ المملكة "الفيصل "السعودية تنشر ملف حول العلمانية
الثلاثاء 19/سبتمبر/2017 - 06:37 م
طباعة

مفاجاة من العيار الثقيل فجرتها مجلة «الفيصل» السعودية في عددها الاخير رقم 491، لشهر سبتمبر من العام الجاري، حيث نشرت المجلة التى تصدر في اشهر دولة دينية في العالم ملف عن العلمانية ولعلها المرة الاولي في تاريخ الاعلام السعودي ان يفجر فيها هذا الموضوع الشائك
وأعدت «المجلة» ملفًا في عددها الجديد بعنوان «الصراع العربي حول العلمانية بين الدولة والدين»، كشفت أن «العلمانية»، لم تعد طرفا في ثنائية فكرية مكانها الكتب والأبحاث وقاعات الندوات، بل ضرورة، وحاجة مهمة بالنسبة للمجتمعات في وقتنًا الحالي، خاصة مع التأكيد على وجود اساسات لها في الإسلام والتراث القديم.
وشارك في الملف عدد من الكتاب والمفكرين من دول عربية مختلفة، منهم: «حسن حنفي، جلبير الأشقر، محمد المحمود، سامية بن عكوش، موسى برهومة، قادري حيدر، محمد شوقي الزين، نادر الحمامي».
بدا الملف بمقال عنوانه العلمانية شرط الحداثة ولا تقدُّم بدونها
للكاتب جلبير الأشقر - أكاديمي وباحث لبناني جاء فيه
قبل الخوض في موضوع العلمانية، لا بدّ من توضيح ما المقصود بهذا التعبير لما يكتنفه في منطقتنا من غموض والتباس، إن لم يكن تشويه متعمّد. فالعلمانية ليست عداءً للدين كما يحلو لأعدائها تصويرها لتأليب المؤمنين عليها، وليس هناك من تناقض بين الإيمان الديني وتأييد العلمانية بمفهومها الصحيح. بل تقوم العلمانية بمعناها الضيّق على فصل الدين عن الدولة، وتقوم بمعناها الأوسع على تجريد رجال الدين من السلطة في الشؤون غير الدينية كافة.
ويستند المعنيان الضيق والأوسع إلى منطق واحد. فلو أخذنا الإسلام مثالًا في تطبيق هذا المنطق (وهو ينطبق على جميع الأديان) لانطلقنا من أن الاختلاف العظيم بين ظروفنا وعلومنا المعاصرة وبين الظروف والعلوم التي كانت سائدة في الجزيرة العربية في عصر الإسلام الأول، يقتضي ممن يريد في عصرنا تسيير جميع الأمور باسم الدين أن يُبدع، مهما حاول ستر إبداعه وراء قناع الاجتهاد والتفسير. لذا فإن ممارسة السلطة السياسية وتقرير الشؤون الاجتماعية والعلمية باسم الدين يعنيان بالضرورة أن بعض الرجال يرى نفسه مخوّلًا فرض بِدَعه وتفسيراته الاعتباطية على المجتمع، الأمر الذي يهدّد بأسوأ العواقب. وبما أن عصر النبوّة قد انتهى ولا يجوز لأحد أن يدّعي تمثيل الإرادة الإلهية، فإن خير أشكال السلطة بالتأكيد ذلك الذي يحول من دون استبداد بعض الأفراد بالمجتمع بحجة ادّعائهم احتكار المعرفة الدينية، أو بأي حجة أخرى. ويتحقّق هذا الشرط من خلال حيازة عامة الشعب على السيادة واستناد القرار السياسي إلى الأغلبية الشعبية، أي من خلال الحكم المدني الديمقراطي. وهذا ما لخّصه الشعار الشهير لثورة عام 1919م في مصر: «الدين لله والوطن للجميع».
وكتب خالد فياض مقال بعنوان العلمانية والظلامية الإلحادية جاء فيه
أما مرادف العلمانية السياسية في مجال علوم الطبيعة فقد بات سائدًا في معظم البلدان. صحيح أن ثمة دولًا أو ولايات قليلة لا تزال تمنع تدريس تطوّر الأجناس بحجة تعارض هذه المقولة مع الدين، غير أنه لم يعد هناك من حكم سياسي يصرّ على أن الشمس تدور حول الأرض بحجة أن هذا ما نصّ عليه التراث الديني. والحقيقة أن الظلامية في مجال علوم الطبيعة لم تقتصر في القرن العشرين على تلك التي تحجّجت بالديانات السماوية، بل شملت أيضًا ظلامية إلحادية في الاتحاد السوفييتي حيث كانت تُفرض في عهد ستالين نظريات «علمية» مستوحاة من فلسفة «ماركسية» محنّطة كانت تشكّل أيديولوجيا الحكم الرسمية، أي ديانته «المادية». فإن ممارسة النقد العقلاني الذي لا يتقيّد بأي أفكار سابقة شرطٌ لا بدّ منه لوجود العلوم الحديثة. بكلام آخر، فإن العلمانية في مجال علوم الطبيعة هي شرط بديهي لتقدّم تلك العلوم التي يعود تأسيسها بوصفها علومًا بالمعنى الحديث إلى زمن تحرّرها من تسلّط الأفكار الدينية المصدر.
والأمر نفسه ينطبق على العلوم الاجتماعية، وهي حقلٌ كان لمفكّر عربي أسبقية في تأسيسه على أسس علمية بالمعنى الحديث. وإذا كان يحقّ لنا أن نفتخر بأن عبدالرحمن بن محمد بن خلدون هو أول من أسّس علم التاريخ وعلم الاجتماع الحديثين، علينا أن نفهم طبيعة ما كان سبّاقًا إليه وما أتاح له تحقيق إنجازه العظيم. وابن خلدون خير مثال على إمكانية التوفيق بين الإيمان الديني وفصل المعرفة الوضعية عن الدين؛ إذ لا يشكّ أحد في إيمانه واعتناقه الإسلام. بيد أن إيمانه هذا لم يمنعه من التحرّر من تفسير التاريخ بالإرادة الإلهية، وكيف به يعزو إلى تلك الإرادة ما شهده في عصره من تغلّب للمسيحيين على المسلمين في الأندلس، وتغلّب للمغول على الخلافة العبّاسية في العراق مع قيام هؤلاء بقيادة هولاكو باجتياح همجي لعاصمة الخلافة بغداد، وبعد ذلك تعرّض دار الإسلام أسوة بأوربا وغيرهما من مناطق العالم لكارثة الطاعون التي أودت بما يناهز ثلث مسلمي ذلك العصر (بمن فيهم والدي ابن خلدون)، وأخيرًا تعرضّ بغداد لاجتياح مغولي همجي جديد بقيادة تيمور لنك.
فكيف بمسلم صادق يقبل عقله أن يعزي إلى الإرادة الإلهية كل هذه الكوارث والنكبات البشعة التي لحقت بعامة المسلمين في عصره؟ هو ذا سرّ بحث ابن خلدون عن تفسير للتاريخ متحرّر من التفسير الديني، وقد حداه الأمر على اكتشاف دور العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية (العمرانية) في تحديد مجرى التاريخ البشري. ومن هذه العوامل «العصبية» التي رأى فيها عاملًا أساسيًّا في تأمين صلابة القوة العسكرية، مفسِّرًا تغلُّب الجماعات القبَلية الآتية من البادية على الجماعات الحضرية بكون عصبية الأولى أقوى من عصبية الثانية (وينسحب هذا التفسير نفسه على تغلّب المغول على الحضارة العبّاسية). وبينما رأى ابن خلدون في الدين عصبية تتميّز بنطاقها الأوسع بكثير من نطاق العصبية القبَلية، عصبية قادرة على صهر قبائل كثيرة ومختلفة في بوتقة قوة قتالية واحدة، لم يفته أن شتى الأديان لعبت مثل هذا الدور الذي لم يكن حكرًا للإسلام أو حتى لديانات أهل الكتاب، وقد لحظ ذلك في مقدمته الشهيرة.
العلمنة وتحرر الدين
في أوربا، استكمل الفكر العلمي الحديث سيادته في مختلف المجالات، سواء أكان في علوم الطبيعة أم في العلوم الاجتماعية، بالترافق مع ما أسمي بعصر التنوير الذي قام على التحرّر من سلطة الدين وتغليب العقل على الإيمان في المجال السياسي كما في مجال المعرفة الوضعية. وقد تقدّمت الثورة العلمية لدى الأوربيين بدءًا من عصر النهضة لديهم، أي بدءًا من القرن السادس عشر الميلادي، بالتوازي مع النقد الديمقراطي للحكم الملَكي المطلق الذي كان يدّعي الاستناد إلى حقّ إلهي. ومع أن العَلمَنة انتصرت على امتداد القارة الأوربية ومستعمراتها الاستيطانية، لم يختفِ الدين في تلك المناطق، بل استمرّ في شكل إيمان حرّ طوعي حلّ محلّ التديّن القسري الذي كان سائدًا من قبل. ليس هذا فحسب، بل إن تحرّر المجتمع والدولة والعلوم والتعليم من هيمنة الدين قد وجد نظيرًا له في تحرّر الدين ذاته من هيمنة الدولة، بعد أن كان الحكم الملَكي في كل دولة من دول أوربا العظمى قد فرض هيمنته على المؤسسة الدينية (الكنيسة) وحوَّلها إلى أداة سياسية من أدوات سلطته.
وفي هذا الصدد نذكر أن جماعات تستخدم راية الإسلام استخدامًا سياسيًّا كانت قد رفعت صوتها في مصر، خلال انتفاضة «الربيع العربي» التحرّرية في عام 2011م، تطالب باستقلال مؤسسة الأزهر عن الدولة. وقد قرأنا حينها أخبارًا كالتالي: «أكد الشيخ خالد فياض – الأمين العام لنقابة العاملين بالأوقاف وإمام وخطيب المسجد الفارسي بالأنفوشي – أنه لا بد من استقلال الأزهر ماليًّا وإداريًّا ليؤدي دوره الحقيقي في المجتمع المصري والعربي والعالمي» («أمل الأمة»، 25 يونيو 2011م). والمفارقة أن الذين رفعوا هذا المطلب هم أعداء للعلمانية بالرغم من أنه، من حيث لا يدركون، جزءٌ لا يتجزّأ من مبادئ العلمانية؛ إذ يندرج في فصل الدين عن الدولة. ولا يسع أي نصير للعلمانية بمعناها الصحيح سوى أن يثني على كلام الشيخ المقتبس أعلاه، ويؤيد مطلبه. أما الذين يريدون أن يجمعوا بين تحرير الدين من الدولة وتقييد الدولة بالدين، فهم يدافعون في الحقيقة عن دولة يسيّرها رجال الدين حتى لو ادّعى بعضهم أنه من أنصار الدولة المدنية، والحال أن لا دولة مدنية ولا ديمقراطية حقيقيتين بلا علمانية.
وتحت عنوان العلمانية أسُسها في القرآن وجذورها في التراث القديم
كتب الدكتور حسـن حنفــي – يقول
انتقل إلينا هذا الموضوع «الدين والعلمانية» من الثقافة الغربية بعد انتشارها في الثقافة العربية وكمصدر ثانٍ للفكر الإسلامي المعاصر. فالموضوع غربي. نشأ في سياق الثقافة الغربية الحديثة، نشأة وتطورًا. فقد تسلطت الكنيسة على الفكر الغربي. واضطهدت المفكرين الأحرار منذ مارتن لوثر وحركة الإصلاح الديني في القرن الخامس عشر حتى إسبينوزا وفولتير في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكان الدين كما تعرضه الكنيسة دينًا عقائديًّا. يصعب فهمه بالعقل الصريح الذي اعتمد عليه الغرب في بداية عصوره الحديثة منذ ديكارت في القرن السابع عشر.
فماذا يعنى التثليث والتجسد، وابن الله، وأم الإله؟ وهل يجوز صلب الأنبياء في التوراة والإنجيل؟ وماذا تعني الطقوس الكنسية السبعة من أول طقس العماد حتى طقس الزواج؟ ولماذا سلطة الكنيسة والمعبد وهما مؤسستان تاريخيتان من صنع البشر بحثا عن السلطة الدينية في مقابل السلطة السياسية، سلطة الأباطرة والملوك، وكلاهما يتسلط على رقاب الناس، ويتحكم في عقولهم، ويدخل في قلوبهم لتحديد من المؤمن ومن الكافر وكأنهما قد شقّا قلوب الناس؟ وهي معصومة من الخطأ. وهو الدين الغيبي الأسطوري، دين الخطيئة والخلاص، وحصار الإنسان العاقل الحر بين ذنب لم يرتكبه؛ خطيئة آدم، وخلاص لم يسع إليه، والإيمان بالمسيح أو بشعب الله المختار. فاليهود هم أبناء الله وأحباؤه، والعودة إلى أرض الميعاد.
حركة المفكرين الأحرار
فكان من الطبيعي أن تنشأ حركة المفكرين الأحرار في كل مكان في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وأميركا دفاعًا عن العقل والبرهان وعن مركزية الإنسان في الكون. فنشأ الصراع بين الدين والعلمانية. وتعني العلمانية، الاتجاه نحو العالم Mundus وليس الاتجاه إلى خارج العالم في الغيبيات والأساطير والخرافات التي مثّلتها المسيحية واليهودية في العصور الوسطى الكنسية. هذا هو السياق التاريخي الغربي الذي نشأت فيه العلمانية في صراعها ضد الدين. ثم أسقط المتغربون، أنصار الثقافة الغربية، هذا السياق على التاريخ الإسلامي وقرؤوه من منظور السياق الغربي. فأخفقوا مرتين: الأولى، إخراج الموضوع من سياقه الغربي. والثانية، إسقاط السياق الغربي على السياق الإسلامي المختلف تمامًا عن السياق الغربي.
أما الإسلام فإنه منذ البداية وكما عبّر عن ذلك القرآن الكريم مرات عدة فإنه دين العقل الذي دافعت عنه العلمانية ضد الخرافة والجهل. وهو ما عبّر عنه القرآن صراحة في مئات من الآيات مثل: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾. وهو ما ظهر في التراث الإسلامي وبخاصة عند المعتزلة وبعض الفقهاء في صيغة العقل أساس النقل. ومن قدح في العقل فقد قدح في النقل. وهو ما ظهر أيضًا عند الفقهاء، وبخاصة عند ابن تيمية في «موافقة صريح المنقول لصريح المعقول»، ووضع مبادئ للمنطق الإسلامي الذي يعتمد على العقل والبرهان مثل «ما لا دليل عليه يجب نفيه». والدليل العقلي هو الذي يجعل الإيمان راسخًا في القلوب كما سأل الله تعالى إبراهيم عليه السلام: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾. بل إن الفلاسفة أطلقوا على الله اسم «العقل والعاقل والمعقول». والاجتهاد وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع يقوم على العقل الذي يقوم باستنباط العِلّة من الأصل قبل أن يجدها في الفرع. والعقل هو مناط التكليف. فالمجنون لا يُكلف.
والإسلام دين العلم. يقوم على النظر والمشاهدة والتجربة؛ لذلك تتكرر آيات النظر في الأرض مثل: ﴿فَانْظُرُوا﴾، ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ﴾. ولما طلب إبراهيم عليه السلام الدليل على قدرة الله أعطاه الله دليلًا تجريبيًّا وهو قطع الطير أربع قطع. ونثر كل قطعة في اتجاه ثم يأتينه ويعدن طيرًا بإذن الله. ولما أراد أن يعطي إبراهيم عليه السلام قومه دليلًا على أن الأصنام ليست آلهة قام بتكسيرها، وعلق الفأس في رقبة كبير الأصنام. ولما سأله قومه ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُون﴾. يعتمد الإسلام على النظر في ظواهر الطبيعة مثل: الشمس والقمر والنجوم والكواكب بل يُقسم بها. ولا يعتمد على المعجزات بمعنى خرق قوانين الطبيعة مثل قلب العصا ثعبانًا أو إنزال مائدة من السماء كما طلبت بنو إسرائيل من عيسى. فالمعجزة للإبهار والدهشة.
والإسلام دين العقل والتجربة ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ﴾. ويعتمد المصدر الرابع في أصول الفقه على التعليل. وهو وجود العلة من الأصل في الفرع، ومعرفة علة الفرع بالتجربة. فالخمر مسكر في الأصل. ومعرفة هذا الشراب مسكر أم لا يتم بالتجربة. فإذا ثبتت علة السكر في الفرع أخذت حكم الأصل. وعندما ادعت امرأة أن رجلًا ضاجعها بدليل وجود منيه على ثوبها فركه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيديه واكتشف أنه زلال بيض. لذلك ازدهر العلم التجريبي في التراث القديم مثل: الطب والصيدلة والنبات والحيوان، والرياضيّ مثل: الهندسة والجبر، والموسيقا والفلك. فإذا كانت العلمانية تقوم على العلم كما قامت على العقل فإن الإسلام كذلك. والعلماء ورثة الأنبياء.
مركز الإنسان في الكون
وإذا كانت العلمانية تعني مركزية الإنسان في الكون والدفاع عن حرية إرادته، وتأسيس المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الحر، فإن هذه الأهداف تنبع من الإسلام. فالإنسان هو خليفة الله في الأرض ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾. وقد ذُكر الإنسان خمسًا وستين مرة في القرآن الكريم مما يدل على أهميته. كما يركز القرآن على مجتمع المساواة والعدالة ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين﴾، ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾. وفي الحديث «ليس منا من بات شبعان وجاره طاوٍ». وهذه هي دلالة الصيام والزكاة، الإحساس بالآخر.
وقد نادى الصحابي أبو ذر الغفاري بمجتمع المساواة عندما رأى البون الشاسع بدأ يظهر بين الأغنياء والفقراء. وعند الأصوليين لقد وضعت الشريعة ابتداءً حفاظًا على الحياة ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾٭، ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ والحفاظ على العقل بالرغم من النسبة العالية للأمية في بلادنا، والحفاظ على الدين أي الحقيقة المطلقة ضد الحقائق النسبية والأهواء البشرية والمصالح الشخصية، والحفاظ على العرض أي على الشرف والكرامة والحياء، والحفاظ على المال ضد تبديد الثروات وبخاصة تلك التي في باطن الأرض في مظاهر الاستهلاك الذي لا يفيد، وليس في بناء المستشفيات والمدارس. والمجتمع الإسلامي مجتمع ديمقراطي حر. الأمر شورى بين المسلمين ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾. وهو مجتمع حر يقبل المعارضة والرقابة على الحكام طبقًا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المبدأ الخامس من مبادئ التوحيد عند المعتزلة مثل العدل، والاستحقاق، والحسن والقبح العقليين. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فوق المنبر: «رحم الله من أرشدني إلى عيوبي»، فأجاب أحد المصلين: «والله لو رأينا فيك عيبًا لقومناه بسيوفنا». ونذكر ذلك دائمًا والمعارضة ضعيفة عندنا، في السجون والمعتقلات أو هاربة إلى الخارج.
لذلك لما كان الإسلام آخر الأديان فقد احتوى كل القيم العلمانية فيه: العقل، والعلم، وحقوق الإنسان، وديمقراطية الحكم. المصلحة مصدر للتشريع طبقًا لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، «وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن». والكافر العادل خير عند الله من المسلم الظالم. والإنسان بعمله. هكذا نادى الفقهاء القدماء والمصلحون المحدثون. فأي إيهام بتعارض الدين والعلمانية هو نسيان لجذور العلمانية في التراث القديم وأسسها في القرآن الكريم أو التبعية للثقافة الغربية وإخراجها من سياقها، وإسقاطها على سياق آخر طبقًا لعقلية التعارض بين الصوري والمادي، العقلي والتجريبي، الأنا والآخر، الدنيا والآخرة، من دون الجمع بين الحسنيين.