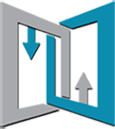خبراء يدرسون علاقة الاسلام بالارهاب في الدول الغربية
الإثنين 03/يوليو/2017 - 04:49 م
طباعة

نشر معهد واشنطن ملخص ندوة مهمة عقدها حول العمليات الارهابية في الغرب وعلاقة الاسلام بها شارك فيها ديك شوف، منسق وطني للأمن ومكافحة الإرهاب" في هولندا و محمد فريزر -رحيم، المدير التنفيذي في أمريكا الشمالية لـ "مؤسسة كويليام الدولية لمكافحة التطرف" ومقرها في لندن فرح بانديث، أقدم مساعدة في "مجلس العلاقات الخارجية" والتي تعمل أيضاً في "المجلس الاستشاري" لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، كرئيسة مشاركة لفرقة عمل "مكافحة التطرف العنيف". وماثيو ليفيت مدير برنامج "ستاين" للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن وجاء في الملخص
الاسلام السياسي غير الاسلام
راي محمد فريزر - رحيم
يتأقلم المتطرفون ويتعلمون بفعالية أكبر من أي وقت مضى. وفي الواقع، لاحظ المحللون لشؤون مكافحة الإرهاب أن الهجمات الاستعراضية الواسعة النطاق تطوّرت إلى ضربات تحتاج إلى تقنيات منخفضة بل ذات تأثير كبير. ومع ذلك، ففي الوقت الذي تشكل فيه مكافحة التطرف العنيف تحدياً ضخماً، يجب على المسؤولين والمحللين أن يكونوا حذرين جداً من عدم الخلط بين هذا التطرف والمعتقدات الإسلامية.
ولدواعٍ تعريفية، لا بد من الإشارة إلى أن الإسلام هو رؤيةٌ عالمية، ونظام قيم، ونظام معتقدات يعتنقه نحو 1,5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم. أما الإسلام السياسي، على سبيل المقارنة، فهو إيديولوجيا سياسية تدعم تفسيراً صارماً للإسلام، الذي هو محدود ومتصلّب وصارم، وقانوني في الغالب (أي متقيد بحرفية الشريعة). وللإسلام السياسي مظاهر حديثة تتجسد في مختلف أنحاء العالم. فبعض الجماعات الإسلامية تشكل منافذ لمنظمات أكثر عنفاً، من بينها الجماعات الإرهابية، التي تستطيع - إذا تُركت دون فحص أو تدقيق - أن تقود الأفراد إلى طريق التطرف نحو جماعات أخرى مثل تنظيم «القاعدة» وحركة «الشباب» و«بوكو حرام» و تنظيم «الدولة الإسلامية». ويرسم الإسلاميون صورةً لدولة إسلامية دينية وأسطورية تخاطب العالم الإسلامي بأجمعه، ولم يكن لها وجود صراحةً، ولكنهم يستغلون فكرتها لحشد الناس على ممارسة العنف. وحين تمتزج الإيديولوجيا الإسلامية بالعقيدة السلفية، تنشأ هذه المظاهر الحديثة للجهادية السلفية.
فما الذي يجب فعله؟ يجب عزل الإيديولوجيا المتطرفة العنيفة عن الإسلام الشائع. ومَن يمكنه القيام بذلك؟ يرى الكثيرون أن العلمانيين وحدهم لا يستطيعون نقض وتغيير التأويلات المتطرفة، فالأصوات الأكثر قدرةً على التصدي للتطرف السلفي هي أصوات المسلمين الأتقياء الملتزمين بالدين الذين يعتبرون هذه المسألة بمثابة مرض سرطان يصيب دينهم. وهنا في الغرب، يتعين على الأفراد والمؤسسات أن ينقضوا النصوص والآراء التي تعزز الأفكار البغيضة أو العنيفة أو تلك الكارهة للنساء. فصحيحٌ أن هذه الأفكار قد تكون محمية قانونياً في الأنظمة الديمقراطية الغربية، إلا أنه يجدر بالناس محاربة الإيديولوجيا والمحرّمات تماماً كما يحاربون رهاب المثلية والتمييز العنصري وغيرها من المظاهر المدمّرة الأخرى.
وتقول فرح بانديث
يجب على المرء أن يكون صريحاً عند التساؤل عن سبب تكرار التحديات نفسها التي يطرحها التطرف والإرهاب بعد مرور 16 عاماً على هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وفي الواقع لا تقتصر هذه القضية على تنظيم «الدولة الإسلامية» - بل هي أكبر بكثير من ذلك.
أضف إلى ذلك أن ما اكتشفه خبراء مكافحة الإرهاب منذ قرابة العقد، حين شرعوا للمرة الأولى بدراسة إيديولوجيا التنظيمات المتطرفة، لا يزال ينطبق اليوم. فالجواب هو في الحلول المحلية، فباستطاعة أصحاب النفوذ الموثوقين والصالحين إحداث فرق في صفوف نظرائهم، وللحكومة دورٌ محدود للغاية. ومن الضروري العودة إلى هذه المبادئ الأساسية لإحراز تقدمٍ في مكافحة الإيديولوجيا المتطرفة.
وعند تطبيق هذه المبادئ الأساسية، يتعين على المسؤولين إقامة شبكات تضم مفكّرين ذوي تفكير مماثل يتقنون أحدث التكنولوجيات ويستطيعون إغداق أفكار بديلة على قنوات التواصل للتصدي للمتورطين في التطرف. وفي الإطار نفسه، لم تكن الأموال الحكومية كافية قبل عقد من الزمن لمساعدة المنظمات الأهلية غير الحكومية على الجبهات الأمامية، ولا تزال بالتأكيد غير كافية اليوم.
وفي العالم اليوم مليار مسلم دون سن الثلاثين (كما أن هناك ما يقرب من 1.6 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم يشكلون حوالي ربع سكان البشرية). وهذه هي الفئة التي تجنّد منها الجماعات على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية» عناصرها. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد المسلمين في العالم إلى ملياري نسمة، ما يعني أن العجز عن معالجة الأسباب الجذرية للتطرف الإسلامي معالجةً شاملة سوف يستدعي خلال عقد من الزمن نفس البحث الروحي [أي التحليل المعّمق للدوافع والقناعات] الذي ينخرط فيه المجتمع حالياً.
بيد أنّ العودة إلى المبادئ الأساسية وتطبيق الدروس المستخلصة على مدى العقد المنصرم، ستحتاج بالفعل إلى تمويل من أجل التمكّن من تنفيذ أي خطة على نطاق مناسب. فالبرامج التجريبية الصغيرة المنفّذة في مختلف أنحاء العالم لن تكفي لمنافسة تنظيم «الدولة الإسلامية» والجماعات المماثلة. ويمكن المجادلة وبشكل مقنع أن الولايات المتحدة لم تحاول حتى الآن بذل كل ما في وسعها في مثل هذه المقاربة. ولكن بالعزم والإصرار، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تنجح إذا ما شملت عناصر حركية وغير حركية في الوقت نفسه، وإذا ما نُفّذت على نطاق أوسع، واتسمت بالجدية في أساسها.
اما ماتيو ليفيت فقال
عند التطلع إلى مرحلة هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» وما يعرف بدولة الخلافة في سوريا والعراق، يتعين على المحللين والمسؤولين أيضاً العودة خطوة إلى الوراء. فحتى إذا كان التنظيم الجهادي يخسر سيطرته على الأراضي ويمنى بالهزيمة على جبهات القتال، سيبقى تهديده في المنطقة والعالم قوياً.
وأولى المشاكل الجدية المترتبة هي عودة المقاتلين الإرهابيين إلى ديارهم، ولا سيما إلى أوروبا، حيث سبق أن عاد المئات من آلاف المقاتلين الأجانب. وحتى بوجود أفضل خدمات الاستخبارات، فإن استخدام الوثائق المزورة بجودة عالية لمعاودة الدخول إلى أوروبا يعني أن السلطات لن تكون قادرة على تحديد جميع العائدين. وبالفعل، سبق أن أبلّغت بريطانيا عن أشخاص حاولوا العودة إلى ديارهم بمثل هذه الوثائق المزورة المتطورة.
أما في الولايات المتحدة، فإن مسألة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب لا ترقى إلى النطاق الذي تشهده أوروبا - إذ ليس لدى الولايات المتحدة سوى ثلاثمائة مقاتل تقريباً، الذين إما سافروا إلى سوريا أو العراق أو ليبيا، أو حاولوا القيام بذلك - ولكن خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة، سيؤدي إطلاق سراح المئات من الإرهابيين المدانين من السجون الأمريكية إلى تغيير الوضع. ولا تملك الولايات المتحدة برامج لمكافحة التطرف العنيف كما في سجونها، ولا تملك مثل هذه البرامج ضمن أنظمة إطلاق السراح المشروط [أنظمة وقف التنفيذ] لديها بما يهدف إلى مساعدة الأفراد على الاندماج من جديد في المجتمع. ولهذا السبب، من الممكن أيضاً أن تواجه الولايات المتحدة تهديداً على نطاق مماثل لذلك الذي تواجهه أوروبا. ويجدر بالذكر أنه من المتوقع إطلاق سراح أول إمرأة تُدان بتهم التورط مع تنظيم «الدولة الإسلامية» في وقت قريب جداً.
من هنا، يستوجب التغلب على منحى التطرف جهوداً مركّزة إلى أقصى حد ممكن على الساحة المحلية. أضف إلى ذلك أن الأشخاص الأكثر فعاليةً في مواجهة إغراء الإرهاب في المستقبل لن يكونوا محللين أو ضباط؛ بل سيكونون أخصائيين اجتماعيين سريريين، وعلماء نفس، ومعلّمين. إذ يستطيع هؤلاء المهنيون الذي يعملون في الواجهة، من خلال تدخلهم المبكر مع الأفراد المعرضين للخطر، أن يساعدوا على منع التطرف قبل أن يتجذر في أعماق هؤلاء الأفراد. ويمكن لهذه الاستراتيجية المحلية أن تضع حداً لحملات التعبئة للعديد من الإيديولوجيات المتطرفة الأخرى أيضاً. وبالإجمال، لا بد لأي مقاربة يتم اتخاذها إزاء التطرف أن تملك توجّهاً شاملاً للمجتمع بأسره، وأن تكمّل في الوقت نفسه الجهود التي يبذلها المسؤولون الحكوميون لمكافحة الإرهاب.
وفي الواقع أن العائق الأكبر أمام النجاح هو التمویل غیر الکافي لمبادرات مكافحة التطرف العنيف التي تطلقها المجتمعات على المستوى المحلي. ولا تستطيع الحكومة الاتحادية كما لا ينبغي أن تكون المصدر الوحيد لتمويل هذه المساعي. يجدر بالمجتمع المدني والشركات الخاصة أيضاً أن تتحمل بعضاً من هذا العبء المالي، لأن خطر التطرف العنيف يهدد الجميع ، وهذا ما يبرر المقاربة القائمة على إشراك المجتمع بأسره - وليس فقط النهج القائم على إشراك كافة الجهات الحكومية. وعموماً، يجب أن تنتقل الجهود المبذولة من القاع إلى القمة، وليس من القمة إلى القاع.
وفي الوقت نفسه، تتهافت وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات على الشبكات المحلية التي يمكن أن تشارك معها لمعالجة حالات التطرف التي تقع دون عتبة الملاحقة القانونية. ويتضح مرة تلو الأخرى، أن الأشخاص الذين ينتهي بهم المطاف بتنفيذ الهجمات يكونون قد تخطوا سابقاً رادار إنفاذ القانون. وفي كثير من هذه الحالات، تم التحقيق مع المشتبه بهم ولكن الضباط قرروا في النهاية أن سلوكهم كان مثيراً للقلق ولكن ليس مخالفاً للقانون بأي حال من الأحوال.
ولا يجوز تجريم الفكر المتطرف في المجتمعات الديمقراطية، ولكن يجب نقض الأفكار المرتبطة به. وعندما تواجه عناصر إنفاذ القانون أفراداً تبنّوا مثل هذه الأفكار الخطيرة بل المحمية، لا بد أن تكون لديهم شبكات محلية تضم شركاء جاهزين من الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس وغيرهم. ومن ثم، عندما يظهر شخصٌ له مواصفات مطلق النار في أورلاندو ويُظهر سلوكيات مقلقة بل غير مخالفة للقانون، سيكون لدى "مكتب التحقيقات الفيدرالي" أو الوكالة المحلية لإنفاذ القانون شخص أو مجموعة يمكن تسليمهم القضية.