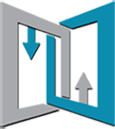قراءة في منطلقات "صناعة الموت" وتفكيك العقل المتطرف
الأحد 22/أبريل/2018 - 05:34 م
طباعة

في الوقت الذي نرى فيه صناع للحياة، نرى أيضًا صناعًا للموت، ومع ظهور بعض الفرق المتشددة التي تدّعي التمسك بصحيح الدين، في العقود الأخيرة، في حين أنها من أهم عوامل هدم الحضارة وسفك الدماء، لذا أطلق عليها الخبراء "صناعة الموت"، فهي الفرق التي لا تنتمي إلى دين بعينه، بل إنها أصبحت فعلاً كريهاً ظهر على أيدي بعض المنتسبين إلى الإسلام والمسيحية، وكذلك اليهودية، وفي هذا التقرير نتناول ورقة بحثية، أعدها الباحث محمود كيشانة، ونشرتها مجلة ذوات الصادرة عن مركز مؤمنون بلا حدود، حاول فيها القاء الضوء على المقصود بصناعة الموت، و ما المنطلقات التي تنطلق منها صناعة الموت؟ وما أهم سماتها؟.
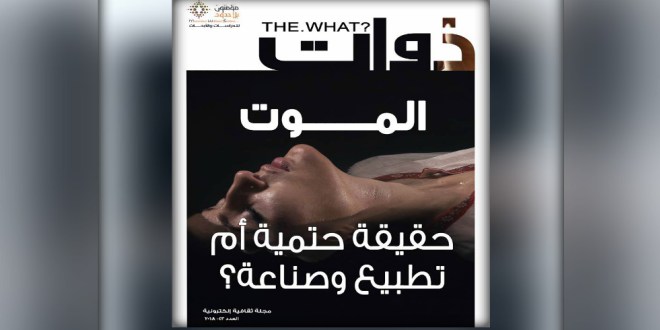
وخلص الباحث، في النهاية، إلى أن إن الجهاد في شكله الحسي القائم على القتال ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة كانت تناسب ذلك الظرف التاريخي الذي كان غاية المسلمين الأوائل فيه الإعلان عن الإسلام ونشره في العالمين، ولم تكن غايتهم مجرد القتل وسفك الدماء. أما وقد حل علينا هذا العصر بتكنولوجياته وأدواته، فقد تعددت إذن الوسائل التكنولوجية والعصرية التي يمكن من خلالها الإعلان عن الإسلام ونشره، ومن ثم يتوارى الجهاد الحسي؛ ليعلن أنه كوسيلة قد حلت محله وسائل أخرى أكثر نجاعة، بحيث تبرئ الإسلام من أي تهمة الإرهاب التي ألصقها به بعض من المتشددين المنتسبين إليه، تحت إلحاحات أيديولوجية، أو بداعي عدم الفهم الصحيح للنصوص الدينية. ومن ثم وجب إزالة ما علق به من شوائب أسهمت في وضع الدين في موضع الاتهام، وكذلك بإعادة تشغيله وفق ما يقتضيه العقل من خلال فهمه للنصوص الدينية.
وبدأ الكاتب ورقته، بالحديث بالإشارة إلى المتأمل في الدين الإسلامي، في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية يجد دعوة صريحة إلى التعايش مع الآخر المختلف في العقيدة أو الجنس أو القبيلة أو غيرها، إلا أن هذه النصوص تختطف من قبل البعض، وتقدم لها تفسيرات مشبوهة تبثّ سمومها، مع أن هذه الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية لم تدعُ قط إلى الاعتداء على الآخر، لاختلافات عقدية أو غيرها، وإنما ينحصر توجيه الآيات في الدفاع عن النفس ودرء اعتداء الآخرين: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين". أما أن يتخذ من الآيات القرآنية أداة لتبرير اتجاهات معينة، فهذا من الأمور التي لا تخدم الدين، وإنما تجعل منه متّهماً في قفص اتهام صنعه له أتباعه الذين ظنوا أنهم بذلك قد قدموا خدمة جليلة لدينهم، وهم في حقيقة الأمر يوجهون له الطعنات الواحدة تلو الأخرى.
وقالت الورقة، بالنظر إلى ما تفعله بعض الجماعات المتشددة من قتل وذبح المخالفين في العقيدة على مسمع ومرأى الجميع على شاشات التلفاز، فإنه تعبير عن الوحشية ومدى ما يعتمل في صدور هؤلاء من حقد على الآخرين، ومحاولة الإجهاز عليهم، وليس تعبيراً بأي حال عن الدين السمح في عقائده وتشريعاته؛ فالرغبة في العنف والقتل - كما يبين رينيه جيرار- متى استيقظت أحدثت في صاحبها تغييرات جسدية تعده للقتال، ومع أن هذا الاستعداد العنفي محدود الأجل، فإنه لا يصح أن نعده مجرد ارتكاس تتوقف أفعاله بتوقف عمل المحفز؛ لأن تهدئة رغبة العنف هي أشد صعوبة من إثارتها بمراحل، خصوصًا في ظروف العيش العادية داخل المجتمع. وقد انتقد العديد من الباحثين المعاصرين معسكرات الموت أو سحابة القتل التي غيمت سماء العالم؛ نتيجة الفهم الخاطئ المبني على عقل مغلق.
ثم حاول كيشانة، الاجابة عن المقصود بصناعة الموت بناء على ذلك، وقال إنه إذا كان هناك صُنّاع للحياة من حولنا، ونقصد بهم أولئك النفر الذين يشيعون روح التفاؤل والجمال بين الناس، وهؤلاء هم الذين يعملون دائماً على نشر التسامح والحوار مع الآخر، أياً كان توجهه العقدي أو المذهبي، ويحلمون بعالم خالٍ من الحقد، خالٍ من الكراهية، خالٍ من مناظر الدماء التي تسيل هنا وهناك، عالم ليس فيه مكان لمُلّاك حقيقة مطلقة من الاتجاه الأصولي أو الاتجاه العلماني، فإننا نجد من يحملون راية كتب عليها صناعة الموت، وهي راية غير مرئية؛ لأن الإنسان لا يحملها على يديه، وإنما يحملها في قلبه، وهنا تكمن الخطورة، إذ إن علاج أدران القلب أو أمراضه أشد صعوبة مما عداها. وهذه الراية لا يحملها أصحاب توجه بعينه، فليست حكراً على بعض أصحاب الاتجاه المحافظ، بل يحملها أيضاً بعض المنتسبين إلى الاتجاهات الحداثية والتنويرية، وذلك بتزكية هوة الخلاف، وعدم البحث عن نقاط التقاء تصنع نوعاً من الحوار بينهم، وإنما أراد كل تيار أن يصنع من نفسه نموذجاً يريد من الآخرين أن يقتفوا أثره، وهي كلها أمور تزكي لا شك صناعة الموت أو تعد سبباً من ضمن أسبابها.
ومن ثم، فصناعة الموت هي تلك الصناعة التي تهدف إلى سفك الدماء وقتل الآخر لاختلافات عقدية أو عرقية أو مذهبية أو غيرها، عن طريق المشاركة الفعلية في القتل، أو عن طريق تعميقه بأي وسيلة من الوسائل أو أداة من الأدوات، ويشارك في ذلك أصحاب توجهات شتى، وليس اتجاه بعينه، وإن كان أشدها ظهوراً الاتجاه الذي يتخذ من التشدد الديني مسلكاً ومنهجاً، حسبما أشارت الورقة.
وعن سبب تسميتها بـ"صناعة الموت"، أجاب بقوله: لأن صاحبها يصنع على عين محبي الدماء، ينشأ وسطهم، ويتشبع بفكرهم، حتى تملأ عليه فكرة القتل كيانه كله، فيصير كالقنبلة الموقوتة التي تنتظر ساعة الانفجار، وما ساعة الانفجار إلا التي حددها القادة والزعماء الذين ينتمي هو لهم ويأتمر برأيهم وينصاع لأوامرهم؛ لأن صناع الموت لا يعرفون من الدين إلا القادة، فإذا أفتوا برأي فهو رأي الدين، وإذا قالوا، فالسمع والطاعة؛ لأنه قول الدين، ألغوا عقولهم وصاروا كالحمار يحمل أسفاراً.
وأبرز الكاتب، مجموعة منطلقات لصناعة الموت بالأساس منها، العقل المغلق: العقل الذي أنتج الموت وجعله صنيعة له هو عقل مغلق، والعقل المغلق كما عرَفه الدكتور محمد عثمان الخشت قائلاً: "العقل المغلق مثل الحجرة المظلمة التي لا نوافذ لها .. إنها لا ترى النور، ولا يمكن لمن بداخلها أن يرى شيئا سواء في الداخل أو الخارج.. ولا يتنفس إلا هواء قديما، أما أكسجين الحياة فلا يمكن أن يصل إليه! إن صاحب العقل المغلق أشبه بالطفل في رحم الأم، كل عالمه هو هذا الرحم، وهو غير متصل مع العالم الخارجي، ولا يمكن لأحد أن يحاوره، ولا يمكن أن يخرج من هذا العالم المغلق بإرادته، إنه يظن أن الخروج من هذا العالم مهلكة، وهو يصرخ بأعلى صوته ويتلوى ويرفس عند إخراجه قسرا".
وهذا هو السبب الذي يفسر لنا لماذا يوصف العنف في الغالب باللاعقلانية، وهذا أيضًا هو السبب الذي يفسر لنا لماذا لا يتورع من إظهار كل ألوان السفك والتنكيل بالآخر، فعقله المغلق يمنعه من التواصل مع الآخر أو التحاور معه، فالقتل بديل للحوار، فهو يتنفس كرهاً على الآخر، وحقداً عليه، ومن ثم فهو لا يستطيع بحال الخروج من هذا الجو الفكري المقيت، ومن ثم فلا يتصور نفسه بعيداً عنه، أو يعيش بمنأى عنه. ولذا فهو يأنف من كل جديد، ويراه ضرباً من الخروج على الدين، ويمثل هذا الجو المرتع الخصيب الذي تبنت وتترعرع فيه صناعة الموت، فمثل هذا العقل إذا قيل له: اقتل، سيقتل في الحال، وإذا قيل له اذبح سيذبح دون تردد، بل إننا نعد هذا الذبح وذاك القتل هو الأكسجين الذي يتنفس به هؤلاء.
ومن ثم فإنه إذا منع من هذا الجو فإنه حتماً سيموت، لأنه لا يعرف غيره، ولا يستطيع إلا أن يأخذه معه أينما حل. ومن ثم لا يستطيع صاحب العقل المغلق أن يتجاوز ذاته أو عالمه الخاص. ومن المستحيل أن يرى أي شيء خارج عقله، ولا يستطيع أن يتجاوز أفكاره المظلمة ولا يمكنه أن يرى غير أفكاره هو، ويعتبرها يقينية قطعية لا تقبل المناقشة، بل يصل به الحد إلى اعتبارها طابعاً إلهياً.. وأن الله تعالى معه! بل إنه ممثل الله على الأرض. والله ليس رب العالمين، بل ربه هو فقط. وعندما يدخل في صراع مع أحد، فالبديل الوحيد عنده هو إعلان الحرب المقدسة؛ فهو وحده على طريق الحق والخير، وغيره كافر، أو عَلماني، أو ضال، أو شرير أو فاسد. ومن ثم فهو لا يسير إلا حيث أوصله عقله الذي يعيش في كهف الأنا فقط، ومن ثم فهو لا يقنع بقانون ولا بآراء؛ لأنها لا تناسب الجو المغلق الذي يرتع فيه، وهذا يفسر حالة النهم في القتل وإراقة الدماء.
وهذه الدماء التي تسيل، إنما تسيل لأتفه الأسباب، بل ما أكثر ما استند هؤلاء إلى مقولة الغاية تبرر الوسيلة أو الضرورات تبيح المحظورات، فالقتل حرام، بيد أنه يستحله عندما يجده يقف سداً بينه وبين مصالحه الشخصية، أو ما يظنه غاية سماوية، ومن ثم فهو في رأيه قتل مقدس، يقتل باسم الدين، وينحر ضحيته تحت نداء السماء. وهو ما عبرت عنه ببشاعة تلك التفجيرات التي أدت إلى مقتل العديد من أبناء مصر في كنيستي طنطا والإسكندرية، وهو ما عبرت عنه ببشاعة أيضاً تلك الإبادة التي يتعرض لها المسلمون باسم الصليب في بورما وأفريقيا الوسطى من جماعات مسيحية مسلحة، كما أن مما يعبر عنه ذلك التهديد المستمر والإرهاب المقنع الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ثاني المنطلقات التي ينطلق منها صانعو الموت، هو الانقياد الأعمى لكل ما يملى عليهم، لذا انتشر القتل باسم الطاعة، طاعة الأمير أو الزعيم أو المرجع، فهو الذي يؤخذ منه الدين، وتنطق بلسانه السماء، ومن ثم فإذا قال سمع له، وإذا أمر أطيع، وإذا نادى أجيب، فهو القادر على تفسير المغلق، وفتح أبواب المبهم، ومن ثم فإعادة التأويل متاحة، ولذا نجد تعدد التأويلات، فلا مانع من تغيير تأويل النص ليتوافق مع المصالح والتوجهات، وليته يؤول النص على أسس عقلية، إذ لو استخدم عقله لعلم أن النص يحوي من قيم التسامح ما يستطيع أن يجعل العالم في سلام وتعايش، لكنه أبى إلا أن يسير خلف من يقلدهم كسير القطيع خلف الراعي، ومن ثم فلا مانع لدى هؤلاء من توجيه النص لتبرير القتل، فإن أشد العوامل التي تصنع الموت هو التقليد الأعمى، كما أن المقلدين بفتح اللام، لا المقلدين بكسرها، هم العامل الرئيس الذي تصنع أسباب الموت على عينه. وهذا التقليد الأعمى هو الذي يصنع الطائفية التي يتلوها العنف والقتل، فالطائفية مرتبطة بالتعصب والغلو فيه.
وبعد العقل المغلق والانقياد الأعمى، يأتي التعصب وهذا ثالث الثالوث، لأن المتعصب يفترض في آرائه وأفعاله الصواب، في الوقت الذي يفترض في آراء وأفعال الآخرين الخطأ، فهو يمارس نوعاً من النرجسية، "فالنرجسية توهمه بأنه الوحيد على حق دائما، والقدرة الكلية لفكرته يتوصل بها إلى تغيير العالم سحريا واجتلاب الفردوس، والإسقاط يُريحه من شبهات الضعف والقصور البشري". وليت تعصبه - أو إن شئت فقل نرجسيته - مبني على أدلة عقلية برهانية، وإنما تعصب مبني على السير في طريق التقليد الأعمى، وهذا التعصب يجعله أولاً ينفي الآخر ويتسلط عليه، رغبة في أن تكون آراؤه وأفعاله في الصدارة، ثم يحصره ثانياً في دائرة التشويه والقتل المعنوي، فإذا لم يجد النفي والتسلط أو التشويه والقتل المعنوي نفعًا، فليس هناك من سبيل غير القتل الجسدي وإراقة الدماء.
وهذا تشدد رفضه الإسلام ذاته، فهناك مجموعة من الأحاديث النبوية لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- تذم بكل قوة التعصب والأسباب الداعية والنتائج التي تترتب عليه، منها: "لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم"، "هلك المتنطعون"، "وإن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا ..."، "إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين". وهذا دليل حي على إن التعصب المقيت بكافة ألوانه وأشكاله سواء أكان: فكرياً أو دينياً أو اجتماعياً أو سياسياً أمر لم يقره الدين بحال، ولم يسمح به، وذلك لما يترتب عليه من آثار، وما يشيعه من موجات الخوف وفقدان الأمن والأمان اللذين يقضيان على السلم الاجتماعي؛ لأن المتعصب يرفض التواصل مع الآخر بدعوى امتلاك الحقيقة، وإذا لم تسر في الركب فأنت ضدي، ومن ثم تنتهك حرماتك وتزهق روحك. ومما يدل على أن هذا التعصب المقيت ليس من الدين في شيء قول الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". وقال تعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم - "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"، وقوله: "لن يشاد الدين أحد إلا غلبه". وقوله: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً ".
وهذه النصوص الدينية دليل واضح على أن الإسلام ينبذ التعصب وما يترتب عليه من تشدد وعنف يؤديان إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. وهذا يدل على شيء من الأهمية بمكان هو أن الانغلاق على القديم دون بيان غثه من سمينه، وعدم مراعاة الظروف المكانية والزمانية يوقع في إشكاليات من هذا النوع الداعي إلى التطرف والقتل، ولذا وجدنا من الباحثين من ينقد أزمة العقل المسلم، ذاهبًا إلى مبدأ التقليد التاريخي الذي ينكب على القديم في بطون الكتب، مع إلغاء الأبعاد الزمانية والمكانية وآثارها لن يؤتي ثماره ما لم ينطلق المنطلق الصحيح له.
كما تحدث عن الأوضاع السياسية العربية شريكة في صناعة الموت، والتي تعد في نظر الكاتب، أحد الروافد الأساسية لصناعة الموت منذ عدة عقود سابقة، فالسياسة العربية تدعي التمسك بالديمقراطية، وهي أبعد ما تكون عنها، تنظر للديمقراطية على أنها من الديكورات التي تجمل بها شكل الدولة أمام العالم ليس إلا، ومن ثم تنظر للحرية على أنها تساوي الفوضى، ومن ثم وجب الاستبداد، والضغط على أنفاس الشعوب بكل السبل والوسائل، وهذا هو الجو المناسب الذي يرتع فيه الفكر المتطرف، الجو الذي يصنع فيه الموت، ذلك أنه القدر الذي تطهى فيه الأفكار وتختمر فيه الرؤى، ومن ثم لا يبقى إلا ساعة التنفيذ، ساعة تطاير الأشلاء وانفجار الجماجم. وعليه فإنه كلما كانت السجون والمعتقلات وتسلط سلطات الدولة قائمة زاد العنف وعم الغلو في كل شيء، وكلما انتهجت الدول نهج الإقصاء ازدادت وتيرة الخلافات، وانتشر الإرهاب، بينما إذا زادت مساحة الحرية وتقبل الرأي والرأي الآخر والاستماع للمعارضة قل التعصب والتشدد ومن ثم الدماء.
وأكدت الورقة، إن مشكلة صناعة الموت في جوهرها هي ناتجة عن إشكالية أخرى تسببها السياسات الخاطئة وهي إشكالية فقد الانتماء، فلو استطاعت الدول بسياسات سليمة ومنطقية أن تعيد روح الانتماء لدى الشباب خاصة - باعتبارهم السواد الأعظم الذي ينضم لجماعات الموت - لتغلبنا على المصدر الممول لصناعة الموت في أنحاء متعددة من العالم، وتستطيع السياسات الهادفة أن تصنع ذلك باتخاذ خطوات إجرائية في مجالات عديدة مثل: التعليم والبطالة ومكافحة الفساد، وغيرها. فغالبية الشباب في الدول العربية يشعر بالاغتراب في وطنه، خاصة إذا وجد أنه مهمش لا تعيره الدولة اهتمامه، إذا وجد أن هناك تفاوتاً طبقياً، حتى كاد يأكل القوي الضعيف، إذا وجد أنه وصل لسن الأربعين وليس لديه من المال ما يستطيع أن يكوّن به أسرة، في الوقت الذي تنفق فيه الدولة ببذخ على شكليات فارغة ومظهرية كاذبة، إذا وجد أنه إذا قال برأي لا يسمع له، بل ربما ألقى به رأيه في غياهب السجون نتيجة اختلافات في الرأي ليس إلا، ومثل هذا الجو هو الجو الذي يرتع فيه صناع الموت، ويجذبون من خلاله الشباب، ومن ثم كانت البطالة والفقر والطغيان من العوامل الرئيسة التي تتضافر بجوار العوامل الأخرى في إنتاج تربة خصبة تنبت شجرة الحقد والكراهية والتي لا نحصد منها إلا الثمار المرة، ثمار التطرف والإرهاب وصناعة الموت.
كما تحدثت الورقة عن المواقف الغربية شريكة في صناعة الموت، وقالت إن المتأمل في المواقف الغربية يجد كيف حولت الدول الغنية في أوروبا وأمريكا القيم إلى سلعة رخيصة تباع وتشترى، وأهم هذه القيم قيمة العدل؛ فالعدل الأساس القوي الذي تقوم عليه الدول وتشيد من خلاله الممالك، كما أنه القيمة المحورية التي تنشر بذور الحب والإخاء والتعاون والتواد، إلا أن هذه القيمة أصبح وجودها نادراً، في عالم استباح لنفسه كل شيء ولم يترك للضعفاء شيئاً، وهذا حتماً يؤدي بدوره إلى إحداث حالة من الكراهية والحنق وهي الحالة التي قد تتطور إلى العنف والعنف المضاد، مما يمكّن أصحاب الأجندات الهدامة من استغلال هذه الحالة في إثارة القلائل والفتن واللجوء إلى التفسيرات الخاطئة للنصوص المقدسة، ثم تجعل من هذه التفسيرات مرجعية لها، فيحدث الصدام والصراع لا التلاقي والوئام، وعليه فإن الغرب بممارساته يعد عاملاً رئيساً في صناعة الموت.
فإذا كانت أمريكا تقف ولا زالت بجوار الكيان الصهيوني، وتشجع ممارساته وتبارك خطواته، وتغض الطرف عما يفعله من جرائم في حق الإنسانية، فله أن يقتل من الفلسطينيين من شاء ويدمر من القرى ما شاء ويحاصر المدن وقتما شاء، في الوقت الذي تصم فيه أمريكا والغرب آذانهم، ويرتضى كل منهم أن يكون مجرد أداة في يد الجاني يبطش بها كيفما شاء، ثم إذا دافع الفلسطينيون عن أنفسهم وديارهم ووطنهم نعتوا بكل نقيصة، وتمثل تلك القضية الحد الفاصل في العلاقة بين الغرب والشرق، ومن ثم تستغل من قبل البعض كأحد المداخل الأساسية في السير نحو التطرف، ومن ثم صناعة الموت.
وانتهى الكاتب إلى أن صناعة الموت هي صناعة من يتمسحون بالدين، ويجعلونه أداة لتبرير قتل المخالف بدعوى الحق المقدس، مع أن القتل في الإسلام من أشد الذنوب. ولو تأملنا النصوص الدينية سواء أكانت الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية لتأكد لنا أن مصطلح الجهاد الذي يتخذه البعض لإباحة الدماء وإزهاق الأرواح فهم خطأ عند الجماعات الدينية المتشددة؛ لأن النصوص لم تبح الدخول في قتال مع الغير إلا لرد العدوان أو نصرة للمظلوم أو نقد العهود، ولا يكون القتال في هذ الأمور مباشرة، وإنما يتم الدخول في بعض المفاوضات السلمية قبلاً، أي أن مرحلة القتال تسبقها مرحلة أخرى تحاول وضع حلول لأسباب القتال قبل أن يقع، فتسيل الدماء.
ويعتبر مفهوم الجهاد من المفاهيم التي تحتاج إلى أن نعيد دراستها دراسة من داخل بنية النص القرآني، لكي يتكشف لنا المدلول الحقيقي الذي يعبر عنه بعيداً عن أي تفسير خاطئ يحيط به، يشوه الدين، ويلقي الرعب في قلوب البشرية التي ما جاء الدين إلا لكي ينقلها من سفه الوحشية إلى ميادين التسامح الإنساني، لكونه السبيل إلى إشاعة روح السلم التي حث عليها الإسلام وجعلها ركناً رئيساً لا تستقيم الحياة إلا به. وحينها نكتشف خطأ من يحصر مدلول الجهاد في جانبه الحسي فقط، وهو القتال ضد الأعداء.
وإذن – بحسب الكاتب- فإن هذا الجانب يشغل وجوده في القرآن والإسلام عامة حيزاً قليلاً للغاية بالنظر إلى ألوان أخرى من الجهاد يغفل عنها الكثيرون ممن ينصبون أنفسهم مدافعين عن هذا الدين، فهناك الجهاد العقلي أو النفسي - وهو الذي يسبق الجهاد الحسي - ومن أشكاله: جهاد الرأي، جهاد الهوى والنفس، جهاد الظلم والاستبداد وغيرها، بل إن المتأمل لأنواع الجهاد في الإسلام يجدها تنحصر في ثلاثة ألوان عامة، هي: مجاهدة العدو الظاهر، مجاهدة الشيطان، مجاهدة النفس، وهذا دليل على اتساع ألوان الجهاد ومدلولاته التي لا تقف عند مجرد اللون أو الشكل الأول، الذي تكشف آيات القرآن الكريم عن أنه في إطار الدفاع عن النفس، دون المبادرة بالاعتداء على الغير المخالف في العقيدة.