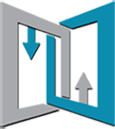ندوة: القلق الأوروبي من ملف عودة المقاتلين وأسرهم
السبت 01/أكتوبر/2022 - 08:31 م
طباعة

قضية إعادة المواطنين الأوروبيين الذين انضموا إلى داعش تظل تثير نقاشًا سياسيًا ساخنًا في الأوساط الأوروبية. رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنهاء “خلافة” داعش في مارس 2019، وفي حين كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي سبّاقة في استعادة مواطنيها من مخيم الهول، والمخيمات الأخرى في سوريا التي تديرها ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية، فقد عارضت بعض الدول علنًا، لا سيّما فرنسا، هذا النهج.
وفي الآونة الأخيرة، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من فرنسا إعادة النظر في قرارها بعدم إعادة امرأتين سافرتا إلى سوريا والعراق في عامي 2014 و2015 للانضمام إلى تنظيم داعش، حيث أنجبتا ثلاثة أطفال. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها أحيطت علمًا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإنها مستعدة لاستئناف عمليات الإعادة إلى الوطن “متى سمحت الظروف بذلك“.
حول هذا الموضوع استضاف موقع “عين أوروبية على التطرف”، ندوته الخامسة عشرة الافتراضية والتي ناقش فيها التعاطي الأوروبي مع ملف إعادة المقاتلين الأجانب الارهابيين من أوروبا وأسرهم إلى ديارهم من عدمه، مع التركيز على أعضاء تنظيم داعش الموجودين في المخيمات في سوريا.
ولمناقشة هذه القضية استضاف الموقع عددًا من الخبراء، وهم:
أبيجيل ثورلي، باحثة في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، هولندا.
ليام دافي، باحث ومتحدث ومدرب في مجال مكافحة الإرهاب، مقيم في لندن.
شارون ويل، أستاذة في القانون الدولي، الجامعة الأمريكية في باريس، وباحثة في مركز الدراسات السياسية في باريس.
صوفيا كولر، محللة أبحاث في مشروع مكافحة التطرف، ألمانيا.
استهلت أبيجيل ثورلي حديثها بالإشارة إلى أن الظروف المريعة في المخيمات معروفة للمتخصصين ووسائل الإعلام منذ سنوات عديدة. وقد اتخذت بعض الدول نهجًا استباقيًا في الإعادة إلى الوطن، خاصة كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان في آسيا الوسطى، وفي أوروبا كانت كوسوفو في المقدمة، ثم تلتها ألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا والسويد، ثم انضمت إليها مؤخرًا فرنسا عقب التوبيخ الأخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضحت ثورلي أن الكثير من القضايا التي تناولها قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأخير تتعلق بمبدأ “السيطرة الفعلية”: عادة ما ينطبق هذا المبدأ على المناطق الخاضعة لسيادة الدولة، ولكن هناك حالات تنطبق فيها المسؤوليات خارج الحدود الإقليمية، بشكلٍ عام حيث يمكن للدول دعم حقوق الإنسان للفرد، أو تثبت قدرتها على القيام بذلك، على سبيل المثال، عن طريق إعادة مواطنين آخرين إلى أوطانهم.
ومع ذلك، ترى ثورلي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ظلَّت في الأساس “على الحياد” من خلال الحكم بأنه لا قدرة فرنسا المادية على الإعادة إلى الوطن، ولا حقيقة أن سكان المخيم يحملون الجنسية الفرنسية، تفرض التزامًا على فرنسا بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم.
وبشأن مسألة ما إذا كانت الجنسية تعطي حقًا هؤلاء الأشخاص الحقَّ في دخول فرنسا، تهرّبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من التقرير فيها أيضًا، وفعلت ذلك بطريقةٍ غامضة عمدًا لتجنب أن يكون لها تأثير مخيف على العمليات الإنسانية، أي أنه لو اتخذت المحكمة موقفًا أكثر حزمًا، لكانت قد خلقت وضعًا تظهر فيه أن قدرة العمليات الإنسانية على إخراج الأطفال من المخيمات تعني القدرة على إعادتهم إلى الوطن، وبالتالي تفرض التزامًا بإعادة جميع المواطنين في المخيمات إلى أوطانهم، ما يوفِّر هيكلًا تحفيزيًا للدول لعدم القيام بأي شيء على الإطلاق لتجنب مسؤولية هذا الالتزام الأكبر.
فيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وافقت شارون ويل على أنه لا يمثل أهمية كبيرة: ذلك أن الحجة القائلة بأن فرنسا مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان لمواطنيها في سوريا -لأن لدى باريس القدرة الفعلية على وقف هذه الانتهاكات ولم تفعل ذلك- قد رُفضت. وهذا نمطٌ عام، لأن تطبيق الالتزامات خارج الحدود الإقليمية يفتح باب “مشكلاتٍ لا حصر لها” بشأن الولاية القضائية.
وشدَّدت ويل على أن الحجة الثانية كانت الأكثر أهمية، وهي أنه لا يمكن حرمان المواطنين من الحق في دخول الدولة التي هم من رعاياها، وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الواقع إنه “قد” يكون على فرنسا التزامٌ إيجابي في هذا الصدد، وينبغي أن تنظر فيه، لكنها تركت القرار النهائي للحكومة الفرنسية.
ومع ذلك، تعتبر ويل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “إشارة قوية جدًا” إلى فرنسا بأنه ينبغي لها استعادة مواطنيها القُصّر من سوريا، وبالتأكيد ينبغي أن تكون أكثر شفافية في شرح سبب عدم قيامها بذلك، لأن الظروف الحالية تثير شكوكًا قانونية وغير ديمقراطية.
تتفق صوفيا كولر على أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان له تأثيرٌ “محدود”، وركزت حديثها على ألمانيا. في هذا الصدد، قالت إن الألمان بصدد إعادة مواطنيهم منذ بعض الوقت، ومن المرجح أن يكملوا العملية هذا العام، ما يجعل القرار أقل أهمية بالنسبة لهم.
لا تزال هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تواجه ألمانيا صعوبة في التعامل معها، خاصة ما يجب فعله إزاء أولئك الذين لا يريدون العودة إلى وطنهم، وأولئك الذين لديهم نوع من الروابط بألمانيا، ولكن ليس لديهم الجنسية. المسؤولية الأمنية والإنسانية التي تقع على عاتق الدولة الألمانية تجاه هؤلاء الأشخاص لا تزال قيد الدراسة.
يرى ليام دافي أن النهج الذي يشدِّد على أن الجهاديين يجب أن “يواجهوا العدالة في الداخل”، وبما أنهم “مسؤوليتنا، يجب أن يكونوا مشكلتنا”، يجب أن يأخذ في الاعتبار حقيقة، وتحديدًا في بريطانيا، أن العديد منهم لن يواجهوا العدالة إذا أعيدوا إلى الوطن.
ففي الواقع، استعانت الحكومة البريطانية بمصادر خارجية لمحاكمة ألكسندا كوتي، والشافعي الشيخ، وهما عضوان في خلية “البيتلز” التابعة لداعش، ومسؤولان عن تعذيب وقتل الرهائن، وشاهدهما عشرات الأشخاص أثناء قيامهما بذلك، لأن النيابة العامة البريطانية لم تكن متأكدة من أنها ستتمكن من إدانتهما، وكان من الأسهل ترك الأمر للأمريكيين. هذا اتهام للنُظم القانونية الأوروبية، ولكن يجب أن يتشكّل هذا النقاش أيضًا من خلال إقناع الناس بماهية المقايضات الحقيقية: القتلة سوف يسيرون بحرية في الشوارع الأوروبية لأن هناك ما يصفه دافي بأنه “ثقب أسود” لسنواتٍ عدة في حياة العديد من هؤلاء الناس، وحتى عندما يتقدم شهود مثل الإيزيديين للإبلاغ عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها أشخاص يقيمون الآن في ألمانيا، وفي أماكن أخرى، ليس هناك ما يضمن أن هذا سوف يستمر.
في حين أن بعض الدول، مثل بريطانيا، تواجه عقباتٍ قانونية في التعامل مع العائدين من داعش، قالت شارون ويل إن فرنسا في وضع أفضل: فهي تقاضي الناس، وتحكم عليهم بالسجن لمددٍ طويلة، لمجرد عضويتهم في تنظيمات محظورة، بدلًا من الاضطرار إلى إثبات أن شخصًا ما شارك في عمل إجرامي محدد كجزءٍ من جماعة إرهابية. وتسمح فرنسا بهذه الملاحقات القضائية دون أي قانون حقيقي للتقادم.
العائدون وإعادة الإدماج
توضح ثورلي أن حجم هذه المشكلة يختلف من دولةٍ إلى أخرى: فهولندا لديها 60 طفلًا في المخيمات، وبلجيكا لديها من 12 إلى 17 طفلًا، والسويد من 25 إلى 30، وفرنسا لديها من 150 إلى 170.
وهذا يعني أن مدى إلحاح القضية والخيارات المتاحة تختلف اختلافًا كبيرًا، ولكن في جميع الحالات، كما تقول ثورلي، تجب معاملة الأطفال كضحايا، مع التركيز على صحتهم وسلامتهم وهويتهم، والحفاظ على الروابط الأسرية والحماية الاجتماعية والبدنية. ويمكن أن تقدم دول آسيا الوسطى وكوسوفو دروسًا مستفادة في هذا الأمر لأنها خاضت تجربة الإعادة إلى الوطن من مرحلة مبكرة.
من جهتها، تشير كولر إلى أن الحكومة الألمانية تقر بأن عليها التزاماتٍ إنسانية بإعادة الأطفال إلى أوطانهم، ولكن هذا لا يعتبر التزامًا عامًا: فالأطفال المرضى والأيتام هم أولئك الذين ينطبق عليهم ذلك، أما الأطفال في مخيم روج -الذي يُدار بشكلٍ أفضل، ويعتبر أفضل من الناحية الصحية من مخيم الهول- فلا يُعتبرون أولوية، على الرغم من أن هناك بعض الحالات الفردية، حيث كسبت بعض الأسر معارك قضائية تطالب باستعادة أحفادها، ونفَّذت برلين هذه القرارات القانونية.
إضافة إلى ذلك، سلّطت كولر الضوء على أن ألمانيا عملت أيضًا بموجب قاعدة قانونية قوية مفادها أنه لا يمكن فصل الأطفال عن أمهاتهم، وهو ما ينطبق على الكثير من دول الاتحاد الأوروبي. لكن معظم دول الاتحاد الأوروبي تفسر هذا على أنه يجب ترك الأطفال في المخيمات مع أمهاتهم. أما بالنسبة لألمانيا، كان ذلك يعني إعادة النساء إلى الوطن مع الأطفال. وهذا بدوره جعل ألمانيا المركز الرئيس لشيءٍ استثنائي للغاية في أوروبا: مقاضاة عضوات داعش، بشكلٍ عام بسبب الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية أو الجرائم التي ترقى لذلك ضد الإيزيديين. وتجدر الإشارة إلى أن الملاحقات القضائية لعضوات داعش تفوق نظيرتها للذكور في ألمانيا منذ عام 2018.
وبينما تمضي ألمانيا قدمًا في خططها لإعادة إدماج العائدين، تقول كولر إن المساءلة يجب أن تشكّل عنصرًا رئيسًا من هذه الخطط: فمحاكمة الأشخاص ومعاقبتهم على الإرهاب والإبادة الجماعية تُعتبر جزءًا مهمًا من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى المجتمع. وحتى الآن، قادت ألمانيا فرض عقوباتٍ قانونية على أعضاء داعش. الجانب السلبي الرئيس هو أن ألمانيا لا تصدر على هؤلاء الأشخاص سوى أحكام سجنٍ قصيرةٍ، تاركةً مسألة الفعالية مفتوحة، وهي مشكلة توجد لدى جميع الدول الأخرى، ومن المحتمل أن تتسبَّب في مشكلاتٍ أخرى، تتمثل في انتشار عدوى التطرف بين نزلاء السجون.
لم يبد دافي خلافًا يُذكر بشأن الأطفال العائدين، ولكن فيما يتعلق بالبالغين، يرى أنه يوجد حتى الآن ميل مزعج لأن يكون الخطاب “غير جاد”: فهؤلاء الأشخاص يُقدمون إما كضحايا -أي لم يكن لديهم أي إرادة في قرار الانضمام إلى خلافة إرهابية- أو يجري تحويلهم إلى نجوم، والظهور في وسائل الإعلام، وعقد صفقات الكتب، ما يقلِّل من شأن ما فعلوه، وما ساعدوا في حدوثه. وبالتالي، يرى دافي أنه إذا لم يكن من الممكن محاكمة العائدين قانونيًا، فيجب علينا التوصل إلى توافق اجتماعي أفضل بشأن كيفية التعامل معهم، ليس أقلها تجنّب منحهم الشهرة التي يمكن استخدامها في تطرف الآخرين.
كيف حدث هذا وماذا يعني؟
يشير دافي إلى أن حقيقة أن الآلاف من الأشخاص قد اختاروا ترك الديمقراطيات العلمانية الليبرالية للعيشِ في أراضٍ ثيوقراطية الإبادة الجماعية لم تخضع للتمحيص. وقد طرح البعض تفسيرات من قبيل: أن هذا كان نوعًا من رد الفعل العنيف على تجربة التهميش في أوروبا؛ وأن الأمر كله يتعلق بإيجاد داعش طريقة فريدة لتجنيد هؤلاء الأشخاص عبر الإنترنت، وهذا التفسير ينتشر خاصة بين بعض ممارسي مكافحة التطرف العنيف، أو أن ما حدث هو سمة متأصلة في الإسلام.
في هذا الصدد، يقترح دافي تحليل بيانات الأماكن التي جاء منها المقاتلون الأجانب لمعرفة مدى صمود هذه النظريات، لكن ما نراه هو أنه حدث في شكل تجمعات: الغالبية العظمى من مقاتلي داعش الأوروبيين جاءوا من نصف دزينة من الدول، وداخل تلك الدول لم يأتوا فقط من مدن محددة، بل من مناطق محددة وحتى من مبانٍ سكنية محددة داخل تلك المدن. هذه التجمعات ليست ما يتوقعه المرء إذا كان التهميشُ أو الإنترنت العاملين الرئيسين، نظرًا لوجودهما على نطاقٍ واسع في جميع أنحاء المجتمع، وإذا كان الإسلام هو المتغيّر الرئيس، كان ينبغي أن تتأثر المدن ذات الكثافة السكانية المسلمة الكثيفة -مثل مرسيليا وجلاسكو وبرادفورد- غير أن هذا لم يحدث.
يرى دافي أن المتغيرّ الرئيس على ما يبدو في إطلاق تدفقات المقاتلين الأجانب هو وجود قدامى المحاربين من حملات الجهاد السابقة -في أفغانستان والجزائر والبوسنة والعراق- الذين انضموا إلى داعش في فترة ما بعد عام 2013 واستخدموا شبكاتهم القديمة للحشد والتعبئة.
ويشدد دافي على أن ما شوهد في ذروة تدفق المقاتلين الأجانب في 2014-2015 “لم يكن أن داعش كان يقوم بالتطرف. بل أن الخلافة قد أظهرت مدى نمو السلفية الجهادية الأوروبية” منذ الجهاد في العراق قبل عشر سنوات، ونحن الآن في فترة “كُموْن” أخرى يتضاءل فيها الاهتمام، لكن الجهاديين يعملون على نشر رسالتهم. وهذا العمل في فترة “كُموْن” هو الذي جعل مدنًا مثل تولوز وبرمنجهام تشهد زيادةً هائلة في عدد سكانها الجهاديين بين عامي 2005 و2015.