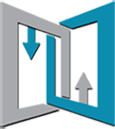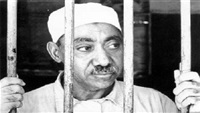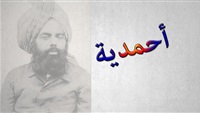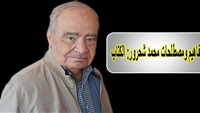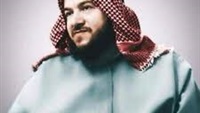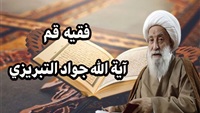من الإخوان إلى داعش: أين تبدأ الفكرة وأين ينتهي العنف؟
الأحد 11/مايو/2025 - 03:28 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
منذ صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، شكّل الخطاب العقائدي والعملياتي للتنظيم صدمة للوعي العالمي والإسلامي على حد سواء، نظرًا لما اتسم به من عنف بالغ وتطرف لا سابق له. غير أن هذا الخطاب، ورغم طابعه الخاص شديد الغلو، لم ينبثق من فراغ. بل جاء متكئًا على منظومة مفاهيمية وموروث فقهي وأيديولوجي تشترك فيه جماعات إسلامية متعددة، تتفاوت في درجة راديكاليتها وأساليبها، لكنها تتقاطع في جملة من المرتكزات النظرية التي تُستثمر — بدرجات مختلفة — في تبرير العنف أو بناء مشروع ديني-سياسي مغاير لواقع الدولة الحديثة.
ينتمي تنظيم داعش إلى الطيف الأكثر تطرفًا ضمن تيارات الإسلام السياسي والجهادي، إلا أن تقاطعاته مع جماعات مثل القاعدة، والسلفية الجهادية، وحتى بعض تيارات الإخوان المسلمين، تؤكد أن جذوره تمتد إلى أبعد من مجرد انشقاق عن تنظيم أم أو تحوّل عسكري طارئ. فالتنظيم يستبطن مفاهيم مركزية مثل "الجاهلية"، و"الولاء والبراء"، و"دار الكفر"، و"البيعة"، و"الجهاد"، وهي مفاهيم مطروحة — بدرجات مختلفة من الغلو — في أدبيات جماعات متعددة، ما يفرض مقاربة تحليلية تُبرز الاستمرارية بين هذه التيارات، لا مجرد التمايز بينها.
هذا التقاطع لا يعني التطابق، بل يفتح الباب لفهم كيفية توظيف المفاهيم الإسلامية في سياقات أيديولوجية مختلفة، وكيف يُعاد تأويل التراث الديني لتبرير مشاريع سياسية تتراوح بين الإصلاح التدريجي، كما في حالة الإخوان المسلمين، إلى المواجهة المسلحة المفتوحة، كما في حالة القاعدة وداعش. إن تتبّع هذه التقاطعات يُمكّن الباحث من تفكيك البنية الأيديولوجية المعقدة التي تقوم عليها هذه الحركات، ويكشف عن إمكانات التدرّج في التطرف الفكري لدى الأفراد والجماعات، من خطاب "النهوض بالأمة" إلى تبرير "الذبح على الهوية".
من هنا، فإن دراسة خطاب داعش، خصوصًا في نصوصه التأسيسية وأدبياته الدورية مثل صحيفة "النبأ"، لا يمكن أن تُفهم دون مقارنتها بخطابات الجماعات الإسلامية الأخرى. فتحت عناوين براقة مثل "العودة إلى الإسلام الصحيح"، أو "إقامة الدولة الإسلامية"، تتوارى شبكة معقدة من المفاهيم المتداخلة، التي قد تبدأ بدعوة إصلاحية وتنتهي بخطاب تفجيري. وتصبح المقارنة بين داعش وتلك الجماعات ليست فقط ضرورة تحليلية لفهم الظاهرة الجهادية، بل أيضًا مدخلًا نقديًا لفهم كيف تتحول الفكرة الدينية إلى أداة للعنف، عندما تُنتزع من سياقاتها الأخلاقية والتاريخية.
ونستند هنا على افتتاحية صحيفة النبأ (العدد 494) الصادرة عن تنظيم داعش الخميس 8 مايو 2025، التي تتقاطع مع خطاب جماعات إسلامية أخرى، رغم أن له طابعه الخاص المتطرف. هذا التقاطع يمكن فهمه على مستويات متعددة:
في العقيدة الجهادية والتصور القتالي
يُظهر خطاب داعش في هذه الافتتاحية تقاطعًا جوهريًا مع عقيدة تنظيم القاعدة، خاصة في اعتبار الجهاد القتالي محورًا رئيسيًا للعقيدة والتدين. كلا التنظيمين يقدّمان القتال بوصفه الوسيلة المركزية لتحقيق "التوحيد الخالص" وتطبيق الشريعة، لا كأداة دفاعية مرتبطة بظروف أو ضوابط شرعية. هذا التمركز حول "القتل في سبيل الله" يُقدَّم كطريق سريع إلى الجنة، مما يُفرغ مفهوم الجهاد من أبعاده الأخلاقية والقانونية في الفقه الإسلامي، ويجعله مسارًا حتميًا لكل "مؤمن حقيقي".
ما يجمع داعش والقاعدة أيضًا هو الخطاب الذي يمجّد الموت بوصفه "فوزًا" لا خسارة، و"كرامة" لا كارثة. في هذا السياق، لا يُصوَّر القتل بوصفه ضرورة اضطرارية أو فعلًا استثنائيًا، بل كغاية في حد ذاته، بل يُحتفى بالموت الانتحاري والتفجيري كأرقى درجات القرب من الله. غير أن داعش يذهب إلى مدى أبعد، إذ لا يكتفي بتبرير العنف ضد "العدو الكافر"، بل يشرّع استباحة دماء المسلمين المخالفين من تيارات أخرى، أو حتى من جمهور المسلمين، تحت ذرائع التكفير والتصنيف العقائدي.
يتقاطع هذا الخطاب كذلك مع ما تبنّته بعض فصائل "السلفية الجهادية" مثل "جبهة النصرة" في مراحلها الأولى، عندما كانت مرتبطة تنظيميًا وفكريًا بالقاعدة. في تلك المرحلة، كان الربط بين مفهومي "الولاء والبراء" و"القتال" حاضرًا بقوة، بما يجعل الاصطفاف العقائدي مقرونًا بالانخراط في العنف المسلح. كما كانت النصرة تستخدم اللغة نفسها في تصوير القتل بوصفه تطهرًا روحيًا، وتقدّم "الموت في المعركة" كعلامة على الصفاء العقدي، لا كخيار سياسي أو عسكري محدد بسياقات معينة.
يُظهر هذا النمط من الخطاب تحوّلًا جذريًا في العقيدة الجهادية، من تصوّر القتال كوسيلة للدفاع عن النفس أو عن الأمة، إلى اعتباره فعلًا تعبديًا في حد ذاته، أقرب إلى "طقس ديني" يقوم به المؤمن تقربًا إلى الله. هذا التحول يرفع من شأن العنف المسلح ليجعله التجلي الأعلى للتدين، وهو ما يتشاركه داعش والقاعدة وبعض فصائل السلفية الجهادية. غير أن الفارق الجوهري يبقى في أن داعش يذهب بهذا المنطق إلى أقصاه، حيث تتحول الحياة كلها إلى مسرح قتال، ويُلغى أي اعتبار للواقع أو للضرورات الشرعية في تحديد مشروعية القتال.
في التبجيل الانتقائي للسيرة النبوية والصحابة
يشترك خطاب تنظيم داعش مع السلفيين التقليديين في تمجيد ما يُعرف بـ"القرون المفضلة"، أي جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم، بوصفهم النموذج الأعلى لفهم الدين وتطبيقه. هذا التبجيل ينطلق من قاعدة أن أفضل فهم للإسلام هو ما كان عليه السلف الصالح، ومن هنا تُستدعى سيرهم باستمرار لتبرير المواقف الدينية أو السياسية. إلا أن السلفية التقليدية – كالسلفية المدخلية أو العلمية – تقصر الاستلهام على الجوانب العقدية والعبادية، وتحرص على ضبط الممارسات السياسية والقتالية تحت مظلة "الإمام الشرعي"، رافضة أي خروج مسلح لا تقره السلطة القائمة.
على النقيض من هذا الحذر، يعتمد خطاب داعش على قراءة انتقائية للتاريخ الإسلامي، يُبَجِّل فيها مشاهد الغزو والقتال فقط من السيرة النبوية، ويُهمِّش الجوانب التشريعية والمؤسسية التي أسست لدولة ومجتمع. تُستدعى معارك مثل بدر وأحد بلا سياقها التاريخي أو ضوابطها الفقهية، لتُوظف كحجج مباشرة لتبرير التفجيرات والانتحار والقتل الجماعي. فالسيرة هنا لا تُقرأ بوصفها تجربة بشرية معقدة فيها السلم والحرب، وإنما تُحوَّل إلى ترسانة من "الوقائع البطولية" التي تخدم خطاب العنف المطلق.
من جهتها، تحتفظ جماعة الإخوان المسلمين بموقف مختلف نوعًا ما، فهي كذلك تمجّد الصحابة وتجعل السيرة النبوية مرجعية، لكنها توظفها في خطاب "نضالي إصلاحي" أكثر منه قتالياً مباشراً. الجهاد لدى الإخوان لا يُفهم بوصفه ممارسة تعبدية للقتل، بل كأداة في معركة سياسية ضد "الاستعمار"، أو في سبيل "التمكين" وإقامة دولة إسلامية. الخطاب هنا أقل دموية، وأكثر التفافًا حول مفاهيم مثل الحاكمية والنهضة والمظلومية، مما يجعل الجهاد جزءًا من مشروع أوسع لا يرتكز على القتال المسلح بحد ذاته، بل يُخضعه لأجندة مرحلية وتنظيمية.
رغم الفروق الكبيرة في الوسائل والمآلات، يبقى القاسم المشترك بين هذه التيارات هو التقديس غير النقدي لتجربة الصحابة والسلف، بوصفها العصر الذهبي المطلق، والمرجعية التي لا يُعلو فوقها شيء. لكن الاختلاف يكمن في طريقة توظيف هذا التقديس: السلفية التقليدية توظفه لضبط السلوك الديني ورفض التمرد، الجهادية توظفه لتأبيد القتال والقتل، بينما الإخوان يستخدمونه لبناء سردية سياسية "نهضوية" ترى في تلك الفترة نموذجًا للدولة الإسلامية المنشودة. وهنا تكمن خطورة القراءة غير التاريخية للسيرة، إذ تتحول من مرجعية روحية إلى مبرر أيديولوجي متعدد الاستخدامات.
في ثنائية "دار الإسلام ودار الكفر"
تعد ثنائية "دار الإسلام ودار الكفر" من الركائز الأساسية في الفكر الجهادي، حيث يتم تقسيم العالم إلى معسكرين متعارضين: المعسكر الإسلامي الذي يطبِّق الشريعة ويعيش في "دار الإسلام"، مقابل المعسكر غير الإسلامي الذي يقع في "دار الكفر". هذا التقسيم نجد جذوره في العديد من الجماعات الجهادية القديمة والمعاصرة، مثل جماعة الهجرة والتكفير التي ظهرت في السبعينيات، وبعض فصائل السلفية الجهادية التي ترى أن أي دولة أو مجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية هو بالضرورة "دار كفر". هذه النظرة تؤدي إلى تجزئة العالم، وإعطاء مبرر ديني لرفض أي تعايش مع الأنظمة التي لا تطبق الشريعة.
أجنحة السلفية الجهادية المعاصرة، مثل تنظيم القاعدة، تعتمد هذا التقسيم أيضًا وتعتبر أن المجتمعات التي لا تسير على نهجها الجهادي هي جزء من "دار الكفر". هذا الموقف يجعل من الصعب التوصل إلى حلول سلمية أو توافقات مع هذه المجتمعات، حيث تُعتبر هذه المجتمعات "عدوًا" يجب محاربته، ويُبرر استخدام العنف ضدها. ويرتبط هذا الفكر بتصورات الجهاد العالمي الذي يدعو إلى مواجهة "الكفار" أينما كانوا، بناءً على التقسيم الذي يجعل أي مجتمع غير خاضع لسلطة الإسلام الجهادي بمثابة "دار الكفر" التي يجب أن تُحارب.
رغم أن الإخوان المسلمين لا يعبرون صراحة عن تبنيهم لتقسيم "دار الإسلام ودار الكفر"، إلا أن بعض أدبياتهم القديمة تشير إلى رؤية مشابهة. سيد قطب، في كتابه معالم في الطريق، تحدث عن "جاهلية العصر" واعتبر المجتمعات التي لا تطبق الشريعة الإسلامية بأنها في حالة من الجهل أو الضلال، مما يخلق نوعًا من التفريق بين "المؤمنين" في الجماعة و"الجاهلين" في المجتمع. هذه الرؤية قد تكون أقل عنفًا في أدبيات الإخوان مقارنة بجماعات السلفية الجهادية، لكنها تفتح الباب لاحقًا لتوظيف نفس المفهوم في سياقات عنفية، كما في مرحلة لاحقة من تطور الفكر الإخواني التي قد تتبنى تكتيكات أكثر تشددًا.
تتجلى مشكلة هذا الفكر في إمكانية استخدامه لتبرير العنف والتمرد ضد الأنظمة القائمة، سواء كان ذلك في سياق الجماعات الجهادية أو حتى في التيارات الإسلامية ذات التوجهات الإصلاحية. على الرغم من أن الإخوان المسلمين في فترات معينة كانوا يبتعدون عن التصريح بشكل مباشر عن "دار الكفر"، إلا أن أدبيات قطب قد تُستخدم لتبرير فرض العنف في حالة الصراع مع الأنظمة الحاكمة التي لا تطبق الشريعة. هذا التوظيف يجعل من الفكر الإسلاموي نقطة انطلاق للتشدد، حيث يتم تفسير الواقع من خلال رؤية دينية تقسم العالم إلى فسطاطين، مما يسهل انتقال الأفراد من الفكر الإصلاحي إلى الفكر المتطرف.
في مفاهيم البيعـة والتضحية
يُشكّل مفهوم البيعة إحدى الركائز الرمزية والتنظيمية في خطاب الجماعات الإسلامية عمومًا، حيث يُنظر إليها كعقد ديني وسياسي في آنٍ معًا. يتقاطع خطاب داعش في هذا الشأن ظاهريًا مع ما نجده عند جماعة الإخوان المسلمين وبعض الطرق الصوفية الجهادية، إذ يُقدَّم الانتماء إلى الجماعة أو التنظيم بوصفه بيعة لله ثم لرسوله، ثم للقيادة أو الأمير. هذه البيعة تُقدَّم كعهد شرعي يُلزم المنتسب بالطاعة والولاء والانقياد الكامل، ما يمنح التنظيم سلطة دينية مطلقة على الفرد.
في حالة تنظيم داعش، تتجاوز البيعة البُعد الرمزي والتنظيمي لتتحول إلى بيعة موت. فهي ليست تعبيرًا عن الالتزام بالتدرج أو العمل السياسي، بل تُقدَّم باعتبارها التزامًا بتنفيذ العمليات الانتحارية، وخوض المعارك حتى النهاية دون رجوع، تحت شعار "بيع النفس لله". البيعة هنا ليست فقط عهد ولاء، بل عقد فداء يتضمن استعدادًا فعليًا للموت، حيث يصبح الانتحار أو "الاستشهاد" هو الترجمة القصوى للوفاء بالبيعة. وهذا ما يجعلها أداة شديدة الفاعلية في حشد الأفراد نحو العنف، وتفجير طاقاتهم النفسية والروحية في اتجاه واحد: القتال حتى الموت.
أما في الحالة الإخوانية، فالبيعة تأخذ طابعًا أكثر تنظيمية وبُعدًا عن الطابع الاستشهادي المباشر. فهي تُقدَّم كعهد طويل النفس، مرتبط بمنهجية "التدرج في التمكين"، حيث تُوظَّف في إطار هرم تنظيمي دقيق، يعزز الانضباط والبناء الداخلي للجماعة. البيعة في هذا السياق تمثّل رابطة عضوية، لكنها لا تتطلب بالضرورة التضحية الفورية بالنفس، بل تنصرف إلى أشكال مختلفة من الالتزام الدعوي، التربوي، والنضالي السياسي الذي يمتد عبر مراحل طويلة.
الفرق الجوهري بين الخطابين يكمن في وظيفة البيعة وأثرها النفسي والتعبوي. فبينما تُمثّل عند الإخوان وسيلة تنظيمية لبناء شبكة ممتدة ومرنة من الأفراد الملتزمين، تتحول عند داعش إلى أداة اختزال وجودي تختصر الحياة في لحظة موت "مجيدة". بهذا المعنى، فإن داعش تُفرغ البيعة من محتواها التربوي أو السياسي، وتحولها إلى تعبير مطلق عن الاستعداد للفناء، بينما يبقيها الإخوان ضمن استراتيجية تنظيمية تستهدف التغلغل المجتمعي والسياسي دون تصعيد مباشر في كل المراحل.
في نفي مشروعية "الواقع" ورفض القعود
يقوم الخطاب الجهادي في عمقه على نفي مشروعية الواقع القائم، سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتقديمه بوصفه انحرافًا جذريًا عن "الحق الإلهي". لا يُنظر إلى هذا الواقع كحيّز يمكن إصلاحه أو تطويره، بل كبيئة فاسدة بالكامل، تستوجب المواجهة والقطيعة. هذا المنظور يشكّل القاعدة النفسية الأولى لتحفيز القتال، حيث يصبح التمرّد على المجتمع والدولة واجبًا دينيًا، لا مجرد خيار سياسي.
تتجلى ملامح هذا النفي للواقع بوضوح في فكر سيد قطب، لا سيما في كتابه معالم في الطريق، حيث يُصنّف المجتمعات الإسلامية المعاصرة ضمن "الجاهلية الحديثة"، بسبب تعطيلها لحاكمية الله واتباعها "شرائع بشرية". هذا الطرح يلتقي مع أفكار أبو الأعلى المودودي، الذي فرّق بين "الإسلام الحقيقي" وبين "الحضارة الغربية الجاهلية"، معتبرًا أن الأخيرة قامت على فصل الدين عن الحياة، وبالتالي فهي فاسدة من الجذور. كلا المفكرين قدّما أرضية أيديولوجية لرفض الواقع ومواجهته باسم "إعادة الإسلام إلى الحكم والمجتمع".
اللافت أن هذا الموقف لا يقتصر على التيارات الجهادية فقط، بل يمتد بشكل ما إلى بعض الحركات الإصلاحية التي تصنّف نفسها كمعتدلة. حتى هذه الحركات، وإن لم تتبنَّ العنف، تتحدث عن "الواقع المنحرف" و"الحياة المادية الفارغة" و"التبعية للغرب"، وتدعو إلى تغييره واستعادته إلى "جادة الصواب". الفرق هو في الوسائل، لا في التوصيف العام للواقع، ما يجعل خطابها في بعض الأحيان أرضًا خصبة لانتقال الأفراد إلى مواقف أكثر تطرفًا، حين تغيب المسافة النقدية بين الدعوي والسياسي، أو بين الإصلاح والمواجهة.
في هذا السياق، يُقدَّم القعود – أي عدم الانخراط في مشروع التغيير الجذري – على أنه خيانة أو تواطؤ مع "الجاهلية"، وليس مجرد موقف سياسي أو اجتهادي. يُصوَّر القاعدون على أنهم باعوا أنفسهم للدنيا، ورضوا بالذل والانحراف، بينما المجاهدون هم وحدهم من اختاروا "الحق"، مهما كان الثمن. هذه الثنائية تغلق الباب أمام التفكير النقدي أو التنوع في الرؤى، وتحوّل الخيار الفردي إلى موقف وجودي أخلاقي، إما أن تكون مع "الفرقة الناجية"، أو مع "المجتمع الضال".
اخيرا
يُظهر خطاب داعش تقاطعات فكرية واضحة مع جماعات إسلامية متعددة، سواء في الرؤية الجهادية الصريحة، أو في الأدبيات التي تقدّم الجهاد كطريق للخلاص، أو حتى في البنية الوجدانية للخطاب الديني التي تمجّد الموت وتُهوّن من شأن الحياة. هذه التقاطعات لا تعني تطابقًا، لكنها تكشف عن بنية مرجعية مشتركة، غالبًا ما تُبنى على تأويلات حماسية للنصوص، وتقديم نماذج مثالية من السلف تُجرد من تعقيداتها التاريخية لصالح غايات دعائية أو تنظيمية.
الاختلاف الجوهري بين داعش وهذه الجماعات الأخرى يكمن في درجة التطرّف. إذ تذهب داعش إلى أقصى مدى في إعادة تأويل النصوص الدينية لتقديس القتل، ليس باعتباره ضرورة أو خيارًا دفاعيًا مشروطًا، بل كغاية في ذاته، وكطريق أوحد "للفوز الأخروي". هذا الانقلاب في وظيفة الجهاد من وسيلة إلى غاية، يفرغ الحياة من معناها، ويقدّم الموت لا كخسارة مأساوية، بل كذروة للنجاح الديني والبطولة الفردية.
ما يجعل خطاب داعش أكثر خطورة هو أنه لا يُنتَج في فراغ، بل ينهل من التراث الديني السائد، ومن خطابات منتشرة في المجال الإسلامي، حتى داخل تيارات توصف بالاعتدال. إذ يقوم التنظيم بتجميع نصوص، أو شعارات، أو تأويلات جزئية من هنا وهناك، ثم يعيد صوغها ضمن منظومة متكاملة من العنف المطلق. وهذا ما يمنح الخطاب "شرعية شكلية" يصعب على المتلقي غير المختص تفكيكها، ويمنح المجند المحتمل شعورًا زائفًا بالتماهي مع الإسلام الأصيل.
لذلك، فإن التعامل مع خطاب داعش لا يكفي أن ينحصر في تفنيد ممارساته أو كشف وحشيته؛ بل يتطلب بالضرورة نقد البنية المرجعية التي يستند إليها، سواء في فهم النصوص، أو في تبجيل التاريخ، أو في تصوير الواقع. فطالما بقي هذا المخزون التراثي قابلاً للاقتطاع والتوظيف بمعزل عن شروطه وسياقاته، فإن أي "داعشي جديد" سيجد دائمًا المادة الأولية التي يحتاجها لصياغة أيديولوجيا دموية، تُقنِع وتُعبّئ وتُفجِّر.