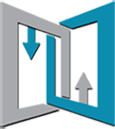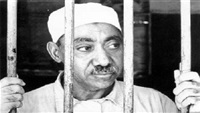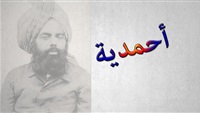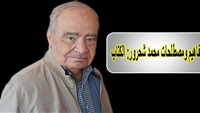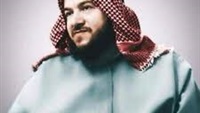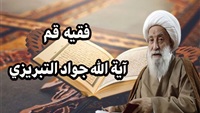الحرب على الإرهاب: الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق وتداعياته
 روبير الفارس وعلي رجب
روبير الفارس وعلي رجب
تمثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 نقطة
تحول جذرية في التاريخ المعاصر، حيث غيرت مجرى السياسة الخارجية الأمريكية والنظام
الدولي بشكل جوهري. فبعد سقوط برجي التجارة العالمي واستهداف البنتاغون، أعلنت
الولايات المتحدة الأمريكية "الحرب على الإرهاب"، والتي شكلت غطاء
استراتيجيا لسلسلة من التدخلات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتقدر مراكز الدراسات التكلفة المالية للحروب
على الولايات المتحدة وحدها التي شنتها إدارة بوش في سبتمبر/أيلول 2001 - والتي
شملت في البداية أفغانستان والعراق، ثم اليمن وباكستان ومناطق أخرى نحو 4.8
تريليون دولار على الأقل حتى الآن؛ وتقدر مدفوعات الفائدة التراكمية الإضافية
المستقبلية على المخصصات السابقة في الفترة 2001-2013 بنحو 8 تريليونات دولار أخرى
بحلول عام 2053، ويتجاوز هذا تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية في مارس/آذار 2019،
والتي أشارت إلى أن متوسط تكلفة الحرب في العراق وأفغانستان وسوريا مجتمعة بلغ
7623 دولارا لكل دافع ضرائب (2019).
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، خصص الكونجرس
حوالي 70 مليار دولار لحروب ما بعد 11 سبتمبر/أيلول كجزء من قانون تفويض الدفاع
الوطني البالغ 738 مليار دولار، مع أن البنتاغون طلب في الأصل أقل من 10 مليارات
دولار من هذا المبلغ لعملية العزم الصلب في العراق وسوريا (ديفينس ون، 4
فبراير/شباط 2020).
ونتيجة لذلك، ارتفع الدين الأمريكي الناتج عن الإنفاق المباشر المرتبط بالحرب، ليصل إلى تريليوني دولار منذ بداية الحرب العالمية على الإرهاب، متراكما مبلغ 925 مليار دولار من مدفوعات الفوائد (بيلتييه، 2020: 1). وحتى لو توقفت التدخلات العسكرية فورا، ستستمر مدفوعات الفوائد في الارتفاع، لتصل، وفقا لتقديرات بيلتييه، إلى أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تريليوني دولار الحاليين و6.5 تريليون دولار بحلول عام 2050. يذكر أن حوالي 40% من حروب ما بعد 11 سبتمبر قد مولت بالاقتراض الخارجي (المرجع نفسه).
الخلفية الفكرية للحرب على الإرهاب
لعبت تيارات المحافظين الجدد دورا محوريا في
صياغة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد أحداث سبتمبر. هذا التيار الفكري، الذي
كان يضم شخصيات مؤثرة مثل بول وولفويتز نائب وزير الدفاع، ودونالد رامسفيلد وزير
الدفاع، وديك تشيني نائب الرئيس، وجد في أحداث سبتمبر الفرصة المناسبة لتطبيق
رؤيته الاستراتيجية.
كان هؤلاء المحافظون الجدد قد دعوا إلى تغيير
النظام في العراق منذ التسعينيات من خلال "مشروع القرن الأمريكي الجديد" (PNAC)، الذي أرسل رسالة مفتوحة
إلى الرئيس كلينتون عام 1998 تطالب بإزالة صدام حسين من السلطة. وعندما وصل جورج
دبليو بوش إلى السلطة، وجد هؤلاء المحافظون الجدد أنفسهم في مناصب مؤثرة تمكنهم من
تحويل أفكارهم النظرية إلى سياسات عملية.
عقيدة بوش والحرب الاستباقية
تبلورت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في
وثيقة "الاستراتيجية الأمنية القومية للولايات المتحدة" التي صدرت في 17
سبتمبر 2002. هذه الوثيقة، المعروفة باسم "عقيدة بوش"، أرست مبدأ الحرب
الاستباقية كركيزة أساسية للأمن القومي الأمريكي.
تنص العقيدة على أن "الولايات المتحدة
ستتصرف، إذا لزم الأمر، بشكل استباقي" لمواجهة التهديدات قبل أن تصبح مكتملة
التكوين. وقد وسعت هذه العقيدة مفهوم الحرب الاستباقية ليشمل الحرب الوقائية، حيث
يمكن استخدام القوة حتى في غياب دليل واضح على هجوم وشيك.
وبعد أحداث سبتمبر بوقت قصير، طالب الرئيس بوش
حكومة طالبان بتسليم أسامة بن لادن وقيادات تنظيم القاعدة، إضافة إلى إغلاق
معسكرات التدريب الإرهابية في أفغانستان. عندما رفضت طالبان هذه المطالب ما لم
تقدم أدلة قاطعة على تورط بن لادن في الهجمات، قررت الولايات المتحدة اللجوء إلى
القوة العسكرية.
وفي 7 أكتوبر 2001، أطلقت الولايات المتحدة
وحلفاؤها "عملية الحرية الدائمة" (Operation Enduring
Freedom) بضربات جوية استهدفت مواقع طالبان
والقاعدة في أفغانستان. شارك في هذا التحالف 51 دولة، بما في ذلك دول حلف شمال
الأطلسي والمملكة المتحدة وكندا والتي استمرت عقدين كاملين وكلفت العالم ثمنا
باهظا على جميع الأصعدة. تعد هذه الحرب من أطول الصراعات في التاريخ الأمريكي
وأكثرها إثارة للجدل، حيث تجاوزت تكلفتها 8 تريليونات دولار وأسفرت عن مقتل أكثر
من 900 ألف شخص.
لكن تحليل الأهداف الحقيقية وراء هذه الحروب،
إلى جانب دراسة التداعيات الإنسانية والسياسية والاقتصادية الكارثية التي خلفتها،
يكشف عن واقع مختلف تماما عما روجت له الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
البداية: هجمات 11 سبتمبر
والاستجابة الأمريكية
في السابع من أكتوبر 2001، أطلقت الولايات
المتحدة وحلفاؤها عملية "الحرية الدائمة" ضد أفغانستان. الهدف المعلن
كان القضاء على تنظيم القاعدة وإسقاط نظام طالبان الذي كان يحمي أسامة بن لادن.
بعد أقل من شهرين، انهار النظام الأفغاني وهربت قيادات القاعدة وطالبان إلى
باكستان المجاورة.
واعتمدت الاستراتيجية الأمريكية على التحالف مع
"التحالف الشمالي" المناهض لطالبان، بدعم من القوات الخاصة الأمريكية
والغارات الجوية المكثفة. في غضون أسابيع قليلة، انهارت مواقع طالبان الرئيسية
تدريجيا:مزار شريف (9 نوفمبر)، كابول (13 نوفمبر)، وقندهار (7 ديسمبر 2001). رغم
النجاح العسكري السريع، فشلت القوات الأمريكية في أسر أسامة بن لادن في معركة تورا
بورا (ديسمبر 2001)، حيث تمكن من الهروب إلى باكستان، مما ترك هدفا رئيسيا للحرب
غير محقق.
والمرحلة الثانية (2002-2021) بعد سقوط طالبان،
انتقلت المهمة الأمريكية من مكافحة الإرهاب إلى بناء دولة ديمقراطية في أفغانستان.
هذا التحول في الأهداف أدى إلى بقاء القوات الأمريكية في البلاد لعشرين عاما، مما
جعلها أطول حرب في التاريخ الأمريكي.
الأهداف المعلنة وغير المعلنة
للحرب
وفقا للرواية الرسمية الأمريكية، جاءت الحرب
على الإرهاب لتحقيق عدة أهداف معلنة في مقدمتها القضاء على تنظيم القاعدة ومنع
وقوع هجمات إرهابية مستقبلية
وكذلك نشر الديمقراطية عبر إقامة أنظمة
ديمقراطية في أفغانستان والعراق، و"تحرير" الشعوب من الأنظمة
الديكتاتورية، وحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات
الأهداف غير المعلنة الحقيقية
كشفت الوثائق والتحليلات اللاحقة عن أهداف أخرى
كانت المحرك الحقيقي وراء هذه الحروب، السيطرة على الموارد الطبيعية
وكان العراق يحتوي على ثاني أكبر احتياطيات
نفطية مؤكدة في العالم. السيطرة على هذه الموارد كانت ستمنح الولايات المتحدة
نفوذا هائلا في أسواق الطاقة العالمية
وفي أفغانستان، كانت الولايات المتحدة تسعى
للسيطرة على خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين
الهيمنة الجيوستراتيجية
ووفقا استراتيجية الأمن القومي الأمريكي
الجديدة التي أعلنها الرئيس بوش في سبتمبر 2002 ركزت على الحفاظ على مكانة
الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة دون منافس.
وكذلك إعادة تعريف حدود المصالح القومية عبر
منح أمريكا حق التدخل في أي مكان، والتحول من سياسة الردع إلى الاستباق والهجوم
السريع.
كما هدفت الاستراتيجية الأمريكية إلى حصار
الصين ومنع صعودها كقوة عالمية منافسة، والقضاء على خطة "بريماكوف"
لإنشاء تحالف بين روسيا والصين والهند وأيضا التموضع في مناطق استراتيجية قريبة من
حدود روسيا والصين.
غزو العراق 2003: كذبة أسلحة الدمار الشامل
في مارس 2003، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها
حربا على العراق تحت ذريعة امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شاملن حيث كشفت التحقيقات
اللاحقة أن إدارة بوش تلاعبت بالمعلومات الاستخباراتية لتبرير الحرب. مثلا، ادعى
ديك تشيني وجود "أدلة واضحة جدا" على أن العراق كان يطور أسلحة نووية،
مشيرا إلى الأنابيب الألومنيوم التي استوردها العراق. لكن الخبراء العلميين في
الحكومة الأمريكية خلصوا إلى أن هذه الأنابيب لا علاقة لها بالبرنامج النووي. كما
روج تشيني لقصة لقاء مزعوم بين محمد عطا (منفذ هجمات سبتمبر) ومسؤول مخابرات عراقي
في براغ، رغم أن الـسي آي إيه والـإف بي آي لم يجدوا أدلة على هذا اللقاء.
وفي 19 مارس 2003، بدأت "عملية حرية
العراق" بضربات جوية استهدفت مواقع النظام العراقي. خلال ثلاثة أسابيع، سقطت
بغداد وانهار نظام صدام حسين. لكن الانتصار العسكري السريع سرعان ما تحول إلى
كابوس أمني واجتماعي.
والأسباب الحقيقية وراء غزو العراق شملت
السيطرة على النفط العراقي والتحكم في أسعاره، وإزاحة نظام لا يتماشى مع المصالح
الأمريكية
وكذلك إقامة قواعد عسكرية دائمة في قلب الشرق
الأوسط، وإعادة تشكيل خريطة القوى الإقليمية لصالح إسرائيل.
التداعيات الكارثية للحربين الخسائر البشرية
والمالية
بعد مرور أكثر من عقدين على انطلاق "الحرب
على الإرهاب"، تتكشف اليوم، بشكل أوضح من أي وقت مضى، التكلفة الحقيقية لهذه
الحروب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وخاصة في أفغانستان والعراق. فقد
بدأت هذه الحروب كرد على هجمات 11 سبتمبر 2001، تحت شعارات مثل "القضاء على
الإرهاب" و"نشر الديمقراطية"، لكنها تحولت إلى كوارث استراتيجية
وإنسانية، فشلت في تحقيق أهدافها وأنتجت أزمات ممتدة حتى اليوم.
وفي أفغانستان قتل حوالي 241 ألف شخص منذ 2001،
بينهم أكثر من 71 ألف مدني أنفقت الولايات المتحدة أكثر من تريليوني دولار على مدى
20 عاما قتل 2465 جنديا أمريكيا و3609 من قوات التحالف.
ويقدم كتاب "اتجاه الحرب: الاستراتيجية
المعاصرة من منظور تاريخي" للمؤرخ العسكري هيو سترون (الصادر عن الهيئة
العامة السورية للكتاب بترجمة حسن جبور إسبر)، رؤية تحليلية شاملة لهذا الإخفاق،
محذرا من تكرار أخطاء الماضي تحت مسميات جديدة، ومنبها إلى خطورة تجاهل البعد
التاريخي في فهم طبيعة الحروب المعاصرة.
و صدر حديثا عن "الهيئة العامة السورية
للكتاب" كتاب مترجم تحت عنوان "اتجاه الحرب: الإستراتيجية المعاصرة من
منظور تاريخي" من تأليف المؤرخ العسكري البريطاني البارز هيو سترون، وترجمة
حسن جبور إسبر. ويعد هذا الإصدار محاولة جادة لفهم الأسباب الحقيقية وراء إخفاقات
الغرب في ما أطلق عليه "الحرب على الإرهاب"، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر
2001.
الكتاب يتناول الحروب التي خاضتها الولايات
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، خاصة في أفغانستان والعراق، ويحلل استراتيجياتها
العسكرية من منظور تاريخي دقيق، لينتهي إلى استنتاج صادم: هذه الحروب لم تكن
"جديدة" كما روج لها، بل تكرار لإخفاقات سابقة بسبب سوء الفهم والتطبيق
الخاطئ لمفهوم الإستراتيجية.
ويشير الكتاب، مستندا إلى تقارير موثوقة، إلى
أن الحرب الأمريكية على أفغانستان خلفت أكثر من 38,000 قتيل من المدنيين الأفغان،
وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، و50,000 معتقل خلال السنوات الثلاث الأولى
وحدها
كذلك ارتفاع بنسبة 330% في عدد الضحايا
المدنيين عام 2017، بعد تخفيف قواعد الاشتباك في عهد الرئيس دونالد ترامب 2442
جنديا أمريكيا قتلوا بشكل مباشر، وأكثر من 40,000 جندي أمريكي أصيبوا،وكذلك انتحار
آلاف الجنود العائدين من الحرب
وقتل قرابة 4000 متقاعد أمريكي بسبب آثار
الحرب، و1150 قتيلا من قوات التحالف الدولي الأخرى
ولا تشمل هذه الأرقام الوفيات غير المباشرة
بسبب الأمراض، أو المجاعة، أو تدهور البنية التحتية الصحية والمائية، والتي تقدر
بمئات الآلاف من الأرواح.
وفي المجمل، قتل ما بين 480,000 و507,000 شخص
نتيجة للعنف الذي استخدمته قوات التحالف الأمريكية في أفغانستان وباكستان والعراق
خلال عامي 2003 و2018، باستثناء الوفيات غير المباشرة، وفقا لجامعة براون (2018).
مرة أخرى، فإن أعداد الأشخاص الذين قتلوا في حروب الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر.
كما لقي نحو 370 ألف جندي ومتعاقد ومدني حتفهم
نتيجة للعنف الحربي المباشر؛ ويعتقد لوتز أن أعدادا أكبر بكثير لقوا حتفهم نتيجة
للعواقب غير المباشرة للحرب، مثل سوء التغذية، وتضرر البنية التحتية، والتدهور
البيئي، والأمراض، والجوع - أو كم عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة لنقص الخدمات في
المناطق التي قصفت فيها المستشفيات وأخرجت من الخدمة. في المتوسط، مقابل كل قتيل
في القتال، يموت أربعة أشخاص آخرين نتيجة لعواقب غير مباشرة قد تظهر آثارها بعد
أشهر أو حتى سنوات. لا تزال البنية التحتية والأنظمة الصحية والتعليمية في العراق
مدمرة بسبب الحرب، مما يولد احتياجات إنسانية مستمرة، وبؤسا، وبعض الوفيات
والإعاقات.
كما قتل نحو 210 آلاف مدني في أعمال عنف مباشرة
من جميع الأطراف، ولقي أكثر من 6800 جندي أمريكي حتفهم في الحروب. ويشير المشروع
إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات والإصابات بين المتعاقدين الأمريكيين
كما يقتضي القانون، مضيفا أنه من المرجح أن يكون 6900 منهم على الأقل قد قتلوا.
ويبلغ عدد اللاجئين والنازحين داخليا من
الأفغان والعراقيين والباكستانيين اليوم نحو 7.6 مليون شخص، وغالبا ما يعيشون في
ظروف غير ملائمة على الإطلاق.
بالاضافة إلى ذلك هناك سجل لمحاولات عديدة من
قبل الجيش الأمريكي لتهريب الآثار خارج البلاد. وسرقت العديد من القطع الأثرية
التي أخرجت من العراق خلال فترة الاحتلال على يد ضباط وجنود التحالف، بما في ذلك
بناء على طلب من الوكالات الأمريكية المعنية وجامعي الآثار.
إن الأضرار التي لحقت بالمتحف العراقي عام 2003
لا تحصى. فسجلاته، التي لم تكن مثالية قبل الحرب، دمرت جزئيا وتضررت على يد
اللصوص. ويعتقد أن نحو 15 ألف قطعة أثرية مفقودة. ولم يسترد منها حتى الآن سوى أقل
من 6000 قطعة، وهي بعيدة كل البعد عن أن تكون من أثمن القطع، استنادا إلى المعرض
الذي أقيم عام 2021. لم تنته عملية الاستعادة بعد، ولكن اتضح أن القطع التي أعيدت
إلى المتحف الرئيسي في العراق لم تسرق جميعها عام 2003. فقد نقل العديد منها إلى
خارج البلاد في ظروف مختلفة بعد ذلك بكثير.
ومن أهم المؤسسات التي تعرضت للتدمير بيت
الحكمة، المكتبة الشهيرة والمركز الأكاديمي، الذي كان يحتوي على الأدلة الأثرية من
العصر العباسي التي بقيت بعد أن نهب المغول المدينة عام 1258.
كانت المأساة الكبرى هي دار الكتب والوثائق
الوطنية العراقية، التي لم تنهب فحسب، بل دمرت عمدا. عرضت بعض الوثائق المسروقة
لاحقا مقابل فدية، لكن الحكومة الجديدة رفضت دفعها للمبتزين. ودمرت العديد من
المخطوطات عمدا باستخدام الفوسفور الأبيض ومدافع المياه القوية.
بعد زيارة الجنود الأمريكيين، نهب السكان
المحليون المكتبة والأرشيف، لتقصير المحتلين في واجبهم بحماية التراث الثقافي
العراقي. لحسن الحظ، نجح الموظفون في لحام الباب الفولاذي للمكتبة، ما جعل الضرر
الذي لحق بالكتب أقل من الضرر الذي لحق بالوثائق الأرشيفية. وبلغت الخسائر
الإجمالية 25% من الكتب، بما فيها الكتب النادرة، و60% من الوثائق الأرشيفية، بما
في ذلك بعض وثائق العهدين العثماني والهاشمي، بالإضافة إلى جميع مقتنيات المكتبة
من العهد الجمهوري.
ومن الآثار السلبية التي خلفها غزو عام 2003
على الأقليات العرقية والدينية المتنوعة التي تشكل النسيج الاجتماعي العراقي،
تأثيره الضار. ومع ذلك، فإن هذا التنوع وهذا التراث الغني هما ما يمهدان الطريق
لمستقبل أكثر إشراقا للأمة، إذا استطاع النظام السياسي الاعتراف به وتمثيله.
بعد تهميشها من قبل نظام سياسي مرسم مؤسسيا
وقلة تمثيلها في البرلمان، وجدت الأقليات العراقية نفسها مهمشة من قبل الدولة، بل
وفي مخيلة مستقبل البلاد. هاجر الكثيرون منهم، ويقيمون الآن في الشتات، مغيرين
بذلك التنوع العرقي والديني في العراق.
إن تقدير الخسائر الثقافية للحرب يتجاوز تدمير
الأضرحة والقطع الأثرية، ونهب المتاحف والمباني: فقد كان استبعاد الأقليات من
عمليات بناء الدولة من أكبر الخسائر الاجتماعية والثقافية التي تكبدها العراق.
وهذا وضع مأساوي للعراق، الذي ينبع تفرده وقوته وثرائه من تاريخه وثقافته العريقة،
وتقاليده الدينية والفنية والموسيقية، واللغات التي ساهمت في تراثه وتطوره. هذا
التراث يستحق الحماية والاحتفاء.
إلى أن يفكك نظام المحاصصة، ويزدهر عراق جديد
قائم على الجدارة، يجب حماية الأقليات وإدماجها في مستقبل العراق. إلا أن ذلك لا
يتحقق إلا من خلال حماية حقوق الأقليات في الحياة السياسية العراقية، وبذل جهود
حقيقية ومتضافرة لزيادة مقاعد البرلمان والتمثيل القانوني للأقليات. ينبغي أن تكون
الأولوية للاستثمار في المناطق التي دمرها الإرهاب والصراع، وتقديم المزيد من
التعويضات للمجتمعات التي دمرت سبل عيشها ومنازلها، وتوفير المزيد من القوات على
الأرض لحماية المجتمعات والمزارات الدينية.
عشرون عاما من الدمار والفساد والعنف، وما
تلاها من هجرة لمجتمعات عديدة، لا يمكن محوها. ومع ذلك، ينبغي أن تشكل الذكرى
العشرون لاحتلال العراق نقطة تأمل في شكل العراق الذي يصبو إليه العراقيون الآن.
هناك بالتأكيد أمل كبير في جيل جديد من العراقيين يدعو إلى رؤى وطنية جديدة،
وإنهاء نظام المحاصصة، وتعزيز الحقوق المدنية، وتوسيع الفرص الاقتصادية.
ومع ذلك، يجب أن تكون جميع طوائف العراق جزءا
من هذا الحوار. فعراق أكثر شمولا، يشيد بتنوعه ويفخر باختلافه، قد يكون القوة
الدافعة اللازمة لتوحيد الأمة.
بعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي للعراق، سقط
العراق من أجندة صنع القرار في واشنطن العاصمة، مهملا جزئيا نتيجة للتجربة المريرة
للحرب، والخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها، ومرور الزمن. لكن بالنظر إلى عشرين
عاما فأكثر، يحتاج العراقيون إلى الكثير من قادتهم وقادتهم الذين حرروهم سابقا.
إن لجنة المصالحة الوطنية، ودستورا جديدا،
واقتصادا أقل اعتمادا على عائدات النفط، ليست سوى بعض المجالات التي يسلط خبراء
مبادرة العراق التابعة للمجلس الأطلسي الضوء عليها في هذه المجموعة من التأملات
بمناسبة مرور عقدين على الغزو الأمريكي.
ظهور الإرهاب وتمدد إيران في الشرق الأوسط
أدت عواقب الحرب في العراق إلى تمكين مذهل
للجهات المسلحة غير الحكومية في المنطقة وخارجها، والتي شنت هجوما مباشرا وشاملا
على سيادة العديد من الدول. وبطبيعة الحال، برز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق
والشام (داعش) في خضم صراع شرس على السلطة في عراق ما بعد الغزو، وسعت إلى إقامة
"خلافتها" كمؤسسة سياسية (سنية) بديلة لمنافسة الدولة القومية، حيث سيطر
على مساحات واسعة من العراق وسوريا بين 2014-2019. تعميق الانقسامات الطائفية أدى
التدخل الأمريكي إلى تفجير الصراعات الطائفية بين السنة والشيعة في العراق.
وبدأت هذه الصراعات بعد تفجير مسجد العسكري في
سامراء عام 2006، وتطورت إلى حرب أهلية طائفية راح ضحيتها عشرات الآلاف.
صعود النفوذ الإيراني استفادت إيران بشكل كبير
من إزالة نظامي طالبان وصدام حسين، اللذين كانا يشكلان حاجزا جغرافيا وأيديولوجيا
أمام النفوذ الإيراني.
مع سقوط النظام البعثي، شهدت إيران أخيرا هزيمة
منافس لم تستطع التغلب عليه بعد ثماني سنوات من إحدى أكثر حروب المنطقة دموية. وقد
مهد ذلك الطريق للتأثير على قادة الشيعة العراقيين الذين اعتمدوا طويلا على دعم
النظام الديني الإسلامي المجاور. وحتى مع تحدي بعض مراكز العلوم الشيعية في النجف
وكربلاء (مرة أخرى) لمدينة قم، أتيحت لإيران فرص جديدة للتأثير لم تكن موجودة من
قبل.
من خلال اختراق المؤسسات السياسية العراقية من
خلال مسؤولين معينين خاضعين لرغبات نظامها، نجحت إيران في تحقيق هدفين: ردع
التهديدات المستقبلية للأعمال العدائية العراقية ومنع الولايات المتحدة من استخدام
الأراضي العراقية كمنصة لغزو إيران.
ومن خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري، دربت
إيران وزودت العديد من الميليشيات التي اخترقت لاحقا البنية الأمنية العراقية
رسميا من خلال قوات تسمى وحدات الحشد الشعبي، والتي نفذت هجمات متكررة ضد أمريكا.
ومع ذلك، أثبتت هذه الجماعات في النهاية قيمتها
للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم (داعش) - ومع ذلك، نجحت إيران حتى في ذلك
الوقت في الظهور بمظهر الحامي لسيادة العراق من خلال تجهيز وحدات الحشد الشعبي على
الفور، على عكس الرد الأمريكي المتأخر.
الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة
وفي أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب، عادت حركة
طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مما يعني فشل المشروع الأمريكي في بناء دولة
ديمقراطية مستقرة. كما تمكنت تنظيمات إرهابية أخرى من ترسيخ وجودها في المنطقة.
وفي العراق لم تتحقق الديمقراطية المزعومة، بل
غرق العراق في دورة من العنف والفساد وعدم الاستقرار. كما لم يتم العثور على أسلحة
الدمار الشامل المزعومة، مما كشف عن حجم التضليل الذي مارسته الإدارة الأمريكية.
وأدت الحروب الفاشلة في أفغانستان والعراق إلى
تراجع كبير في المصداقية والهيبة الأمريكية دوليا. ظهر هذا التراجع جليا في انسحاب
الولايات المتحدة من عدة مناطق أفريقية لصالح روسيا والصين.
وخلقت الحروب فراغا في القوة استغلته قوى
إقليمية أخرى برزت روسيا كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط، بينما عززت الصين من نفوذها
الاقتصادي في المنطقة.
وكانت الحرب في العراق مثيرة للقلق بشكل خاص
للقادة الصينيين. قليلون هم من اعتقدوا أن الولايات المتحدة ستخوض حربا كارثية
كهذه بسبب شيء مثالي مثل تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط. كان الافتراض السائد
هو أن الحرب كانت تتعلق بالحفاظ على السيطرة على النفط العالمي - واستخدام هذه
الهيمنة لمنع الصين من الصعود إلى وضع المنافس الند.
وأصبحت
ما يسمى بـ " معضلة ملقا " سمة من سمات التحليل في المشهد الاستراتيجي
للصين: فكرة أن أي قوة يمكنها السيطرة على مضيق ملقا يمكنها التحكم في شحن النفط
إلى الصين، وبالتالي اقتصادها. منذ ذلك الحين، طورت الصين أكبر بحرية في العالم
واستثمرت في الموانئ عبر منطقة المحيط الهندي من خلال مبادرة طريق الحرير البحري.
زاد إنفاقها الدفاعي خمسة أضعاف هذا القرن، من 50 مليار دولار في عام 2001 إلى 270
مليار دولار في عام 2021، مما يجعلها ثاني أكبر منفق دفاعي في منطقة المحيطين
الهندي والهادئ بعد اليابان، وأعلى من دول المحيطين الهندي والهادئ الثلاثة عشر
التالية مجتمعة.
ومنذ حرب العراق، أصبح الشرق الأوسط محور تركيز
أكبر في السياسة الخارجية الصينية. فبالإضافة إلى بناء جيشها الخاص، بدأت الصين
بمناقشة الشؤون الأمنية والاستراتيجية مع موردي الطاقة في الشرق الأوسط، وإجراء
تدريبات مشتركة، وبيع أنظمة أسلحة أكثر تنوعا، والسعي إلى وجود إقليمي يتعارض أو
يتنافس بشكل متزايد مع تفضيلات الولايات المتحدة.
كما أدت تداعيات الحروب إلى إعادة ترتيب
التحالفات الإقليمية، حيث برزت محاور جديدة قائمة على التنافس بين القوى الإقليمية
والدولية، خاصة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا والصين وإيران من
جهة أخرى.
الدروس المستفادة فشل المشروع الإمبريالي
الجديد تكشف تجربة الحرب على الإرهاب عن فشل المشروع الإمبريالي الجديد الذي تبنته
الولايات المتحدة في مطلع الألفية الجديدة. فرغم التفوق العسكري الساحق، فشلت
أمريكا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى في كلا المسرحين. الحاجة إلى
حلول سياسية أظهرت التجربة أن المشاكل السياسية والاجتماعية المعقدة لا يمكن حلها
بالقوة العسكرية وحدها.
الحروب التي استمرت عقود لم تنجح في بناء دول
مستقرة أو القضاء على الإرهاب، بل أدت إلى مضاعفة المشاكل. تكلفة الهيمنة العالمية
أثبتت هذه الحروب أن الحفاظ على الهيمنة العالمية من خلال القوة العسكرية يتطلب
تكلفة باهظة، ليس فقط من الناحية المالية والبشرية، بل أيضا من ناحية المصداقية
والشرعية الدولية.
إن الحرب على الإرهاب، التي أطلقت كرد على
أحداث 11 سبتمبر 2001، تركت إرثا مدمرا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فبدلا
من تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية المزعومة، أدت هذه الحروب إلى زعزعة
الاستقرار الإقليمي وتفجير الصراعات الطائفية وظهور تنظيمات إرهابية أكثر تطرفا.
كما أدت إلى تراجع النفوذ الأمريكي عالميا
وبروز قوى منافسة جديدة، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية استخدام القوة العسكرية
كأداة للسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين.
دور الشركات الأمنية الخاصة وتأثيرها على
النزاعات في العراق وأفغانستان بعد 2001
شكل ظهور الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بعد
هجمات 11 سبتمبر 2001 تحولا جذريا في طبيعة النزاعات المسلحة، حيث لعبت هذه
الشركات دورا محوريا في العمليات العسكرية والأمنية في كل من العراق وأفغانستان،
مما أثار تساؤلات جوهرية حول خصخصة الحروب وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
وشهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
تطورا مذهلا في صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، حيث أصبحت هذه الشركات
لاعبا محوريا في الأمن العالمي. بعد انتهاء الحرب الباردة، تزايد الاعتماد على هذه
الشركات لتقديم خدمات عسكرية وأمنية متخصصة تتراوح من الخدمات اللوجستية إلى
العمليات القتالية المباشرة.
وفقا للبيانات المتاحة، ازداد عدد الدول التي
تعمل فيها الشركات الأمنية الخاصة الروسية من 4 دول في عام 2015 إلى 27 دولة في
عام 2021، مما يظهر التوسع المتسارع لهذه الصناعة على المستوى العالمي.
الشركات الأمنية في العراق: بلاك ووتر والهيمنة
الأمنية
تعتبر شركة بلاك ووتر الأمريكية (التي غيرت
اسمها لاحقا إلى أكاديمي) أشهر مثال على دور الشركات الأمنية الخاصة في العراق بعد
الغزو الأمريكي عام 2003. حصلت الشركة على عقود بمليارات الدولارات لتوفير الحماية
للدبلوماسيين والمنشآت، وأول عقد لها في العراق كان بقيمة 21 مليون دولار لحماية
بول بريمر، رئيس سلطة التحالف المؤقتة.
بحلول نهاية عام 2003، فاق عدد موظفي الشركات
الأمنية الخاصة عدد القوات البريطانية وأصبح ثاني أكبر قوة مسلحة في البلاد بعد
القوات الأمريكية. تقدر التقارير أن عدد المتعاقدين الأمنيين المسلحين في العراق
تراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف شخص، رغم عدم وجود أرقام رسمية دقيقة.
وكان للشركات الأمنية الخاصة تأثير عميق على
طبيعة النزاع في العراق من عدة جوانب:
الجانب التشغيلي: سمحت هذه الشركات للقوات
الأمريكية بتنفيذ مهام أوسع بعدد أقل من الجنود النظاميين، حيث قدر الخبراء أن
استبدال 113 ألف متعاقد أمني يتطلب 250 ألف عسكري نظامي.
الجانب الاستراتيجي: وفرت هذه الشركات للحكومة
الأمريكية مرونة سياسية أكبر من خلال تجنب القيود المفروضة على عدد القوات
النظامية وتقليل الخسائر العسكرية الرسمية.
التجربة الأفغانية: دور معقد
ومتعدد الأوجه
وفي أفغانستان، رافق وصول الشركات الأمنية
الخاصة الغزو الأمريكي في أواخر عام 2001، حيث وصل عدد الشركات العاملة إلى حوالي
140 شركة في أوج النشاط. بلغ عدد المتعاقدين ذروته عام 2012 بحوالي 120 ألف موظف،
منهم 28 ألف متعاقد أمني.
تطور دور هذه الشركات من تقديم الخدمات
اللوجستية ودعم القواعد في البداية إلى المشاركة في مجال الاستخبارات والعمليات
العسكرية. وصلت نسبة المتعاقدين إلى العسكريين النظاميين من 1:1 في 2010-2011 إلى
3:1 في نهاية التدخل الأمريكي.
وكان اعتماد القوات الأفغانية على المتعاقدين
الأمريكيين أحد أبرز جوانب التأثير، حيث اعتمدت القوات الحكومية الأفغانية بشكل
كبير على المتعاقدين الممولين أمريكيا لإصلاح وصيانة أسطولها من الطائرات
والمركبات المدرعة.
عند انسحاب المتعاقدين مع القوات الأمريكية،
فقدت القوات الأفغانية قدرتها على الحفاظ على عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات
الشحن والمروحيات الأمريكية الصنع والطائرات بدون طيار لأكثر من بضعة أشهر.
الانتهاكات
مجزرة ساحة النسور
تعتبر مجزرة ساحة النسور في بغداد في 16 سبتمبر
2007 أبرز مثال على الانتهاكات التي ارتكبتها الشركات الأمنية الخاصة، حيث أطلق
حراس شركة بلاك ووتر النار عشوائيا على المدنيين العراقيين، مما أسفر عن مقتل 17
شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وأظهرت التحقيقات أن إطلاق النار كان غير مبرر
وأن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد. أدين أربعة من عناصر الشركة
عام 2014، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عنهم في 2020، مما أثار
غضبا واسعا في العراق.
تآكل السيادة الوطنية
أدى الاعتماد المفرط على الشركات الأمنية
الخاصة إلى تآكل السيادة الوطنية في كل من العراق وأفغانستان من خلال:
الإفلات من العقاب: عملت هذه الشركات في منطقة
رمادية قانونيا، مما صعب محاسبتها على انتهاكاتها.
التحكم في الموارد: سيطرت الشركات الأمنية على
جوانب حيوية من الاقتصاد والأمن، مما قوض قدرة الحكومات المحلية على ممارسة سلطتها
الفعلية.
خلق هياكل موازية: أنشأت هذه الشركات نظما
أمنية واقتصادية موازية تتحدى سلطة الدولة الرسمية.
التأثير على النسيج الاجتماعي
أثر وجود الشركات الأمنية الخاصة سلبا على ثقة
السكان المحليين في كل من العراق وأفغانستان، حيث اتسمت ممارساتها بالعدوانية
المفرطة. كما وصف أحد الصحفيين ممارسات شركة بلاك ووتر: "إنهم مشهورون بكونهم
عدوانيين جدا. يستخدمون رشاشاتهم مثل أبواق السيارات".
وساهمت الممارسات التمييزية لبعض الشركات
الأمنية في تعميق الانقسامات الطائفية والعرقية، خاصة في العراق، حيث أدت إلى
تفاقم التوترات بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.
وفي السنوات الأخيرة، برزت مجموعة فاغنر
الروسية كنموذج جديد للشركات الأمنية الخاصة، حيث تختلف عن النموذج الأمريكي في
كونها أداة مباشرة للسياسة الخارجية الروسية. تعتمد فاغنر على الموارد الاقتصادية
والعسكرية التي تتداخل مع القوات المسلحة الروسية، وقد وصل عدد موظفيها إلى أكثر
من 50 ألف شخص.
ويشير الخبراء إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي دولي
أكثر صرامة للتعامل مع الشركات الأمنية الخاصة، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة مع
مجموعة فاغنر التي صنفت كمنظمة إرهابية من قبل عدة دول.
ونشرت سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر
وثيقة مونترو عام 2008 التي تضمنت توصيات لتمكين الدول من تنظيم الشركات العسكرية
والأمنية الخاصة على النحو القانوني السليم.
وتظهر تجربتا العراق وأفغانستان أن الاعتماد
المفرط على الشركات الأمنية الخاصة يحمل مخاطر جدية على الاستقرار طويل الأمد
والسيادة الوطنية. فقد أدى غياب الرقابة الفعالة والمساءلة إلى انتهاكات جسيمة
لحقوق الإنسان وتقويض جهود بناء السلام.
كما أن خصخصة الحروب قد تؤدي إلى إطالة أمد
النزاعات نظرا للحوافز الاقتصادية التي تدفع هذه الشركات للاستفادة من استمرار
حالة عدم الاستقرار.
ومع استمرار نمو صناعة الأمن الخاص عالميا،
تواجه الحكومات والمجتمع الدولي تحديات معقدة في موازنة الحاجة لخدمات هذه الشركات
مع ضرورة ضمان المساءلة والشفافية. يتطلب الأمر وضع آليات رقابة دولية أكثر فعالية
وإطار قانوني واضح ينظم عمل هذه الشركات في مناطق النزاع.
العودة إلى المربع صفر.. عودة
طالبان وانسحاب من العراق
بعد أكثر من عقدين من التدخل العسكري الأمريكي
في كل من أفغانستان والعراق، تعود واشنطن تدريجيا إلى الداخل، معلنة انسحابات
متتالية أعادت المشهد الإقليمي إلى نقطة البداية، حيث تعود قوى جهادية مثل
"طالبان" و"داعش" للواجهة من جديد، بينما يزداد القلق من
تداعيات هذا الانسحاب على أمن واستقرار المنطقة.
أولا: أفغانستان.. عودة طالبان بعد عقدين من
الحرب
كان التدخل الأمريكي في أفغانستان في أكتوبر
2001 أول رد مباشر على هجمات 11 سبتمبر، بهدف إسقاط حكم طالبان والقضاء على تنظيم
القاعدة. وبعد عشرين عاما، تنسحب القوات الأمريكية لتعود "طالبان" إلى
الحكم، بشكل أثار تساؤلات حول جدوى هذا التدخل الطويل.
وتقول
كاثرين ويلبارغر، الباحثة في معهد واشنطن، إن الانسحاب جاء كجزء من استراتيجية
لتوجيه الموارد الأمريكية إلى أولويات عالمية أخرى. لكنها تعترف أن ما حدث كان عكس
المتوقع، حيث استولت طالبان على الحكم مجددا، واندلعت أزمة لاجئين، مما أعاد
الأنظار إلى أفغانستان.
وأشارت إلى أن واشنطن باتت بحاجة لإعادة النظر
في كيفية دعم شركائها الأمنيين في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا، عبر بناء
تحالفات إقليمية جديدة تعوض غياب الوجود المباشر.
المشهد الجهادي الجديد:
الباحث هارون زيلين أكد أن تركيبة الجماعات
الجهادية تغيرت جذريا؛ فلم تعد عربية فقط، بل باتت مزيجا من عناصر من جنوب آسيا،
وشبه القارة الهندية، وحتى جنوب شرق آسيا.
بالنسبة لتنظيم داعش – ولاية خراسان، فقد حافظ
على وجود محدود في أفغانستان منذ 2015، لكنه بدأ يحاول استثمار نجاح طالبان لإعادة
تقديم نفسه كممثل شرعي للدولة الإسلامية في المنطقة.
التنظيم كثف هجماته ضد طالبان، كما حصل في
ولاية ننجرهار قبل سقوط كابول، ما يشير إلى تصاعد تنافس داخلي جهادي قد يفجر الوضع
الأمني مرة أخرى.
والنجاح الذي حققته طالبان أعطى زخما جديدا للحركات الجهادية الأخرى،
كما ظهر في تهنئة "هيئة تحرير الشام" في سوريا بانتصار طالبان، واعتباره
نموذجا يجب تكراره في دمشق.
وينظر إلى هذا الانتصار كعامل أساسي شجع
الولايات المتحدة على التسامح مع الجبهة السورية بقيادة محمد الجولاني، بل
والتعامل معها كسلطة أمر واقع في الشمال السوري، مع تقارير عن رفعها من قوائم
الإرهاب.
ثانيا: العراق.. انسحاب جديد وسط تحذيرات من
تكرار سيناريو 2011
بالتزامن مع ذكرى 11 سبتمبر هذا العام، بدأت
الولايات المتحدة خطوات فعلية للانسحاب من العراق، ضمن اتفاق مبرم مع بغداد ينص
على إنهاء مهام التحالف الدولي بحلول نهاية سبتمبر 2025.
وحذر ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، من تكرار خطأ
انسحاب 2011، الذي مهد لصعود "داعش" في 2014.
وأكد على أن التهديدات الإرهابية ما زالت
قائمة، وأن القدرات الجوية العراقية محدودة، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر مع
القوات الأمريكية قبل الانسحاب الكامل.
الانسحاب الأمريكي عام 2011 أدى إلى فراغ أمني،
استغلته "داعش" للسيطرة على ثلث العراق وسوريا، ما تسبب بموجة نزوح وعنف
لا تزال آثارهما قائمة حتى اليوم.
الاتفاق الأمريكي-العراقي:
وتوصل الطرفان إلى جدول زمني للانسحاب
التدريجي، مع تأكيد ضرورة استمرار التعاون الأمني، خصوصا في المناطق الحدودية
الهشة مع سوريا، حيث تنشط خلايا داعش النائمة.
تقارير إعلامية أشارت إلى بدء سحب مئات الجنود
من قاعدة عين الأسد في الأنبار، وهي القاعدة الأكبر للولايات المتحدة في العراق،
والتي تعرضت لهجمات متكررة، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى في غزة.
ثالثا: تحديات ومخاطر مشتركة
في كل من العراق وأفغانستان، لم يؤد الانسحاب
الأمريكي إلى استقرار دائم، بل إلى صعود قوى متطرفة، وتوسع للنفوذ الإيراني،
وتراجع في قدرات الشركاء المحليين.
في أفغانستان عادت طالبان إلى الحكم، وبدأت
موجة تجنيد جهادية جديدة بقيادة داعش، وفي العراق لا يزال خطر داعش قائما،
والحدود مع سوريا مفتوحة أمام تدفقات أمنية معقدة، في ظل غياب تنسيق إقليمي فعال.
العودة إلى المربع صفر؟
الانسحابات الأمريكية المتزامنة في كل من
أفغانستان والعراق تعيد طرح تساؤلات قديمة جديدة: هل كانت هذه الحروب تستحق
التكاليف البشرية والمادية؟ وهل تحققت الأهداف الاستراتيجية المعلنة؟ أم أن واشنطن
عادت إلى المربع صفر، حيث بدأ كل شيء، لكن بثمن باهظ وأزمات متجددة؟
في المحصلة، يبدو أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة
من إعادة التشكيل الجيوسياسي، حيث الفراغ الأمريكي يملأ بقوى إقليمية ودولية، فيما
تعود التنظيمات الجهادية لتستغل الفوضى، مستعيدة مشهد ما بعد 11 سبتمبر، لكن بنسخة
أكثر تعقيدا.