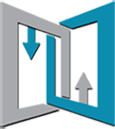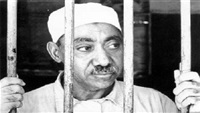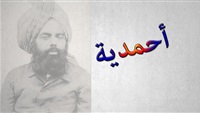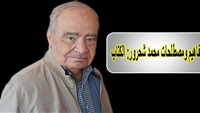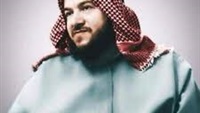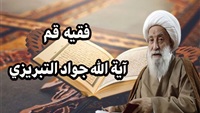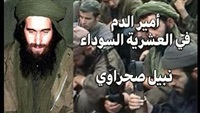بين النص والدم: كيف يستخدم تنظيم "داعش" اللغة لصناعة الولاء والاصطفاف؟
السبت 11/أكتوبر/2025 - 12:18 م
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
في الثاني من أكتوبر 2025، نشرت صحيفة «النبأ» التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية افتتاحية جديدة تندرج ضمن سلسلةٍ من الخطابات التي تهدف إلى إعادة إنتاج سردية التنظيم بعد تراجعاته الميدانية في العراق وسوريا والساحل الإفريقي. لا تُعدّ هذه الافتتاحية حدثًا معزولًا أو تعبيرًا عن رأي كاتبٍ فردي، بل جزءًا من بنيةٍ اتصالية مؤسسية تعمل على صيانة الهوية التنظيمية وتغذية الوعي الجهادي بمنظومة متكرّرة من المفاهيم والمقولات. من هنا، فإن تحليل مضمونها ليس ترفًا بحثيًا، بل ضرورة لفهم كيف تُترجم الأيديولوجيا إلى لغةٍ اتصالية تُعيد تفسير الهزيمة كابتلاء، والعزلة كتميّز، والعنف كفضيلةٍ أخلاقية.
إن هذه القراءة لا تكتفي بتفكيك البنية اللغوية للخطاب، بل تتناول أيضًا دلالاته السياسية والنفسية والاجتماعية، باعتباره نموذجًا مصغّرًا لأسلوب التنظيم في بناء المعنى وتوجيه الجمهور. فالافتتاحية تكشف عن تحوّل في وظيفة الإعلام الجهادي: من أداة تعبئة ظرفية إلى وسيلة لإدارة الوعي الجمعي وصناعة الهوية المستمرة. ومن خلال تحليل عناصر النص — من انتقاء الآيات والأحاديث إلى توظيف العواطف الجماعية مثل الذنب والعار — يمكن إدراك كيف يسعى التنظيم إلى تحويل الكلمة إلى فعل، والمفردة إلى سلاح رمزي. وتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تُبرز الثغرات المنهجية والمنطقية في الخطاب وتقدّم تصورًا لمقاربات المواجهة الفكرية والاجتماعية والشرعية التي يمكن أن تُسهم في إضعاف تأثيره المستقبلي.
السياق
افتتاحية «النبأ» لا تُعد نصًا عفويًا أو مقالةً فردية بل هي جزء من منتَج إعلامي مُمنهج تصدره أذرع الدعاية في تنظيم الدولة. الصحيفة تُنشر بانتظام وتخضع لما يشبه جدولًا تحريرياً واستراتيجيةً رسائلية، ما يعني أن كل افتتاحية تُنسق لتخدم أهدافًا محددة: ترسيخ مرجعيات فكرية، إعادة إنتاج رموز شرعية، وبناء خطابٍ موحّد يُعيد تشكيل وعي القارئ وفق أُطر التنظيم. بهذا السياق، تصبح «النبأ» أداة مؤسسية أكثر منها صوتًا فرديًا، وهي تعكس أولويات القيادة وتوجّه النقاش الداخلي والخارجي لدى جمهور التنظيم.
لا يمكن قراءة مقتطفات مثل تلك الافتتاحية بمعزل عن بنيتها التنظيمية؛ فهي تستخدم نصوصًا دينية ومراجع شرعية مُنتقاة بعناية لتقنين مواقف سياسية وعسكرية. الاختيارات القرآنية والحديثية داخل النص لا تأتي عشوائية، بل تُوظف لخدمة بنية إقناعية مُحكمة: تبرير العنف، تمييز الولاء، وخلق معيار أخلاقي للتفاضل بين عناصر الجماعة والمجتمع الأوسع. هذا التوظيف الانتقائي للنصوص الشرعية يعمل كدرع شرعي أمام النقد ويمنح خطاب التنظيم طابعًا معداً لإقناع من هم في الحَدّ الفاصل بين الالتحاق والانسحاب.
إحدى وظائف الافتتاحية المركزية هي إعادة تأطير الهزائم والانسحابات كجزء من اختبار إيماني — استراتيجية نفسية وسياسية واضحة. بدلاً من الاعتراف بعوامل لوجستية أو سياسية أو أخطاء قيادية، يحول الخطاب التنظيمي الانكسارات إلى محكٍّ يفرّز «الصدق» من «النفاق»، ويحوّل الخسارة إلى مقياس انتقائي لاختيار المخلصين. هذا الأسلوب يفعل أمرين معًا: يحافظ على الروح المعنوية لدى القاعدة من خلال تقديم معنى للمعاناة، وفي الوقت ذاته يُستخدم كأداة تنقية داخلية لتهميش المعارضين والواقعيين.
لهذا السبب يصبح تحليل افتتاحيات مثل هذه ضروريًا لفك شفرة استراتيجية التواصل لدى التنظيم. قراءة النصوص على ضوء توقيتها، وتكرار موضوعاتها، واستهدافها الأُطرية (الشباب، العائلات، المقاتلون السابقون) تكشف عن نمط منظّم في بناء السرد والدعوة. فهم هذا النمط لا يخدم فقط جهود البحوث الأكاديمية بل هو أداة عملية لصانعي السياسات ومصممي برامج الوقاية، إذ يبيّن نقاط الضعف البلاغية والمنطقية التي يمكن استغلالها في تصميم ردود شرعية، برامج بديلة للشباب، وحملات معلومات مضادة تستهدف تفكيك قدرة هذه الخطاب على التجنيد والهيمنة الاجتماعية.
بنية الرسالة وأهدافها التكتيكية
تبدأ الافتتاحية بتوظيف نصّي متعمد من القرآن والحديث، ليس كمرجع مجرد بل كأداة شرعية تُشكّل مقوّمًا مركزيًا للرسالة. الاقتباس الانتقائي وإخضاع النصوص للتأويل الذي يخدم الهدف الدعائي يوفّران غطاءً إيمانيًا لكل دعوة أو إجراء يُعرض في السياق. بهذه الطريقة يتحول الاستشهاد الديني إلى مرشح يصفّي النقد: من يشكك في المضمون يُصوَّر سريعًا كمشكك في النص نفسه أو في شرعيته، فتصبح المناقشة العقلانية محرَّفة إلى محنة إيمانية تُظهر المعرِّض بمظهر المُتحيّر أو المُخالف للدين.
ثم تتبنى الافتتاحية منطقًا ثنائياً صارماً يقسّم الناس بين فئتين متقابلتين لا ثالث لهما: «مُجاهد صادق» و«منافق قاعد». هذا التجزئة الاختزالية تُبسط الواقع الاجتماعي والسياسي إلى اختبار أخلاقي يسهّل عملية الاستقطاب. القارئ يُجبر ضمنيًا على الانحياز أو أن يُعرّض نفسَه للوصم، وتفقد القضايا المركبة أبعادها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لصالح معيار واحد مُجرّد: الانخراط في الجهاد أو الاتهام بالنفاق.
تُعزز الافتتاحية هذه الثنائية بصيغة بطولية تمجد التضحية وتقدّس العنف باعتباره معيارًا أعلى للشجاعة والالتزام. الجهاد يُعرض كمقياس أخلاقي لا يُقاس بموازين دنيوية بل بمقاييس استثنائية للشهامة والإيثار؛ ومن لا يطابق هذا المعيار يُقذف بلقب الخزي والتخاذل. هذه المثالية ليست دعوة فقط بل تقنية تربوية: تُعيد تشكيل تصورات القارئ عن الشرف والواجب، فتضغط على الحساسيات الثقافية لتصير القبول بالعنف سلوكًا مرغوبًا ومطلوبًا.
أخيرًا، يمتد الخطاب ليشمل بعدًا جنسانيًا ونفسيًا يستدعي معايير الذكورة والتضحية لاختبار الانتماء. يُستعمل الحديث عن الفراق والخوف من الموت وحب الدنيا كآليات تذكي الشعور بالعار وتضغط على الذوات لتقبل القسمة على ذاته والمال. تترافق كل هذه العناصر مع تكرار منهجي عبر وسائل مثل «النبأ»، ما يحوّلها من شعارات مؤقتة إلى أنماط تواصلية مُجذّرة؛ والتكرار هنا هو ما يمنح الخطاب الفاعلية—فالثيمة المتواصلة تقوّي قبولها الاجتماعي وتُضعف المناعة النقدية لدى المستهدفين.
أساليب الإقناع المنهجية
الافتتاحية تعتمد استراتيجية إقناع مُحكَمة تبدأ بتقزيم أعذار المعترضين وإضفاء صبغة أخلاقية سلبية عليها؛ فحب الأسرة والتمسك بالمصالح الدنيوية يُعرضان كدلائل على الضعف والنفاق، لا كظروف إنسانية معقدة. هذا النهج يحوّل أسبابًا اجتماعية واقتصادية مشروعة إلى عيوب شخصية، فيُحشِّد شعور الذنب والعار لدى من يتردّد، ويجعل من القبول بالمخاطرة والتضحية علامة مميّزة للصدق الإيماني. النتيجة أن المنطق الأخلاقي في النص لا يفسّر الواقع بل يقطع عليه، ويجبر القارئ على إعادة تقييم خياراته عبر مقياس أخلاقي مُنتقًى.
ثانيًا، يمزج الخطاب بين القداسة الدينية والتحريض الأخلاقي بحيث يصبح النصُّ مرجعيةً مزدوجة: نص مقدس يمنح الحركات فعلًا مشروعًا، وصك إدانة يمنح القارع الاجتماعي صلاحية فضح المخالفين. هذا المزج يساهم في تبييض أفعال عنيفة أو انتقائية، لأن أي فعل يُقدّم على أنه امتثال لنص ديني يبدو -من منظور القارئ المتأثر- أقل قابلية للنقد الأخلاقي أو القانوني. بالتالي، يتحوّل الاستدلال الديني الانتقائي إلى غطاء يعرقل المناقشة العقلانية ويصعّب مساءلة القرارات الميدانية أو السياسية.
ثالثًا، تعتمد الافتتاحية على اختيار تاريخي ونصي انتقائي للأمثال والأحاديث، فتستخرج نصوصًا تُعزّز الاستنتاج المرغوب وتغفل السياقات التي قد تغيّر مدلولها. هذا الانتقاء المقصود يجعل من التفسير المستند إلى النص عملية مُوجَّهة مسبقًا، لا عملية بحثية نقدية؛ فيتمّ تقديم تفسير واحدٍ ممسوك كحقيقة لا تُناقش. النتيجة أن الجمهور المستهدف لا يُعرض له تعددية قراءات ممكنة، بل يُقنع بتفسير أحادي يجعل المعارضة تبدو خروجًا عن الدين أو خيانة للمجتمع.
رابعًا، هذا الأسلوب يُنتج منطقًا ثنائيًا اختزاليًا (انتماء كامل أو إدانة شاملة) يخدم هدفَيْ التنقية والاستقطاب الداخلي. فعبر إفراغ المساحات الرمادية من أي قيمة أخلاقية أو شرعية، تُصبح الساحة الاجتماعية قابلة للتصفية: يُطرد المعتدلون، ويُعزّز موضع المتشددين، ويُضعف أي إرادة للمعارضة المنظمة داخل المجتمع. العامل الحاسم هنا هو المنهجية—فالتكرار المنهجي والمزج بين القداسة والتحقير يتركان أثرًا تراكمياً يجعل من هذا الخطاب أكثر صعوبة في التفكيك أو الردّ بمنهجية بسيطة.
وظيفة النص بالنسبة للتنظيم
يمكن النظر إلى الافتتاحية بوصفها أداة استراتيجية متعددة الوظائف داخل بنية التنظيم، تؤدي أدوارًا تتجاوز حدود التحريض اللفظي إلى مستوى إدارة الوعي الجمعي. فهي تمثل خطابًا موجّهًا بعناية نحو جمهور داخلي يحتاج إلى إعادة تعبئة مستمرة، خاصة في لحظات الارتباك أو التراجع. هذا النص لا يُنتج مجرد حماسة عابرة، بل يُعيد تشكيل الانتماء ذاته بوصفه فعلًا إيمانيًا لا يحتمل التردد أو النقاش. فكل فرد يُدعى إلى أن يرى التزامه ليس خيارًا سياسيًا أو فكريًا، بل امتحانًا دينيًا يحدد موقعه من الإيمان والولاء، ما يجعل الانضباط الداخلي جزءًا من العقيدة نفسها.
في البعد الثاني، تؤدي الافتتاحية وظيفة “التنقية الداخلية”، وهي من أخطر الأدوات التي يستخدمها التنظيم لضبط تماسكه. فالخطاب لا يكتفي بدعوة الأفراد إلى الثبات، بل يُعيد ترسيم حدود الجماعة من الداخل عبر آلية الإقصاء الرمزي. كل صوت معتدل أو مشكّك يُصنَّف تلقائيًا في خانة الضعف أو النفاق، مما يخلق بيئة مغلقة لا تقبل المراجعة. بذلك تتحول اللغة إلى أداة رقابة معنوية تمارس الإكراه دون حاجة إلى عنف مادي مباشر، إذ يكفي أن يُوسَم أحدهم بالمنافق حتى يُقصى نفسيًا واجتماعيًا.
أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في “إعادة تعريف الفشل”، وهي آلية ذهنية تتيح للتنظيم الاستمرار رغم الهزائم. فعندما تُمنى الجماعة بخسائر ميدانية أو سياسية، يُعاد تأطيرها خطابيًا على أنها «اختبارات إلهية» أو «غربلة للمؤمنين». هذا التأويل يُحوّل الهزيمة من عامل تفكك إلى فرصة تطهير، ويمنع تسرّب الإحباط إلى القاعدة. ومن خلال هذا التلاعب الرمزي، تُستبدل الواقعة الواقعية (الخسارة) برواية معنوية (التمحيص)، ما يحافظ على تماسك الإيمان بالقيادة وبالمشروع نفسه.
أخيرًا، تعمل هذه النصوص كأداة نفسية طويلة المدى تُبقي الأتباع في حالة استعداد دائم وتضحية مستمرة. فالتكرار المنتظم لهذا النوع من الخطاب يخلق ما يشبه "المزاج العقائدي" الذي يوازن بين الألم والأمل، وبين الشعور بالتهديد والإحساس بالاصطفاء. وبهذا المعنى، لا تكون الافتتاحية مجرد رد فعل ظرفي على حدث معين، بل جزءًا من منظومة خطابية تُغذي بقاء التنظيم واستدامة دوافعه القتالية والرمزية، حتى في غياب الانتصارات الفعلية.
الثغرات والمنطق المعيب في الخطاب
من منظور نقدي موضوعي، تظهر في الافتتاحية ثغرات منطقية تجعلها هشّة عند المئول والتحليل. أولًا، تعتمد الخطابة على قفزات استدلالية لا تربط بين الأسباب والنتائج بوضوح منهجي؛ فهي تنتقل من إدراك اجتماعي مركب إلى أحكام أخلاقية مطلقة من دون بناء أدوات قياس أو براهين موضوعية. هذا الانزلاق المنطقي يسهّل عملية الإقناع الانفعالي لكنه يفقد النص مصداقيته أمام قارئ يتطلب حججًا مرتّبة وأدلة ملموسة بدلاً من وصفات اجترارية.
ثانيًا، ثمة ميل واضح إلى التعميم والتخوين، حيث تُلصق صفات الذمّ بجماعات واسعة لمجرد غيابهم عن أعمال القتال. هذا التعميم يقطع ثُلثَ الواقع الاجتماعي — كالضغوط الاقتصادية، الالتزامات العائلية، القيود الصحية، أو تبعات القمع الأمني — ويحوّلها إلى سلوكيات فردية قابلة للإدانة الأخلاقية فقط. نتيجة ذلك أن أي محنة اجتماعية تُقرأ كقصور شخصي أو خلل إيماني، ما يغيّب التحليلات السياسية والاجتماعية الضرورية لفهم دوافع الناس وظروفهم الحقيقية.
ثالثًا، ثغرة جوهرية في الخطاب تتعلق بالتفسير الانتقائي للنصوص الشرعية والتاريخية. الافتتاحية تستدعي آيات وأحاديث خارج سياقاتها اللغوية والتأريخية، ثم تُعيد قراءتها بما يخدم خلاصتها الدعائية. هذا التعامل يجعل من المرجع الديني ساترًا لا دليلًا؛ فالتأويل الأحادي يتجاهل قواعد علوم النص (اللغة، السياق، سبب النزول، المذهب الفقهي)، وبالتالي يضعف المقاربة أمام جمهور داخلي أو خارجي يملك ثقافة شرعية أو وعيًا علميًا، ويترك الباب مفتوحًا لتفنيد النص من قبل مناهج تأويلية أخرى أكثر اتساقًا.
رابعًا، وعلى مستوى التطبيق العملي، تُعاني الافتتاحية من غياب أي حلول منهجية أو سياساتية للمشكلات التي تذكرها. الدعوات إلى التضحية والوصم الأخلاقي لا تقترن بخطط لوجستية، برامج إعادة تأهيل، أو إجراءات اقتصادية تُنهي العوائق المادية أمام المشاركة؛ لذا تظل الرسالة كلامًا رمزيًا يحفز العاطفة ولا يعالج الأسباب البنيوية للتردد أو الانسحاب. هذا النقص يحوّل النص إلى أداة تحريض أكثر منه خارطة طريق عملية، ويزيد احتمال نتائج عكسية كازدياد النفور الاجتماعي أو إفلات القاعدة من الدعوة إذا لم ترافقها حلول ملموسة.
مخاطر وتأثيرات ملموسة
الخطاب الدعائي من هذا النوع لا يقف عند حدود التنظير العقائدي، بل يمارس تأثيرًا مباشرًا في البنية الاجتماعية والنفسية داخل المجتمعات المستهدفة. إذ يُنتج مناخًا من الضغط الاجتماعي يوجَّه بالأساس نحو الفئات الشابة ذات الأوضاع الاقتصادية الهشّة. في ظل شعور بالإقصاء أو فقدان الأمل في العدالة والفرص، يجد هؤلاء الشباب أنفسهم أمام خطاب يُقدّم “المعنى” و”الانتماء” كتعويض عن الفقر والتهميش. بذلك يصبح الخطاب المتطرف وسيلة لإشباع الحاجة إلى الاعتراف والانتماء، ما يجعل احتمالات الانجذاب إلى شبكات التجنيد أو الدعاية عالية جدًا، خاصة حين يُقدَّم الجهاد بوصفه طريقًا للشرف والكرامة في عالم ظالم.
على المستوى الاجتماعي، يؤدي الخطاب إلى تعميق الانقسام داخل المجتمعات المحلية عبر فرض ثنائية حادة بين “المؤمنين الصادقين” و”المنافقين المتخاذلين”. هذا التقسيم لا يبقى نظريًا، بل يتسرّب إلى تفاصيل الحياة اليومية — في المساجد، والمدارس، ووسائل التواصل الاجتماعي — حيث يُعاد تعريف الانتماء الديني بمعايير الولاء للتنظيم لا للدين نفسه. النتيجة هي تفتيت النسيج الاجتماعي، وتحويل الاختلاف في الرأي إلى عداوة وجودية، ما يضعف قدرة المجتمعات على بناء توافق أو تبنّي خطاب وطني جامع.
أما على المستوى الثقافي والأخلاقي، فيُسهم الخطاب في إعادة إنتاج منطق العنف كقيمة معيارية. حين يُقدَّم القتال والتضحية الدموية بوصفهما المقياس الأعلى للإيمان والرجولة، يتحوّل العنف من استثناء إلى قاعدة أخلاقية. هذا التحول يترك آثارًا عميقة في الوعي الجمعي، إذ يصعب بعده إعادة دمج الأفراد الذين تبنّوا هذه الرؤية في منظومات مدنية تؤمن بالتعددية والسلم الاجتماعي. وتزداد خطورة هذا الأثر حين يُغلف بخطاب ديني يمنح العنف مشروعية رمزية يصعب منازعتها بالعقل وحده.
وتدعم هذا التقييم دراسات صادرة عن مراكز أبحاث متخصصة في شؤون التطرف والإعلام، مثل مركز “كويليام” في بريطانيا، ومعهد “ستيمسون” الأميركي، ومبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT). تؤكد هذه الأبحاث أن الذراع الإعلامية للتنظيمات المسلحة تُعدّ عنصرًا بنيويًا في استمرارها، لأنها لا تكتفي بتبرير أفعال العنف، بل تعيد إنتاجها نفسيًا في أذهان المتلقين. وبهذا المعنى، فإن الخطر لا يكمن فقط في الرسالة نفسها، بل في قدرتها على التحول إلى منظومة رمزية تعيد إنتاج التطرف جيلاً بعد جيل.
خلاصة تقييمية وتوصيات
تُظهر القراءة التحليلية للافتتاحية أنها تمثل نموذجًا نمطيًا في أدبيات التنظيمات المتطرفة، يقوم على هندسة الوعي العقائدي من خلال لغة بسيطة ومنظمة، تستثمر في المفاهيم الدينية لتصنع اصطفافًا حادًا بين “المؤمن” و”المنافق”. هذه البساطة الأخلاقية تمنح الخطاب قدرة على النفاذ إلى الجمهور غير المتخصص، خصوصًا في بيئات يغيب عنها الوعي النقدي والبدائل الفكرية. إلا أن هذا الخطاب، رغم فعاليته التعبوية الداخلية، يعاني من هشاشة بنيوية، إذ يعتمد على منطق عاطفي منفصل عن المعطيات الاجتماعية والشرعية، ويقدّم تفسيرات جاهزة بدل النقاش العقلاني أو التأويل المنهجي للنصوص.
كما يتضح أن الخطاب يؤدي وظيفة مزدوجة: فهو من جهة وسيلة للحشد والتعبئة، ومن جهة أخرى أداة لـ حماية الهوية التنظيمية عبر تحويل الهزائم إلى رموز صمود. هذه القدرة على إعادة تعريف الفشل تمنح التنظيم طاقة استمرارية رمزية، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن عجز عن مواجهة الواقع بموضوعية، إذ يتم إحلال “المعنى الإيماني” محل التحليل الواقعي، فيتحول النص إلى منظومة تعويض نفسي أكثر من كونه بيانًا سياسيا أو عسكريًا. هذه المفارقة هي ما يجعل الخطاب قويًا في الداخل وضعيفًا في الخارج، لأنه يخلق عزلة فكرية مغلقة لا تنفتح على الحوار أو المراجعة.
ولمواجهة مثل هذا الخطاب بفاعلية، لا بد من اعتماد منهجية للرصد والتحليل المبكر. المطلوب ليس فقط تتبّع المواد الإعلامية المتطرفة بعد صدورها، بل بناء وحدات تحليل لغوي ونفسي تتابع أنماط المفردات والرموز المستخدمة في نصوص التنظيمات. هذا التحليل الاستباقي يمكن أن يكشف التحولات في خطاب التنظيم، ويتيح صياغة ردود توعوية موجهة للجمهور قبل أن تترسخ الدعاية. وهو ما أثبت نجاحه في تجارب أوروبية حيث تمكّنت وحدات المراقبة الرقمية من إضعاف أثر دعاية داعش بين عامي 2016 و2019.
أما على الصعيد الشرعي، فالحاجة ماسة إلى خطاب ديني تفسيري بديل يُقدَّم بلغة علمية قريبة من الناس، ويرتكز على المنهج الأصولي الصحيح في فهم النصوص: أي الجمع بين النص والسياق والمقاصد الشرعية. هذا النوع من الخطاب لا يكتفي بالردّ النظري، بل يشرح للناس الخلفيات التاريخية للنصوص التي يسيء التنظيم استخدامها. وعندما يَظهر للمستمع أن الآية أو الحديث الذي يستند إليه المتطرفون منقوص من سياقه، يضعف تأثيرهم تلقائيًا.
إلى جانب المواجهة الفكرية، من الضروري التركيز على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الشباب فريسة سهلة للخطابات المتطرفة. البطالة، وغياب العدالة الاجتماعية، والشعور بالإقصاء من المجال العام، كلها عوامل تخلق أرضية خصبة للتجنيد. لذلك ينبغي تطوير برامج تعليمية ومهنية بديلة تمنح الشباب معنى للانتماء من خلال العمل والمشاركة المدنية، بدل أن يجدوه في التنظيمات المغلقة. تجارب إعادة الإدماج في بعض الدول الإفريقية والعربية أثبتت أن توفير فرص عمل وتدريب يقلص قابلية الشباب لتصديق الدعاية الجهادية.
وأخيرًا، يجب العمل على تعزيز السرديات المدنية والإيجابية التي تعيد تعريف مفاهيم مثل الشجاعة والالتزام والتضحية. فبدل أن يُربط مفهوم البطولة بالعنف والموت، يمكن أن يُعاد ربطه بالعطاء الاجتماعي، والابتكار، وخدمة المجتمع. دعم الإعلام المحلي، والقصص الواقعية عن مبادرات ناجحة في التعليم والتنمية، يسهم في بناء وعي جماعي مقاوم للدعاية المتطرفة. وفي موازاة ذلك، يبقى دعم البحوث الميدانية ضروريًا لقياس الأثر الفعلي لمثل هذه الخطابات، واستناد السياسات الوقائية إلى بيانات واقعية تُمكّن من تصميم تدخلات مكيّفة مع خصوصية كل مجتمع.