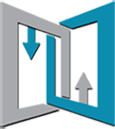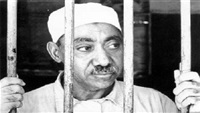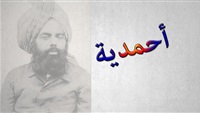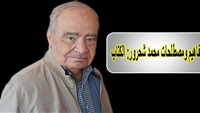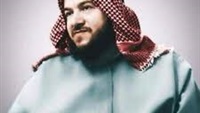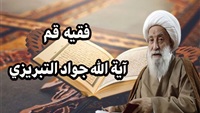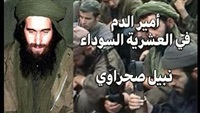إعادة تدوير التكفير: البلاغة الوعظية في خدمة المشروع الداعشي
الأحد 12/أكتوبر/2025 - 02:28 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
في التاسع من أكتوبر 2025، نشرت صحيفة «النبأ»، الذراع الإعلامية الأبرز لتنظيم داعش، افتتاحية حملت في ظاهرها نَفَسًا وعظيًا يدعو إلى الإيمان والعمل الصالح، لكنها في عمقها مثّلت تحولًا لافتًا في الخطاب الأيديولوجي للتنظيم. فبعد أن كان التنظيم يُخاطب أتباعه بمنطق “الخلافة والتمكين” إبّان ذروة تمدده في العراق وسوريا، عاد اليوم إلى لغة الوعظ الفردي والإصلاح النفسي، محاولًا استبدال فشل السلاح ببلاغة النصوص الشرعية. هذه العودة إلى خطاب الإيمان واليقين ليست مجرد تبدّل في النغمة، بل هي إعادة تموضع اضطرارية لجماعة فقدت الميدان والسلاح والحاضنة، ولم يبقَ لها سوى “العقيدة” لتبرير بقائها واستدعاء شرعيتها القديمة.
تأتي أهمية هذه الافتتاحية من كونها مرآة لمرحلة ما بعد الهزيمة في مشروع “الدولة”، إذ يكشف تحليلها عن تحول أيديولوجي من الخطاب السياسي الجهادي إلى الخطاب العقدي الوعظي. فداعش الذي كان يُقدِّم نفسه بوصفه دولة الخلافة، أصبح اليوم يُخاطب أنصاره كجماعة مؤمنة مطاردة تحتاج إلى الثبات واليقين. من هنا، تتخذ اللغة الدينية في الافتتاحية وظيفة مزدوجة: تهدئة القاعدة الداخلية المأزومة من جهة، وإعادة تعبئة الخلايا النائمة فكريًا من جهة أخرى. والنتيجة أن “الإيمان” يتحول إلى غطاء بلاغي لإدامة مشروع العنف، في نصٍّ يقدّم نفسه موعظةً روحانية بينما يعمل في العمق على إعادة تدوير التكفير وتبرير القتال.
السياق العام:
تأتي افتتاحية صحيفة النبأ الأخيرة 516، والتي يصدرها تنظيم داعش في واحدة من أكثر اللحظات هشاشة في تاريخ التنظيم ، إذ يواجه التنظيم تراجعًا ميدانيًا واضحًا في معظم مناطق نفوذه، وتفككًا تنظيميًا في هياكله الإدارية والعسكرية. فبعد الضربات المتلاحقة التي تلقاها في سوريا والعراق والساحل الإفريقي، لم يعد يملك القدرة على التحكم بالميدان كما كان في ذروة تمدده، ما جعله يعيد ترتيب أدواته الخطابية ليعوض عجزه العسكري بخطاب دعوي عقدي يستهدف البنية النفسية والفكرية لأتباعه.
وفي ظل هذا الضعف المتزايد، تحولت صحيفة النبأ إلى المنبر الدعائي الأبرز الذي يحمل عبء “تثبيت العقيدة الجهادية”، بعدما غابت الانتصارات الميدانية التي كانت تشكل مادة التعبئة الرئيسية. لذلك لم تعد الافتتاحيات تركز على “التمكين” أو “الخلافة”، بل على مفاهيم إيمانية عامة مثل “الإخلاص” و“العمل الصالح” و“الابتعاد عن الوهم”، وهي مفاهيم تُقدَّم بلبوس وعظي لكنها تؤدي وظيفة أيديولوجية دقيقة: إعادة تأهيل المقاتل فكريًا ليصمد في عزلة التنظيم وانحسار نفوذه.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن قراءة الافتتاحية الأخيرة والصادرة مساء الخميس 9 اكتوبر 2025، كخطبة دينية عابرة أو نص وعظي موجه لعامة المسلمين، بل كجزء من استراتيجية تواصل داخلية تهدف إلى ضبط القاعدة التنظيمية نفسيًا وفكريًا، وإعادة إنتاج صورة “المؤمن المجاهد” بوصفها النموذج الأوحد للإيمان الحق. فالتنظيم، وهو يترنح بين فقدان السيطرة الجغرافية وتآكل الحاضنة الاجتماعية، يسعى عبر هذا الخطاب إلى إعادة تعريف الانتماء الديني ذاته وفق مقاييسه الخاصة، حيث يصبح الجهاد المسلح هو معيار الإيمان، والابتعاد عنه دليل “وهم” وانحراف.
وعبر هذا المنظور، يمكن القول إن افتتاحية النبأ تمثل محاولة لإحياء الثنائية الجوهرية في فكر “داعش”: ثنائية الإيمان والضلال أو النحن والآخر. فهي تعيد صياغة معادلة “نحن المؤمنون المجاهدون” مقابل “الآخرون الواهمون الضالون”، في تكرار لجوهر العقيدة الداعشية التي لا ترى في العالم إلا فسطاطين متقابلين. هذه الثنائية هي التي تمنح التنظيم مبرره الوجودي الأخير في لحظة الانحسار، إذ تبقي أفراده في حالة تعبئة دائمة ضد “الآخر” مهما كان، وتعيد تعريف “النجاة” لا بوصفها نجاة إيمانية عامة، بل التزامًا بمسار التنظيم ذاته باعتباره الطريق الوحيد إلى الإيمان الحقيقي.
موعظة الإيمان واليقين
تُقدِّم افتتاحية النبأ نفسها في ظاهرها نصًا وعظيًا تقليديًا، يقوم على استدعاء المفاهيم الإيمانية الكبرى كالإخلاص واليقين والعمل الصالح. فالقارئ للوهلة الأولى يواجه خطابًا يبدو متجذرًا في النص القرآني والحديث النبوي، يستدل بعبارات مأثورة مثل “ليس الإيمان بالتمنّي ولا بالتحيّلي ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل”، ويستدعي تفاسير الطبري وابن كثير وغيرهما من المفسرين الأوائل لإضفاء المصداقية الشرعية والاتصال بالتراث الإسلامي. هذه الصياغة المحكمة تمنح النص هالة من القداسة والسكينة، وتوهم القارئ أنه أمام موعظة تزكوية تسعى لإحياء الصلة بين الإيمان والعمل، لا أكثر.
لكن التدقيق في اختيار الآيات وطريقة توظيفها يكشف أن الخطاب ليس بريئًا ولا عفويًا. فالكاتب يتعمّد اقتطاع النصوص من سياقها، ليؤسس لفكرة أن الإيمان لا يُثبت إلا بالفعل، ثم يُعرّف “الفعل” ضمنيًا بأنه القتال والجهاد في سبيل الله كما يراه التنظيم. بذلك يتحول المفهوم القرآني المفتوح لـ“العمل الصالح” إلى مفهوم مؤدلج يختزل الإيمان في ممارسة العنف، ويستبعد كل صور العبادة والعمل المدني والاجتماعي، في عملية تضييق مقصودة للمعنى تُحوّل الدين من فضاء أخلاقي جامع إلى أداة فرز واستبعاد.
ويظهر كذلك أن النص يسعى إلى تأثيث مشهد ديني رمزي يقوم على المعارضة بين “المؤمن الصادق” و“الواهم المدّعي”. فبينما يردّد المفسرون القدامى أن الإيمان يُختبر بالعمل والاتباع، يوظف كاتب الافتتاحية هذه المقولة ليبني عليها حكمًا قيميًا حادًا ضد المجتمع المعاصر، متهِمًا المسلمين الذين لا ينخرطون في مشروع التنظيم بأنهم “يعيشون على الأماني والأوهام”. هكذا تُحوَّل الموعظة إلى أداة إدانة، وتصبح كل ممارسة إسلامية خارج إطار التنظيم نوعًا من الخداع الذاتي أو الانحراف عن “الحقيقة الإيمانية”.
وفي العمق، تكمن خلف هذا الهدوء البلاغي نواة خطاب أيديولوجي متشدد يعيد إنتاج فكرة “الإيمان الحصري” التي طالما شكّلت أساس فكر داعش. فالنص لا يدعو إلى الإخلاص لوجه الله، بل إلى الإخلاص لنسق التنظيم نفسه بوصفه الممثل الوحيد للإيمان الصحيح. ومن خلال استخدام لغة دينية هادئة وأسلوب وعظي متزن، يخفي الكاتب مشروعًا لتجديد شرعية العنف والتكفير تحت غطاء الإيمان والعمل، حيث يُعاد تعريف “الإيمان الحق” على أنه التزام بخط الجهاد كما ترسمه القيادة الداعشية، بينما يُدفع كل مخالف – مهما بلغت تقواه – إلى خانة “الوهم” و“الضلال”. وبهذا المعنى، تتحول الموعظة من دعوة للإصلاح الروحي إلى أداة لإعادة إنتاج الفكر الإقصائي نفسه، في ثوب لغوي أكثر لُطفًا وأقل صدامية ظاهرًا.
الرسائل المضمرة:
الافتتاحية توظف لفظة «الوهم» ليس كصفة معنوية فحسب، بل كمفتاح أيديولوجي محكم يقسّم العالم الإسلامي إلى فسطاطين متقابلين. في هذا التقسيم، تصبح الهوية الدينية مرهونًة بنمط سلوكي واحد ومحدَّد: إما أن تكون «مؤمناً مجاهداً» بالمفهوم الداعشي، أو «واهمًا» و«مدّعيًا» بالإيمان إذا اكتفيت بالشعائر والانتساب الاسمي. بهذا التحويل تُحوَّل مسألة عقيدة شخصية وسياسة اجتماعية معقَّدة إلى معيار ثنائي قاطع، يقف وراءه منطق استبعادي يُبرر التفريق والتكفير وإلغاء مشروعية الآخر داخل الأمة نفسها.
كما أن هذا التقسيم يخدم وظيفةً تنظيمية داخلية واضحة: إذ يوظف خطاب «الوهم» كآلية لاحتواء الشكوك والاختلافات الداخلية، ولتجريد المعارضين أو المترددين من صفة الإيمان الشرعي. بذلك يتجاوز النص مجرد النقد الوعظي إلى إقامة محكمة أخلاقية وعقائدية تقضي مسبقًا على شرعية كل من لا ينسجم مع فقه التنظيم السياسي والعسكري. ويصبح «الواهم» هنا مرادفًا للمجتمع المدني، للفصائل المنافسة، وللهيئات الدينية التي تبتعد عن السلوك المسلح، ما يفتح بابًا واسعًا لتبرير العنف ضد جماعات وصِيَغ اجتماعية متنوعة تحت مسمى «التخلي عن الإيمان».
من الناحية الخطابية والدلالية، يضخ الكاتب في بنية النص استثمارًا مقصودًا لآيات قرآنية وألفاظ نبوية تختزل معنى العمل الصالح في إطار جهادي محدد. فالآيات التي تتحدث عن الجزاء والثواب تُختزل في سياقها المقصود ليُفهم منها أن «النجاة» مرتبطة بالانخراط في مسار القتال وفق رؤية التنظيم، لا بالأعمال الخيرية أو الالتزام الشرعي العام. هذه المقاربة تُنتج قراءة نصية اختيارية تُهمّش التنوع الشرعي والاجتهادي داخل الإسلام، وتحوّل النصوص الجامعة إلى أدوات تأطير أيديولوجي لصالح خطاب يستعيد احتكار تعريف «الصلاح» و«الإيمان».
وأخيرًا، لهذه الرسائل المضمرة أثر مباشر في المجال الاجتماعي والسياسي: فهي تشرعن شرعية العنف وتعمّق الانقسامات داخل النسيج الاجتماعي المسلم، وتفكك أي مشروع توافق مدني أو جهود مصالحة بين الفصائل. كما أنها تُضعف خطاب الاعتدال والمرجعية الدينية التقليدية عبر توجيه الاتهام العام إليها بأنها «وهم»، ما يؤدي إلى تجميد أي حوار داخلي وإغلاق باب الاجتهاد، ويزيد من عزلة التنظيم لكنه في الوقت نفسه يجعل من كل مخالِف هدفًا مشروعًا لإعادة التوجيه بالقوة.
وعظ يتخفّى خلفه التحريض
الافتتاحية مبنية على هيكلية خطابية محكمة تُظهر من اللحظة الأولى وعيًا منظوميًا بكيفية توجيه الرسالة: تبدأ بتمهيد وعظي مألوف يسحب القارئ إلى منطقة السرد الديني الحميمة. اختيار الحديث النبوي أو العبارة القرآنية الافتتاحية ليس صدفة؛ هو محاولة لاستدعاء «السلطة الشرعية» والارتباط بالتراث السلفي لكي ينظر القارئ إلى النص بوصفه وصية مرجعية لا تُمسّ، فتقل احتمالات التشكيك وتزداد فرص الامتثال الذهني أولاً قبل السلوكي لاحقًا.
ثم ينتقل الخطاب إلى طبقة الاستدلال القرآني والتفسيري، حيث تُستدعى أقوال المفسرين القدامى كطبقة ثانية من الصدقية التاريخية. هذا التوظيف للتفاسير ــ غالبًا باقتطاع وانتقائية ــ يمنح الافتتاحية هالة علمية من داخل التراث ذاته ويجعلها تبدو كخلاصة مجمعة للعلم الشرعي، لا كبيان دعائي. بتلك الخطوة يتحول النص إلى ما يشبه «تقرير فتاوى» مبسّط يهدف إلى تثبيت قراءات محددة للنصوص تُلائم أهداف التنظيم وتقصي قراءات مخالفة أو معتدلة.
في المرحلة التالية يوفّر الكاتب جسرًا إلى الواقع الاجتماعي عبر نقد موجز لـ«الناس اليوم» — الذين يُصوّرون كغارقين في الأماني والوهم — وبذلك يُحدِث انقسامًا تصوريًا بين عالمين: عالم الدين الحقيقي، وعالم المظاهر الفارغة. هذا التحول سردي مهم لأنّه يحول القارئ من متلقٍ سلبي إلى شاهد مُدان: ليس عليه فقط أن يصدق البلاغة، بل أن يستشعر مسؤولية أخلاقية تجاه ما يُعرض عليه كحقيقة مُستترة. وبذلك تُهيّأ الأرضية النفسية لقبول ما سيأتي لاحقًا من أحكام واستدعاءات للفعل.
أخيرًا تأتي الخاتمة التحريضية كقطبة مغناطيسية تربط الإيمان بالجهاد والاتباع والثبات، فتُغلق الدائرة الخطابية في غاية تعبئوية واضحة. هذه الخاتمة لا تكتفي بدعوة معنوية، بل تقوم بعمليات ترسيخ معرفي ونفسي: تعريف «العدو» وتبرير استهدافه، تحييد النقد الداخلي، وتحويل الحيرة إلى فعل مؤجَّل يُبرر العنف كخيار وحيد للنجاة. وبهذه الخُطى تتحول الافتتاحية من وعظ ظاهر إلى منظومة دعائية داخلية تعمل على تثبيت الولاء وإبطال البدائل السلمية، مما يجعلها أكثر خطورة من نص وعظي بسيط لأنه يخفي تحريضًا منظّمًا وراء ثياب الكلمات الطيّبة.
السياق المحلي والإقليمي:
تكتسب افتتاحية النبأ أهميتها من السياق المحلي الذي يمر به تنظيم "داعش"، إذ تعيش فروعه في العراق وسوريا مرحلة انكماش ميداني غير مسبوقة. فقدت خلاياه القدرة على الحركة الواسعة، وتعرضت بنيته اللوجستية لضربات قاسية من التحالف الدولي والقوات المحلية، كما تراجعت شبكاته المالية وخطوط إمداده. في هذا المناخ، لم يعد الخطاب العسكري أو بيانات الانتصار ممكنة، فاضطرت أذرعه الإعلامية إلى اللجوء مجددًا إلى ما يمكن تسميته بـ«المنابر العقدية»، حيث يتحول النص الوعظي إلى وسيلة لتعويض فقدان السيطرة الميدانية، واستدعاء مشاعر الإيمان والثبات لإخفاء مظاهر الضعف والانحسار التنظيمي.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن فصل هذا التوجه عن تطورات الجبهة الإفريقية، حيث شهدت منطقة الساحل ــ خصوصًا مالي وبوركينا فاسو والنيجر ــ انتكاسات متتالية للتنظيمات الموالية لـ«داعش» بفعل الضربات الجوية والتنسيق الإقليمي ضدها. هذا التراجع الميداني دفع الجهاز الدعائي المركزي إلى تبنّي خطاب أكثر روحانيةً ظاهريًا، يعيد التركيز على الإيمان والعمل واليقين بدلاً من الغزو والتمكين. غير أن هذا التحول لا يعكس اعتدالًا حقيقيًا، بل هو تكتيك لإعادة التعبئة النفسية وإعداد القواعد الأيديولوجية لمرحلة جديدة من العنف، حيث يصبح الإيمان ذاته مقدمة للجهاد لا بديلاً عنه.
أما في السياق الإقليمي الأوسع، فتأتي الافتتاحية في قلب صراع أيديولوجي متجدد بين التنظيم وخصومه من التيارات الجهادية الأخرى، وعلى رأسها «القاعدة». فالأخيرة تحاول منذ سنوات الظهور بصورة أكثر «اتزانًا» و«انضباطًا شرعيًا»، مستفيدة من انهيارات «داعش» لتقديم نفسها كبديل أكثر «نضجًا» وأقل اندفاعًا. أمام ذلك، تسعى «النبأ» إلى نزع هذه الشرعية عن القاعدة عبر إعادة احتكار مفهوم الإيمان، وتصوير خصومها بأنهم أهل دعوى ووهم لا عمل وجهاد، وبذلك تخلق حالة استقطاب داخلي تعيد من خلالها تثبيت هوية التنظيم كحارس «الإيمان الحق».
في المقابل، يواجه «داعش» أيضًا حملة فكرية من التيارات السلفية الدعوية التي تشن عليه نقدًا عقائديًا حادًا، متهمةً إياه بالغلو والتكفير غير المنضبط. ومن هنا يحرص خطاب الافتتاحية على الردّ غير المباشر، بالتأكيد أن التنظيم وحده يمثل «الملة الحنيفية» وأن كل ما عداه انحرافٌ عن «الحق الأول». هذه اللغة المضمرة لا تستهدف النقاش الفكري، بل تسعى لخلق تمايز عقدي صارم يحمي القاعدة الداخلية من الاختراق أو التشكيك، ويعيد إنتاج القناعة القديمة بأن التنظيم هو الطائفة المنصورة التي لا يصح الإيمان إلا بالانتماء إليها.
الرسائل المسكوت عنها:
ورغم ما تحمله الافتتاحية من صياغة حادة ونبرة يقينية ظاهرة، فإن القراءة المتأنية تكشف عن تحوّل خفي في خطاب التنظيم، يشي بقدرٍ من الارتباك الداخلي والدفاع عن الذات أكثر مما يعكس ثقة في الموقف. فالنص، الذي يبدو في ظاهره هجومياً على الآخرين، يتضمّن في باطنه اعترافاً ضمنياً بتآكل الهيمنة الفكرية والرمزية للتنظيم، إذ يلوح وكأنه يرد على اتهامات وُجهت إليه لا أنه يهاجم خصومه من موقع قوة. هذه النغمة الدفاعية تعكس وعياً مأزوماً داخل الجهاز الدعائي لـ«داعش»، الذي يحاول تبرير تراجعه عبر إعادة تعريف الإيمان والتقوى بما يتناسب مع موقعه الجديد كجماعة مطاردة لا كـ«دولة» قائمة.
ويبدو أن استخدام مفهوم «الوهم» في هذا السياق لا يستهدف فقط خصوم التنظيم في الخارج، بل يتضمن إشارة داخلية موجهة إلى صفوفه ذاتها. فالتنظيم يعيش منذ سنوات على وقع انشقاقات متكررة، خاصة في ولايات غرب إفريقيا والشام، حيث تزايدت النزاعات بين القادة والمقاتلين حول الشرعية الدينية والولاء المركزي. بهذا المعنى، يصبح الحديث عن «الوهم» وسيلة لتطهير الصف الداخلي من الشكوك والتمرد، وللتأكيد على أن أي خروج عن القيادة المركزية هو انحراف عن «الإيمان الصادق». أي أن الخطاب الوعظي هنا يؤدي وظيفة تأديبية داخلية بقدر ما يؤدي وظيفة تحريضية خارجية.
أما التركيز المتكرر على مفاهيم مثل «ملة إبراهيم» و«العمل الصالح» في مقابل غياب شبه تام لأي ذكر لمصطلحات كانت يوماً مركزية كـ«الخلافة»، و«التمكين»، و«الولاية»، فيكشف عن انكماش أيديولوجي واضح في مشروع التنظيم. فبدلاً من الخطاب السياسي الديني الذي يدّعي القدرة على إقامة دولة وتطبيق الشريعة، عاد التنظيم إلى اللغة العقدية الوعظية التي تذكّر بمرحلة ما قبل 2014، أي قبل إعلان «الخلافة». هذه العودة ليست خياراً روحياً بل اضطراراً نابعاً من العجز عن تجسيد الوعود السابقة في الواقع، ومن ثمّ يصبح التركيز على الإيمان الفردي بديلاً عن المشروع الجماعي الذي انهار.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن الافتتاحية تكشف عن مرحلة انتقالية يعيشها «داعش»: من حركة تدّعي العالمية والسيطرة، إلى جماعة تبحث عن بقاء رمزي في حيز الإيمان والمظلومية. هذا التحوّل من «مشروع دولة» إلى «دعوة إيمانية» هو في حد ذاته شكل من أشكال الهزيمة الأيديولوجية، وإن حاول الخطاب إخفاءه خلف ستار النصوص الدينية. فالتنظيم الذي كان يرى نفسه ممثلاً للحق المطلق، أصبح مضطراً لتبرير ذاته أمام أتباعه قبل خصومه، مبرهناً بذلك على أن الأزمة اليوم ليست في الميدان فقط، بل في جوهر الفكرة نفسها.
الأثر المتوقع: تعميق العزلة وتغذية العنف
يُتوقع أن يترك هذا الخطاب أثرًا بالغ الخطورة على المستوى المحلي، إذ يُعيد تنشيط الذهنية الانعزالية لدى الخلايا النائمة والأنصار المتخفّين للتنظيم. فالنص، الذي يتظاهر بالوعظ والتذكير بالإيمان، يمنح غطاءً عقديًا جديدًا للعنف، من خلال ربط «الإيمان العملي» بالجهاد القتالي، وتقديم الكفّ عن القتال بوصفه علامة ضعف في العقيدة. هذا الربط يُحوّل المقاتل السابق إلى مؤمنٍ ناقص، ويحوّل العودة إلى السلاح إلى فعل «توبة» واستقامة، وهو ما يمنح الخلايا النائمة مبررًا نفسيًا ودينيًا لاستئناف النشاط الإرهابي تحت شعار الالتزام بالإيمان الحقيقي.
وعلى المستوى الإقليمي، يسهم هذا الخطاب في إعادة تدوير مفردات «الجهاد ضد المسلمين» داخل المجال الدعوي الجهادي، في لحظةٍ تتراجع فيها المواجهة مع «العدو البعيد» — أي الغرب — لصالح التركيز على «العدو القريب»، أي الأنظمة والمجتمعات الإسلامية. هذا التحول في بوصلة العداء يُهدد بإطلاق موجة جديدة من العنف الداخلي، تكون ساحتها المدن الإسلامية ذاتها، ويُعيد إنتاج منطق «الفرز العقدي» بين المؤمنين الصادقين والمنافقين، ما يعني فتح الباب أمام اغتيالات وانقسامات اجتماعية وسياسية أوسع.
كما أن الخطاب، في بنيته العميقة، لا يوجَّه فقط إلى الخارج أو إلى الأعداء المفترضين، بل إلى جمهور التنظيم الداخلي نفسه. فهو محاولة واضحة لإعادة لحمة الصف المتشظي، وتوحيد الولاءات المبعثرة بعد الانشقاقات المتكررة. يقدّم النص مفهومًا جديدًا لـ«الوحدة» قائمًا على الولاء العقدي لا التنظيمي، أي على الإيمان بالمنهج لا بالقيادة، ما يتيح له استيعاب المترددين والناقمين من دون مراجعة حقيقية للمسار السابق. بهذا المعنى، لا يسعى التنظيم إلى التجديد أو المراجعة، بل إلى ترميم شرعيته المفقودة باستخدام لغة العقيدة.
في المحصلة، فإن الافتتاحية لا تمثل دعوة إلى إصلاح الإيمان أو تصحيح المفاهيم كما قد يوحي ظاهرها، بل هي خطوة في مسار إعادة بناء الشرعية الأيديولوجية لمشروع العنف ذاته. فباسم «الإيمان» يُعاد تبرير التكفير، وباسم «العمل الصالح» يُستدعى السلاح من جديد. إنها محاولة لبعث روح العداء في لحظة انكسار، وإعادة إنتاج الصدام بوصفه طريق الخلاص الوحيد، ما يجعلها نصًا تحريضيًا خطيرًا يزرع بذور دورة جديدة من العنف داخل المجالين المحلي والإقليمي معًا.
خلاصة
افتتاحية النبأ الصادرة في 9 أكتوبر 2025 تكشف عن تبدّل في لهجة الخطاب الداعشي دون تغيّر في جوهره. فالتنظيم، بعدما فقد أدوات السيطرة الميدانية، يحاول استعادة السيطرة الرمزية عبر إعادة تعريف الإيمان على مقاسه.
إنها محاولة لإنتاج إيمان بديل، يساوي بين “العمل” و“القتال”، ويحوّل النص القرآني من مصدر للهداية إلى أداة للفرز الأيديولوجي.
بهذا المعنى، يمثل النص مثالًا حيًا على تديين العنف عبر البلاغة الوعظية، وعلى استمرار مشروع داعش في صيغة دعوية جديدة، أقل ضجيجًا وأكثر خطورة في اختراق العقول.