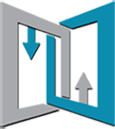سوق الكراهية: كيف يستثمر المتطرفون إجراءات الأمن الغربية كـ "نجاحات" دعائية؟
الجمعة 26/ديسمبر/2025 - 03:21 م
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
تأتي افتتاحية صحيفة "النبأ" الأخيرة والتي يصدرها تنظيم داعش المنشورة مساء الخميس 25 ديسمبر 2025، كنموذج صارخ للخطاب الدعائي الذي لا يكتفي بالتعليق على الأحداث، بل يسعى لإعادة هندسة الوعي الجمعي من خلال استثمار "سيكولوجية التوقيت". فباختيار مواسم الأعياد والمناسبات الرمزية، يحاول التنظيم المتطرف تحويل الفضاءات العامة من ساحات للاحتفال والتعايش إلى مسارح للرعب والمواجهة الحضارية المزعومة. إن هذا النص لا يهدف فقط إلى التحريض المباشر، بل يرمي بظلاله نحو تعميق الاستقطاب العالمي، مغذياً السرديات المتطرفة المتبادلة التي تقتات على مشاعر الكراهية وتغييب العقل لصالح الانفعال المتفجر.
وفي العمق من بنيتها الخطابية، تعمد الافتتاحية إلى توظيف ترسانة من الآليات الإقناعية المضللة، التي تبدأ بالتجريد من الإنسانية وتنتهي بقلب الحقائق الأمنية لتصويرها كـ "انتصارات وهمية". ومن خلال تفكيك هذه السردية، يتضح لنا أننا لسنا أمام مشروع سياسي أو ديني متماسك، بل أمام "أيديولوجيا عدمية" تقتات على استغلال الهشاشة الفردية لتحويلها إلى وقود في حرب استنزاف خاسرة. إن قراءة ما وراء الكلمات تكشف عن أزمة سردية خانقة تعيشها هذه التنظيمات، حيث يتحول خطاب "التمكين" السابق إلى خطاب "نكاية وانتقام" يائس، يحاول تعويض انحساره الميداني بصناعة بطولات ورقية في خيال أتباعه.
السياق العام للنص
تجيء هذه الافتتاحية في توقيتٍ مدروس بدقة، هو موسم الأعياد في أوروبا والغرب عمومًا، حين تتجه الأنظار عادة إلى الفضاء العام المملوء بالاحتفالات والرموز الدينية والاجتماعية. هذا التوقيت ليس بريئًا؛ إذ يدرك خطاب التنظيمات المتطرفة القيمة الرمزية العالية لهذه اللحظات، سواء لدى المجتمعات الغربية أو لدى الجاليات المسلمة المقيمة هناك. ومن ثمّ، يصبح النص محاولة لاستثمار هذه اللحظة الحسّاسة، ليس فقط للتعليق عليها، بل لتحويلها إلى منصة دعائية تعبّئ المشاعر وتعيد ترتيب الأولويات في أذهان المتلقين.
وتبني الافتتاحية سرديتها على استدعاء قاموس “الحرب الحضارية”، حيث تُقسّم العالم إلى معسكرين مغلقين متواجهين: “معسكر إيماني” مزعوم مقابل “معسكر صليبي–يهودي”. بهذه الثنائية الحادة يجري تبسيط واقع عالمي شديد التعقيد إلى لوحة صراع صفري، تُمحى فيها الفروق بين الدول والمجتمعات والأفراد، بل وحتى بين المدنيين والعسكريين. هذا التصنيف الإطلاقي يمنح التنظيمات المتطرفة مبررًا أيديولوجيًا لتبرير العنف، ويُنتج رؤية للعالم لا مكان فيها للتنوع أو المواطنة أو العلاقات الإنسانية العابرة للهويات الدينية.
وتحاول الافتتاحية أن تُدخل القارئ في مناخ نفسي محدد عبر التركيز المكثف على الإجراءات الأمنية المشددة في العواصم الأوروبية خلال موسم الأعياد. فتقرأ الانتشار الأمني، وإلغاء بعض الفعاليات أو تعديلها، لا بوصفها إجراءات حماية وقائية، بل بوصفها “ثمار نجاح” للهجمات الإرهابية. هنا يمارس النص عملية قلب دلالي: الخوف العام يصبح دليل قوة، والحذر الأمني يتحول في الخطاب الدعائي إلى اعتراف غير مباشر بتأثير التنظيم. وهكذا تُستثمر تفاصيل الحياة اليومية لتغذية سردية النكاية والتهويل.
وفي المستوى الأعمق، يعكس هذا الخطاب حالة عالمية من الاستقطاب المتبادل، يتقاطع فيها التشدد الديني مع صعود الشعبويات واليمين المتطرف في الغرب. فالافتتاحية لا تولد في فراغ؛ بل تتغذى على مشاعر الاحتقان، وصور الصراع، وحوادث الكراهية المتبادلة، لتعيد تدويرها في قالب ديني تعبوي. ومن خلال هذا التوظيف للسياق، يسعى النص إلى إقناع جمهوره بأن العالم يعيش مواجهة حضارية حتمية، في محاولة لقطع الطريق على أي سرديات بديلة تقوم على التعايش والمواطنة والشراكة الإنسانية.
البنية الخطابية وآليات الإقناع
تعتمد الافتتاحية على بناء خطابي يقوم على صناعة عالَمٍ ثنائي قائم على العداء المطلق، وتستخدم لذلك مجموعة من الأدوات الدعائية التي سبق توظيفها في أدبيات التنظيمات المتطرفة. فهي لا تتعامل مع النص باعتباره تحليلًا سياسيًا أو قراءة واقعية للأحداث، بل باعتباره وسيلة تعبئة وتحريض. لذلك تُصاغ الجمل بلهجة يقين حادّ، وتُقدَّم الاستنتاجات على أنها حقائق نهائية لا تقبل المراجعة. هذه اللغة القطعية تسعى إلى تعطيل التفكير النقدي لدى القارئ ودفعه إلى التلقي الانفعالي بدل التأمل العقلاني.
أولى هذه الأدوات تتمثل في التجريد الممنهج من الإنسانية. فغير المسلمين يُقدّمون في النص بوصفهم “كتلة صليبية–يهودية” متجانسة معادية بطبيعتها، بلا تمييز بين أفرادها أو سياقاتها. وبهذا التجريد تُلغى الفروق بين المدني والعسكري، بين رجل الدين والطفل والمرأة، ليصبح الجميع “أهدافًا مشروعة”. هذا المسار ليس لغويًا فقط، بل هو خطوة نفسية ضرورية لتبرير العنف، إذ يُسهل الانتقال من الاختلاف الديني أو السياسي إلى نزع القيمة الإنسانية عن الآخر بالكامل.
الأداة الثانية هي تقديس العنف وإعادة تسميته. فالأفعال التي تستهدف المدنيين تُعاد صياغتها لغويًا لتصبح “جهادًا نقيًا” و“فعلاً شرعيًا”، ويُمنح مرتكبوها وضعًا أخلاقيًا ساميًا. هذا الإطار يُخرج العنف من دائرة النقاش الإنساني والقانوني ليُدخله في نطاق المقدّس الذي لا يُنتقد. وهنا تكمن الخطورة؛ إذ لا يكتفي الخطاب بتبرير العنف، بل يرفعه إلى درجة العبادة، بما يخلق حافزًا قويًا لدى المتلقين للتماهي مع هذا النموذج والبحث عن معنى شخصي عبره.
وثالث هذه الأدوات هي الانتقائية النصية. فالافتتاحية تنتقي من التراث الديني ما ينسجم مع خطابها القتالي، وتتجاهل عمدًا تراثًا واسعًا من النصوص والمقاصد التي تؤكد حرمة النفس الإنسانية، وحقوق المخالفين في الدين، وضوابط الحرب، واحترام العهود والمواثيق. يتمّ فصل النصوص عن سياقاتها التاريخية والتفسيرية، ثم تُعاد قراءتها قراءة تجزيئية، لتتحول إلى شواهد مُعلّبة تُستخدم كوقود دعائي لا كمرجعية علمية رصينة. بذلك، يُستبدل الاجتهاد الفقهي المعقّد بقراءة شعاراتية تُشرعن العنف سلفًا.
أما الأداة الرابعة فهي قلب المعنى وإعادة تأطير الواقع. فبدل قراءة الإجراءات الأمنية في المدن الغربية باعتبارها محاولة لحماية المدنيين من مخاطر محتملة، يعاد تأطيرها باعتبارها دليل نجاح “تكتيكات الإرهاب”. بهذا القلب الدلالي يتحول الخوف العام إلى مكسب، ويصبح انشغال الدول بحماية مواطنيها علامة هزيمة لا مسؤولية. هذا الأسلوب يهدف إلى رفع معنويات الأنصار وإقناعهم بأن تأثير التنظيم مستمر حتى لو تراجعت قدراته الميدانية.
وتبرز كذلك تقنية تصنيع البطولة، حيث يُعاد تقديم منفذي الهجمات بوصفهم “نماذج ملهمة” و“أبطالًا” يُحتذى بهم. يتم تجاهل ضحاياهم بالكامل، كما يتم تجاوز المعاناة الإنسانية التي تخلفها هذه الأفعال. عبر هذا التصنيع الرمزي، يجري بناء خيال بطولي بديل يجذب الشباب المهمش أو الغاضب أو الباحث عن معنى، ليجد في العنف هويةً وانتماءً ورسالةً كبرى. وهكذا يصبح العمل الإرهابي ليس مجرد فعل إجرامي، بل “سردية حياة” يُدعى الأفراد للانخراط فيها.
وأخيرًا، يجمع النص بين كل هذه الأدوات ضمن إستراتيجية إقناع شاملة تستهدف العقل والوجدان معًا. فهو يقدّم تفسيرًا تبسيطيًا للعالم، ويمنح المتلقي إحساسًا زائفًا باليقين والاصطفاف الأخلاقي، ويُغرقه في لغة تعبئة قائمة على الظلم التاريخي والثأر والهوية المغلقة. هذه البنية الخطابية لا تشرح الواقع بقدر ما تُعيد تشكيله في وعي القارئ، بما يجعل النص ذاته جزءًا من ماكينة التجنيد والتطرّف لا مجرد تعليق أيديولوجي على الأحداث.
الرسائل المسكوت عنها
على الرغم من النبرة الواثقة واللغة المنتشية التي تظهر في الافتتاحية، فإن النص يكشف –من حيث لا يريد– عن طبقات متعددة من الضعف البنيوي. فخلف خطاب القوة والحسم، تبرز إشارات دالة على تراجع القدرات وتقلص النفوذ، تظهر في طريقة اختيار الموضوعات، وفي طبيعة الأفعال التي يُراد التحريض عليها، وفي غياب أي رؤية إيجابية للحياة أو المجتمع. هذه التناقضات بين الظاهر والباطن تجعل قراءة “الرسائل المسكوت عنها” ضرورة لفهم الموقع الحقيقي للتنظيم اليوم.
أولى هذه الرسائل تتمثل في الاعتماد المتزايد على الهجمات الفردية. فالافتتاحية تمجّد بصورة لافتة دور “المبادرات الفردية”، وتُكثر من الإشارة إلى أشخاص يعملون بمعزل عن بنية تنظيمية متماسكة. هذا التركيز لا يعكس اتساع القوة بقدر ما يكشف تراجع القدرة على التخطيط المركزي، وانحسار السيطرة الإدارية والجغرافية التي سبق أن شكّلت ركيزة الدعاية في مراحل صعود التنظيم. إن تقديم الفرد المعزول باعتباره النموذج الأعلى يدل ضمنيًا على غياب الهياكل المتماسكة التي كانت تُميّز مرحلة “المركز الموحّد”.
الرسالة الثانية تتمثل في الاعتراف غير المباشر بضيق الخيارات المتاحة. فالخطاب الذي يدعو إلى “استثمار أي فرصة” و“أي وسيلة متاحة” يشي بانتقال التنظيم من موقع الفاعل المنظم إلى موقع المحرّض الذي لا يملك سوى الخطاب. هذا التحول يعني الانتقال من نموذج “تنظيم يسيطر ويدير” إلى نموذج “شبكات خطابية” تعتمد على إثارة المشاعر وإطلاق الدعوات العامة غير المؤطرة تنظيميًا. وهو اعتراف ضمني بأن الإمكانات اللوجستية والعسكرية السابقة لم تعد متوافرة كما كانت.
كما يبرز في النص غياب كامل لأي مشروع سياسي أو اجتماعي قابل للحياة. فلا حديث عن إدارة شؤون الناس، ولا عن خدمات، ولا عن تصوّر للدولة أو المجتمع أو الاقتصاد. الافتتاحية لا تقدم إلا العنف باعتباره غاية بذاته لا وسيلة لشيء آخر. هذا الفراغ البرامجـي يفضح عجزًا عن تقديم بدائل واقعية، ويختزل الدين والسياسة معًا في دائرة الانتقام المستمر، وهو ما يعمّق الطابع nihilistic العدمي للخطاب ويجرده من أي مضمون إنساني.
ومن الرسائل المسكوت عنها أيضًا القلق من فقدان الجاذبية الجماهيرية. فالإفراط في اللغة التعبوية، والإصرار على صناعة بطولة قسرية، ومحاولة إعادة تفسير الواقع بوصفه انتصارًا دائمًا، كلها مؤشرات على شعور داخلي بتآكل الجاذبية التي كان التنظيم يتمتع بها في لحظات توسعه. إن كثافة الشعارات هنا تحلّ محل الحقائق الميدانية، ما يعني أن النص يشتغل لتعويض ما لا يمكن تحقيقه على الأرض عبر الإيحاء النفسي.
كما يعكس الخطاب عزلة متزايدة عن الواقع العالمي والإسلامي على السواء. إذ لا يظهر أي وعي بتعقيدات أوضاع المسلمين في بلدان متعددة، ولا باختلاف تجاربهم، ولا بوجود تحديات معيشية واقتصادية واجتماعية تحتاج حلولاً عقلانية. يتمّ اختزال العالم الإسلامي في “جمهور تعبئة” لا كشعوب لها مصالح وحقوق وتطلعات. هذا الاستعلاء الخطابي يُظهر المسافة الواسعة بين التنظيم والناس العاديين، ويكشف محدودية قدرته على إنتاج مشروع حضاري جامع.
أخيرًا، يكشف هذا كله عن أزمة سردية داخل التنظيم نفسه. فبعد أن كان الخطاب يتغذى على فكرة “الدولة” و“التمكين” و“الفتوحات”، لم يعد يملك اليوم سوى خطاب الاستنزاف والانتقام. إن الانتقال من وعود البناء إلى تمجيد الفوضى يعبّر عن تحوّل عميق: من أيديولوجيا تدّعي القدرة على إدارة المجتمع إلى أيديولوجيا تكتفي بتدمير المجتمع الذي تزعم الدفاع عنه. بهذه القراءة، تصبح الافتتاحية نفسها وثيقة على مرحلة انحسار أكثر منها إعلان قوة.
الدلالات الأيديولوجية والرمزية
تعتمد الافتتاحية على إعادة إنتاج ثنائية “الولاء والبراء” في أقصى صورها السياسية والأمنية، بحيث تُختزل العلاقة مع العالم في معادلة صفرية: إما اصطفاف كامل أو قطيعة كاملة. لا مكان في هذا التصور لأي مساحات للتعاون الإنساني أو العيش المشترك أو المواطنة أو الحقوق المتبادلة. هذه القراءة المتشددة تنقل مفهومًا عقديًا خاصًا إلى المجال السياسي والاجتماعي بصورة قسرية، فتتعامل مع المخالف الديني باعتباره خصمًا وجوديًا لا شريكًا في المجال العام. بهذا يصبح الصدام خيارًا وحيدًا، وتُلغى إمكانات الحوار أو التسويات أو التعارف المتبادل التي نصت عليها قيم إنسانية ودينية واسعة.
وتشتغل الافتتاحية على صناعة ذاكرة صراعية من خلال الاستخدام المكثف لمصطلح “الصليبيين”. فالمصطلح لا يُستعمل هنا بوصفه توصيفًا تاريخيًا باردًا، بل كأداة تعبئة رمزية تستحضر قرونًا من الحروب الدينية وتعيد إسقاطها على اللحظة الراهنة. بهذا يتمّ تحريك مشاعر الثأر والانتقام، واستدعاء صور الماضي بصورتها الأكثر دموية لفرض قراءة حاضرة للعلاقات الدولية. إنّه تاريخ مصطنع يُنتقى بعناية ليغذّي ذاكرة الجراح، ويغفل تمامًا قرونًا أخرى من التعايش والتبادل الثقافي والتجاري بين المسلمين وغيرهم.
كما يقدّم النص نسخة مغلقة من الهوية الدينية تربط الإيمان بالعنف ربطًا مباشرًا، وتقدم القوة العسكرية باعتبارها التعبير الأسمى عن التدين. في هذا الإطار تُمحى الحدود بين الدين، باعتباره منظومة أخلاقية وروحية تقود إلى بناء الإنسان والمجتمع، وبين مشروع سياسي دموي يسعى إلى فرض ذاته بالقهر. تمزج الافتتاحية بين المستويين عمدًا، بحيث يبدو الرفض للعنف وكأنه ضعف في الإيمان، ويبدو الاختلاف السياسي وكأنه انحراف عقدي. هذا الخلط يقوّض إمكانات التدين المتصالح مع القيم الإنسانية ويحتكر الحديث باسم الدين.
وفي مستوى أعمق، تكشف هذه الدلالات عن محاولة لخلق هوية جماعية بديلة تقوم على الإقصاء لا على الانتماء المشترك. فبدل تعريف الذات من خلال قيم العدل والعلم والعمل والعمران، يُعرَّف المؤمن من خلال الصراع والتميّز العدائي عن الآخر. هذا البناء الرمزي يغلق الهوية على نفسها ويجعلها قابلة دومًا للتعبئة العنيفة، لأن وجودها يصبح مرهونًا باستمرار الصراع. وبهذا المعنى، لا تمثل الافتتاحية مجرد خطاب تعبوي عابر، بل محاولة لإعادة تشكيل المخيال الديني نفسه على صورة الحرب الدائمة.
الأثر الاجتماعي والسياسي لمثل هذا الخطاب
يؤدي هذا النوع من الخطاب إلى توسيع دوائر التطرف المتقابل، فهو لا يكتفي بإنتاج العنف داخل السياق الذي يصدر عنه فقط، بل يسهم في إعادة تشكيل خطاب يميني متشدد في المقابل. حين يُقدَّم العالم في صورة معسكرات متصارعة على أساس الهوية الدينية أو الحضارية، يجد المتطرفون في الغرب مادة إضافية لتأكيد سردياتهم عن “خطر المسلمين”، كما يجد المتطرفون داخل المجتمعات المسلمة ما يغذي إحساسهم بالحصار والاضطهاد. وبهذه الطريقة تدخل الأطراف المختلفة في حلقة مغلقة من الاستقطاب المتبادل، حيث يغذي كل طرف سردية الطرف الآخر.
ينعكس هذا الخطاب على علاقة الأقليات المسلمة بمجتمعاتها، فيُعمِّق فجوة عدم الثقة بين الطرفين. فالمسلمون المقيمون في الدول الغربية يتضررون مرتين: مرة من جرائم العنف التي قد تُرتكب باسمهم دون علاقة لهم بها، ومرة أخرى من موجات الشك والريبة والإجراءات المشددة التي قد تُفرض عليهم جماعيًا. وتتحول الحوادث الفردية إلى ذريعة لتوسيع الصور النمطية، فتتراجع فرص الاندماج الإيجابي، ويُنظر إلى الأقلية ككتلة متجانسة يُخشى منها بدل أن تُعامَل كمواطنين متنوعين.
يشكّل هذا الخطاب محاولة واضحة لشرعنة العنف ضد المدنيين عبر تمييع الفارق بين المقاتل وغير المقاتل. فحين تُختزل المجتمعات بأكملها في وصف “العدو”، ويُستباح الجميع تحت دعاوى الثأر أو العقاب الجماعي، يتم تقويض واحد من أهم الأسس الأخلاقية والقانونية التي قام عليها كل من الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الحديث. والخطر هنا لا يقتصر على التنظير، بل يمتد إلى إنتاج بيئة نفسية تُسهِّل تبرير الاعتداء على الأبرياء، وتكسر الحواجز الأخلاقية أمام استهدافهم.
يمتد الأثر غير المباشر لهذا الخطاب إلى المجال العام والسياسات العامة في الدول المختلفة، حيث يدفع الحكومات إلى تبني إجراءات أمنية أشد صرامة وتشديد الرقابة على الفضاءات العامة والإعلامية والرقمية. ومع تكرار الأحداث العنيفة، يصبح الأمن أولوية مطلقة تُستخدم لتقييد الحريات العامة والتضييق على المجتمع المدني وتقليص مساحات النقاش. وهكذا يُعاقَب المجتمع بأسره، ويُعاد تشكيل المجال العام بطريقة أقل انفتاحًا وأكثر خوفًا، في دائرة مغلقة يكون فيها التطرف سببًا ونتيجة في آن واحد.
كيف يعمل هذا الخطاب على التجنيد؟
على المستوى النفسي يعمل الخطاب التجنيدي على منح الأفراد شعورًا سريعًا بالبطولة والمعنى. فالأشخاص الذين يشعرون بالعزلة أو الهامشية أو فقدان القيمة الذاتية يجدون في هذا الخطاب وعدًا بدور “استثنائي” يخرجهم من العادية. تُستعار مفردات الشجاعة والتضحية والريادة لتغطية فعل العنف، فيتحول الفرد من شخص يائس أو مهمّش في حياته اليومية إلى “بطل” داخل سردية أكبر، بما يخلق إغراءً نفسيًا قويًا خاصة لدى الشباب الذين يبحثون عن هوية ودور واضحين.
على المستوى المعرفي يبسط الخطاب صورة العالم إلى ثنائيات حادة: حق/باطل، مؤمن/كافر، نحن/هم. هذا التبسيط يلغي التعقيد الواقعي ويقدّم للفرد إجابات جاهزة بدل التفكير النقدي. وبهذا يتحول الواقع السياسي والاجتماعي المعقد إلى قصة صراع مطلق لا تقبل الرمادي أو التعدد، وهو ما يمنح المنتمين شعورًا باليقين والاطمئنان الفكري، حتى لو كان هذا اليقين مبنيًا على قراءة مشوهة أو انتقائية للواقع والدين معًا.
على المستوى الوجداني يستثمر الخطاب في مشاعر الغضب والظلم والإهانة المتراكمة لدى بعض الأفراد. تُستحضر صور المآسي والحروب والتمييز، ولكن بدل توجيه هذه المشاعر نحو العمل السلمي أو التغيير المدني، يتم توجيهها نحو فكرة الانتقام والعقاب. وهكذا يُعاد تشكيل طاقة الألم إلى دافع عنيف، ويُقنع الفرد بأن العنف ليس فقط مبررًا، بل هو التعبير “الطبيعي” عن غيرته على الدين أو الجماعة.
يجمع هذا الخطاب بين هذه الأبعاد الثلاثة ليصنع بيئة تجنيد متكاملة: هوية تمنح الانتماء، سردية تمنح اليقين، وشحنة عاطفية تدفع إلى الفعل. ومع تكرار الرسائل وغلق أي منافذ للنقد أو التساؤل، ينزلق بعض الأفراد تدريجيًا من التعاطف إلى التبرير ثم إلى الاستعداد للمشاركة. الخطر هنا لا يكمن في الفكرة وحدها، بل في قدرتها على تحويل الهشاشة الفردية والاجتماعية إلى قبول بالعنف بوصفه خيارًا مشروعًا ووحيدًا.
ما الذي يغفله النص عمدًا؟
يتعمد الخطاب تجاهل حقيقة مؤلمة مفادها أن الغالبية الكبرى من ضحايا هذه التنظيمات هم من المسلمين أنفسهم. فآلاف المدنيين قُتلوا أو شُرّدوا أو فُقدوا بسبب العمليات التي نفذتها جماعات متطرفة تزعم الدفاع عن الإسلام. لكن النص يتجاوز هذه الحقيقة كليًا، لأنه لو اعترف بها لانكشف التناقض بين ادعاء “نصرة الأمة” والواقع الدموي الذي يدفع المسلمون ثمنه قبل غيرهم.
يغفل الخطاب أن الإرهاب لا يضرب الأفراد فقط، بل يصيب بنية المجتمعات المسلمة في صميمها: يزعزع الأمن، يدمّر الاقتصادات المحلية، ويقوّض الحياة التعليمية والثقافية. المدن التي كانت آمنة ومزدحمة بالحياة تحولت إلى مناطق نزوح وخراب، والأسواق والمدارس والمستشفيات أصبحت أهدافًا أو ضحايا غير مباشرة للعنف. كل ذلك يُمحى من السردية الدعائية لصالح صورة رومانسية مزعومة لـ“الجهاد”.
يسكت النص عن الكوارث التي ألحقها التنظيم نفسه بالمناطق التي سيطر عليها: أنظمة قمعية، انتهاكات جسيمة للحقوق، فرض تأويلات متشددة على الناس، وتهجير واسع للسكان. بدلاً من الاعتراف بهذه الوقائع، يتم إنتاج خطاب يجمّل التجربة ويحوّلها إلى “يوتوبيا مفقودة”، بينما الحقيقة كانت واقعًا مليئًا بالخوف والبطش وانهيار الخدمات الأساسية.
يهمّش الخطاب تمامًا القيم الأخلاقية الكبرى التي تشكل جوهر الشريعة مثل الرحمة والعدل وحفظ النفس والكرامة الإنسانية. فبدل إبراز مقاصد الدين التي تؤكد حرمة الدماء وصون الإنسان، يُستبدل بها خطاب انتقامي يغلق باب الرحمة ويبرر القتل باسم الدين. وهنا تكمن أخطر عمليات التلاعب: تحويل دين يقوم على التعارف والعدل إلى لافتة لعنف لا يعترف لا بإنسانية الضحية ولا بحدود الأخلاق.
في مواجهة هذا الخطاب – ما العمل؟
لا يمكن مواجهة هذا الخطاب عبر المقاربة الأمنية وحدها، مهما كانت ضرورتها، لأن جذوره ليست أمنية فقط بل فكرية وثقافية واجتماعية. المطلوب مشروع متكامل يفكك الفكرة قبل أن تصل إلى مرحلة الفعل، ويحصّن المجال العام بحيث لا تتحول الأزمات والهشاشات الفردية إلى بوابة للتطرف. فالأمن يعالج النتائج المباشرة، أما الفكر والتربية والإعلام فيتعاملون مع الأسباب العميقة التي تصنع البيئة الحاضنة للعنف.
يظل تفكيك السرديات الدينية الزائفة عنصرًا محوريًا في المواجهة. ويتم ذلك من خلال قراءة علمية للنصوص الدينية في سياقاتها التاريخية واللغوية، وإبراز مقاصد الشريعة الكبرى التي تعلي من قيم العدل والرحمة وحفظ النفس. كما يشمل ذلك تصحيح المفاهيم المتعلقة بالجهاد، وأخلاقيات الحرب والسلم، والتأكيد على حرمة الدماء المدنية. هذا التفكيك ليس سجالًا لغويًا فقط، بل إعادة بناء خطاب ديني أخلاقي قادر على استعادة ثقة الشباب.
على المستوى الاجتماعي والتربوي، تمثل التربية على التعددية والمواطنة واحترام الاختلاف خط الدفاع الأهم ضد الاستقطاب. فالمجتمعات التي يشعر أفرادها بأنهم جزء أصيل من نسيجها تكون أقل عرضة للانجراف نحو العنف. ويستلزم ذلك تطوير مناهج التعليم، ودعم المبادرات الشبابية، وتوسيع المساحات العامة للحوار، بما يضعف السردية الثنائية “نحن/هم” التي يقوم عليها التطرف.
ينبغي أيضًا الإنصات الجاد إلى الشكاوى الحقيقية التي يستثمرها المتطرفون: مشاعر التمييز، الإقصاء، الفقر، وانسداد الأفق. معالجة هذه القضايا بوسائل عادلة وسلمية يقلل من قدرة الخطاب المتطرف على استغلالها. وإلى جانب ذلك، يلعب الوعي الإعلامي دورًا حاسمًا؛ إذ يساعد الأفراد على تمييز التلاعب بالصورة واللغة، وكشف آليات الدعاية التي تحوّل العنف إلى بطولة مزيفة. بهذه الأدوات المتكاملة يمكن تقليص مساحة الجاذبية لهذا الخطاب بدل الاكتفاء بملاحقة نتائجه.
خاتمة
الافتتاحية ليست مجرد “مقال رأي”؛ إنها نص تعبوي يسعى لتطبيع العنف وإعادة إنتاج عالم منقسم على ذاته. قوتها ليست في ما تعلنه فقط، بل في ما تزرعه من خوف وكراهية وتبسيط للواقع. قراءتها النقدية تكشف أنها تعبّر عن أزمة خطاب مأزوم يبحث عن معنى في الرماد، أكثر مما تعبّر عن مشروعٍ قادر على الحياة. إن تفكيك هذه اللغة، أخلاقيًا وفكريًا، شرطٌ أساسي لتجفيف منابع التطرف وحماية الإنسان – أيًّا كانت هويته ودينه – من أن يتحول إلى “وقود” في حروب دون معنى.