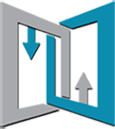الإسلام وحرية الرأي والتعبير (2)
الجمعة 20/فبراير/2026 - 12:16 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
يُقدم الدكتور عبد الرحيم علي في هذا الطرح تشريحاً فكرياً يتسم بالعمق والشجاعة، حيث نجح في تفكيك الإشكالية المزدوجة التي تحاصر مفهوم حرية الرأي في الإسلام، مفرقاً ببراعة بين جوهر النص الديني وبين التوظيف السياسي القمعي الذي مارسته تيارات وسلطات اتخذت من "الطاعة" وسيلة لشلّ العقل. إن هذا المقال لا يكتفي بالدفاع التبريري، بل يضع الإصبع على جرح "الازدواجية المعيارية" في الخطاب الغربي، ويدعو بوعيٍ مستنير إلى استعادة السؤال المعرفي بعيداً عن صراعات الأيديولوجيا، مما يجعل من سلسلته هذه مرجعاً نقدياً ضرورياً لإعادة بناء الوعي الإسلامي المعاصر وتحريره من جمود التقليد وسوء التأويل.
هل الإسلام ضد حرية الرأي؟
سؤال الغرب… وسوء نية البعض
منذ عقود، يُطرح سؤال حرية الرأي في الإسلام خارج سياقه الطبيعي، لا باعتباره بحثًا معرفيًا، بل كاختبار إدانة.
سؤال لا يُراد له أن يُجاب، بل أن يُستخدم.
وفي قلب هذا الاستخدام المتحيّز، تُرتَّب النتيجة قبل البحث:
أن الإسلام، بطبيعته، معادٍ للحرية.
لكن أي قراءةٍ جادّةٍ تُلزمنا بسؤالٍ سابقٍ على الاتهام:
هل يُدان دينٌ أو حضارةٌ من خلال أسوأ ممارسات لبعض أتباعه؟
أم من خلال نصوصه المؤسسة، ومنهجه في إدارة الاختلاف، وطبيعة العلاقة بين الدِّين والسلطة في تجربتها التاريخية؟
الطاعة… حين تُصادِرُ العقل
المأزق الحقيقي يبدأ من نقطةٍ تبدو في ظاهرها فضيلة: الطاعة.
فالطاعة، في الثقافة العربية، كثيرًا ما قُدِّمت بوصفها «فضيلة الفضائل»، وضمانة الاستقرار والتماسك، صالحةً – وفق هذا المنظور – لكل زمانٍ ومكان.
غير أن هذه «الفضيلة» حين تستند إلى تأويلٍ ديني جامد، وتُسخَّر لخدمة مصالح دنيوية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تتحوّل من قيمةٍ أخلاقية إلى داءٍ عضال؛ يُفضي إلى شلل العقل، ويقود إلى العجز عن الإبداع والتجديد، ويُعرقل كل رغبةٍ في التفكير الحرّ المستقل، وينتهي بنا إلى الاستسلام السلبي لمتغيرات واقعٍ معقّدٍ لا يكفّ عن التغيّر.
ولهذا، لا تُفاجئنا حقيقةٌ ثابتة:
أن الأنظمة الشمولية الديكتاتورية المتسلطة – على اختلاف نشأتها وأفكارها – لا تريد مواطنًا حرًّا يجرّب ويخطئ ويفكّر، بل تريد مواطنًا مُطيعًا، خائفًا، خاضعًا لكل ما هو موروثٌ جامد، وكارهًا لكل ما هو جديدٌ متجدِّد.
ومن المنطقي أن يقود هذا الجمود، والإعراض عن التجديد، والتشبّث بكل ما هو تقليدي «إستاتيكي»، إلى حالةٍ فكريةٍ خطيرة، تتجلّى في الاعتقاد اليقيني بامتلاك الحقيقة المطلقة، والصواب الذي لا يداخله الشكّ؛ إيمانٍ لا يرى إلا الماضي، ويتعلّق بالأفكار القديمة مهما تناقضت مع روح العصر وإيقاعه المختلف.
وهنا بالذات، يتبدّى جوهر الإشكالية:
هل ما يُمارَس باسم الإسلام هو الإسلام؟
أم أن كثيرًا مما يُصادَر من حريةٍ في مجتمعاتنا إنما هو ثمرة تحالفٍ قديم بين الطاعة السياسية والتأويل المغلق؟
لكن المفارقة: لماذا الإسلام وحده في قفص الاتهام؟
اذ أن سؤال «حرية الرأي في الإسلام» لم يُطرح بالحِدّة نفسها مع أديانٍ أو حضاراتٍ أخرى، رغم أن تاريخ القمع فيها موثّقٌ، ممتدٌّ، وأكثر دمويةً في بعض مراحله.
لكن الإسلام، تحديدًا، وُضع في قفص الاتهام الدائم، لا بسبب نصوصه، بل بسبب لحظةٍ سياسية وثقافية شهدت:
• صعود حركاتٍ أيديولوجية تتحدّث باسم الدِّين،
• وانفجار صراعات داخل المجتمعات الإسلامية،
• وتراجع دور الدولة الوطنية في أكثر من بلدٍ عربي.
في هذا المناخ، جرى الخلط المتعمّد بين:
الدِّين كنصّ،
والدِّين كخطابٍ سياسي،
والدِّين كممارسةٍ سلطوية.
وهنا بدأ سوء النيّة.
من يسأل… ولماذا؟
في كثيرٍ من النقاشات الغربية، لا يُطرح السؤال من باب الفضول المعرفي، بل من موقع التفوّق الأخلاقي المفترض.
الإسلام يُساءل دائمًا:
هل يسمح بالنقد؟
هل يقبل الاختلاف؟
هل يحتمل حرية التعبير؟
بينما نادرًا ما يُطرح السؤال ذاته عن:
حدود حرية الرأي في المجتمعات الغربية نفسها، أو عن «الخطوط الحمراء» غير المعلنة، أو عن القوانين التي تُقيِّد التعبير حين يمس «المقدسات السياسية» أو «الذاكرة الجماعية».
وهنا لا نتحدث عن مقارنةٍ تبريرية، بل عن ازدواجيةٍ معيارية:
حرية تُستَخدم معيارًا حين تخدم خطابًا بعينه، وتُقيَّد حين تمس روايةً سائدة.
سوء النيّة… وسوء الردّ:
وفي المقابل، لم يكن الرد الإسلامي دائمًا على مستوى التحدي.
فعوضًا عن تفكيك السؤال، والتمييز بين النص والممارسة، تحوّل الرد في كثيرٍ من الأحيان إلى:
• إنكارٍ كاملٍ لوجود المشكلة،
• أو دفاعٍ عصبيّ يبرّر القمع باسم «حماية الدِّين»،
• أو خطابٍ وعظيّ لا يخاطب العقل الحديث.
وهكذا، التقى سوء النيّة في طرح السؤال مع ضعف الإجابة، فخرج الإسلام خاسرًا في معركةٍ لم يُحسن المسلمون خوضها.
هل المشكلة في الإسلام… أم في السلطة؟
حين نراجع تاريخ القمع باسم الدِّين، نكتشف حقيقةً صادمة:
أن أغلب حالات خنق الرأي لم تكن دفاعًا عن العقيدة، بل دفاعًا عن السلطة.
السلطة التي تستخدم الدِّين لتأبيد نفسها،
والتنظيم الذي يحتكر الفهم ليمنع النقد،
والجماعة التي ترى في الاختلاف تهديدًا وجوديًا.
في كل هذه الحالات، لم يكن النص هو المشكلة، بل من أمسك به… وكيف استعمله.
لماذا نحتاج إلى إعادة طرح السؤال؟
لأن استمرار السؤال بصيغته الاتهامية، واستمرار الرد بصيغته الدفاعية، يعني بقاء الأزمة مفتوحة بلا أفق.
نحن لا نحتاج إلى تبرئة الإسلام أمام محكمةٍ وهمية، ولا إلى تبرير كل ما جرى باسمه، بل إلى إعادة السؤال إلى مكانه الصحيح:
كسؤالٍ معرفيّ، لا كسلاح.
في الحلقات القادمة، سنعود خطوةً إلى الوراء… إلى النص نفسه، لنسأل:
كيف تحدّث القرآن عن الحرية؟
نواصل غدًا…
باريس : الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.