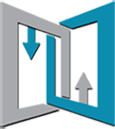الدين كأداة دموية: آليات التحريض في خطاب داعش الدعائي
الأحد 11/مايو/2025 - 03:25 ص
طباعة
 حسام الحداد
حسام الحداد
في عددها 494 الصادر يوم الخميس 8 مايو 2025، نشرت صحيفة النبأ، الذراع الإعلامية الرسمية لتنظيم داعش، افتتاحية حملت عنوانًا لافتًا: "فزت وربّ الكعبة". هذا العنوان مستلهم من مقولة منسوبة إلى الصحابي الجليل حرام بن ملحان، وردت في كتب السيرة النبوية، عندما طُعن غدرًا أثناء أدائه لمهمة دعوية في زمن النبي محمد ﷺ، فهتف بتلك العبارة تعبيرًا عن استشعاره للفوز بالشهادة رغم قتله غدرًا. باختيار هذا العنوان، يسعى تنظيم داعش إلى توظيف الرمز الديني والتاريخي لإضفاء مشروعية أخلاقية ودينية على عملياته العنيفة، وإعادة تأويل وقائع القتل والموت في سياق معاصر بوصفها تجليات للفوز الإلهي والرضا الرباني.
تعمل هذه الافتتاحية على إعادة إنتاج منظومة من الرموز والمقولات الدينية القديمة، وتُسقطها على الواقع السياسي الراهن ضمن سردية جهادية مغلقة. الخطاب هنا لا يُقدّم فقط مبررات أيديولوجية للعنف، بل يُعيد تشكيل وعي أنصاره عبر آليات لغوية ونفسية تهدف إلى تطبيع القتل وتجميله. من خلال هذه اللغة التعبوية، يتم تحويل الموت إلى احتفال، والمذبحة إلى نصر، والانتحار إلى شهادة، بما يخلق حالة وجدانية مغلقة تُلغي الحواس النقدية وتُعطل التفكير المستقل.
تحليل هذا النص من خلال منهج تحليل الخطاب (Discourse Analysis) يُظهر بوضوح كيف يستخدم التنظيم أدوات لغوية واستدعاءات دينية منتقاة بعناية لبناء سردية ذاتية تعزز القطيعة مع العالم الخارجي، وتُقصي كل رواية بديلة. فالنص لا يكتفي بتبرير العنف، بل يُعيد تشكيل المفاهيم الدينية التقليدية – كالـ"شهادة" و"الجهاد" و"النصر" – لتتلاءم مع أهداف التنظيم وممارساته العنيفة. وتتحول بذلك اللغة إلى أداة للهيمنة الأيديولوجية، تشتغل على الوجدان والدين والهوية في آنٍ معًا.
في السياق السياسي والأيديولوجي الأوسع، تعكس هذه الافتتاحية كيف يستثمر تنظيم داعش في الرموز التراثية لإعادة إنتاج خطاب تعبوي يتجاوز حدود الحدث الآني إلى مشروع طويل الأمد لصناعة الولاء والهوية. إنها محاولة لتأبيد المعركة، ليس فقط على الأرض، بل في العقول والقلوب. وهذا ما يجعل تحليل الخطاب الداعشي ضروريًا لفهم بنيته الداخلية وآليات تأثيره، خاصة في ظل تحولات ساحة الجهاد المعولم، وتنامي أدوات الإعلام الحربي الرقمي، وازدياد الحاجة إلى مقاربات نقدية تفكك هذا الخطاب من داخله.
البنية الخطابية والتركيز على الثنائية القيمية
تعتمد افتتاحية العدد 494 من صحيفة النبأ على بنية خطابية تتسم بالحسم القيمي، عبر تقديم ثنائيات متقابلة ومطلقة: مثل "الربح مقابل الخسارة"، و"الفوز الدنيوي مقابل الفوز الأخروي"، و"المجاهدون مقابل القاعدون". هذه الثنائيات لا تُطرح كخيارات تفاوضية أو اجتهادية، بل تُفرض كحدود فاصلة بين الإيمان والكفر، بين الفلاح والخذلان. ما يُراد من هذه البنية ليس الإقناع العقلي، وإنما استدعاء موقف وجداني حاد، يضع القارئ أمام اختبار أخلاقي حاسم: إما أن تكون مع "الحق" المتمثل في الجهاد والتضحية، أو مع "الباطل" المتجسد في الراحة والانكفاء.
الخطاب يتعمد نفي أي منطقة وسطى أو موقف تأملي قد يسمح بالحياد أو التفكير النقدي. فإما أن تكون "مجاهدًا" تنتمي إلى صفوة الله المختارة، أو "قاعدًا" من أهل الخذلان، ممن باعوا آخرتهم بدنياهم. هذا الإلغاء الممنهج لأي خيار ثالث يعكس رغبة التنظيم في احتكار التأويل الديني والشرعي، بحيث تصبح رؤيته للجهاد والموت هي المعيار الوحيد للتقوى والصلاح. بهذا الشكل، تُغلق كل منافذ الحوار أو الاجتهاد، ويُختزل الدين في معادلة دموية لا تقبل النقاش.
لا يستند هذا الخطاب إلى برهنة عقلية أو تحليل واقعي، بل يقوم على استثارة الانفعال العاطفي والوجداني. يتم توظيف مفردات من قبيل "الفوز الأعظم"، "الجنة"، "النصر الموعود"، في مقابل ألفاظ مثل "الخسران المبين"، "الذل"، و"الخذلان"، لصناعة حالة وجدانية تحفّز الانتماء القتالي وتؤسس لمنطق تضحوي متطرف. فبدل أن يُطلب من القارئ أن يفكر، يُدفع إلى أن يشعر، ويتحمّس، ثم ينخرط. وهذا بالضبط ما تحتاجه جماعات مثل داعش: وقود بشري غير متردد، يتخذ القرار بناءً على الانفعال لا العقل.
إن هذه البنية الخطابية المبنية على التقابل القيمي الحاد تُستخدم كأداة تحشيد فعالة. فعندما يُقابل "الحق الإلهي" بـ"الماديات الجاهلية"، و"الباقية" بـ"الفانية"، تصبح كل تفاصيل الحياة الدنيوية مشبوهة، ويُصبح الانتماء للجماعة والموت في صفوفها هو الخيار الوحيد المشروع دينيًا. بهذا الشكل، ينجح التنظيم في نزع الشرعية عن أي خطاب إصلاحي أو سلمي أو حتى واقعي، ويحول الجهاد إلى هوية شاملة، لا إلى فعل محكوم بشروط شرعية وأخلاقية دقيقة. إنه خطاب لا يهدف فقط إلى الإقناع، بل إلى الهيمنة النفسية وتوجيه القرار الفردي نحو التطرف.
استخدام النصوص الدينية خارج سياقاتها
تعتمد افتتاحية النبأ على اقتباسات دينية من القرآن والسنة تُنتزع من سياقاتها التاريخية والشرعية، وتُوظف في سياق تعبوي يخدم الأجندة القتالية للتنظيم. من بين هذه النصوص قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾، وكذلك قول الصحابي الجليل: "فزتُ ورب الكعبة" عند مقتله. هذه الآيات والأحاديث تُستخدم لا بوصفها مصادر للهداية والبيان، وإنما كشعارات دعائية تبرر الموت والقتل وتُضفي عليهما طابعًا من القداسة والتفوق الأخلاقي. النتيجة أن النص الديني يُفقد معناه الشامل ويُختزل في بعده القتالي فقط.
لا تقدم الافتتاحية أي إحالة إلى الضوابط الفقهية التي تؤطر مفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية. فلا ذكر لمبدأ "إعلان الإمام أو ولي الأمر"، ولا لشروط مشروعية القتال مثل دفع العدوان، أو التناسب بين الفعل ورد الفعل، أو حرمة التعرض للمدنيين. هذا التجاهل المتعمد للإطار الفقهي يُحول الجهاد من فريضة مشروطة إلى نشاط قتالي مطلق، مما يفتح الباب أمام العنف الفوضوي ويشرعن القتل على الهوية، حتى خارج ميدان القتال.
اللافت في الخطاب أن استخدام النصوص لا يهدف إلى بيان مقاصد الشريعة من حفظ النفس والدين والعقل، بل إلى إثارة الانفعال الديني لدى القارئ. فالنص القرآني لا يُعرض ضمن سياقه التفسيري أو المقاصدي، بل يُستدعى كعبارة مقتطعة تغذي إحساسًا بالتفوق الأخلاقي والبطولي لمن يختار "الاستشهاد". هذا النوع من الخطاب يعطل القدرة على التفكير النقدي ويُفضي إلى نوع من "التمجيد الديني للموت"، حيث يصبح القتل والقتل المضاد سُنة ممدوحة لا جريمة مدانة.
في المحصلة، ما يجري في هذا الخطاب هو تحريف منهجي للمفاهيم الدينية؛ إذ تُحوّل آيات الجهاد من أدوات دفاعية تحفظ كرامة الإنسان إلى أدوات تحريضية تُستخدم لتبرير الإرهاب. ويتم تغييب مفاهيم مركزية في الإسلام مثل العدالة، والرحمة، والنية، والمآل، لحساب مقاربة أحادية عنيفة تُختزل فيها الطاعة في القتال والولاء في سفك الدماء. وبهذا يتم تشويه العقيدة ذاتها وتحويلها إلى منصة للدم، بدل أن تبقى إطارًا للهداية والرحمة.
اللعب على النوستالجيا الدينية
يعتمد النص على توظيف مفهوم "القرون المفضلة" — أي زمن الصحابة والتابعين — بوصفه نموذجًا ذهبيًا خالصًا، خاليًا من التناقضات أو التعقيدات التاريخية. ويُستخدم هذا النموذج لتكوين ثنائية حادة بين "الماضي الطاهر" و"الحاضر المنحط"، حيث يصوَّر الصحابة وكأنهم جميعًا باعوا أنفسهم لله دون تردد، بينما يُقدَّم المعاصرون كغارقين في الجبن والملذات. هذا النوع من الخطاب يغفل أن زمن الصحابة كان مليئًا بالنقاشات والخلافات والاجتهادات المتعددة، وأن قراراتهم لم تكن دومًا أحادية أو ساذجة كما يوحي الخطاب الجهادي.
لا يُستدعى الماضي هنا من أجل الدراسة أو الاعتبار أو النقد، بل بوصفه "حنينًا مطهرًا"، يُستخدم كوقود تعبوي. فاستحضار التاريخ لا يجري على أسس عقلية أو معرفية، بل بوصفه ذاكرة رمزية مثقلة بالعاطفة، تُوظف لترسيخ مشاعر الذنب لدى المتلقي، ثم توجيهه نحو فعل "التطهر" من هذا الذنب عبر العنف. يصبح الماضي الإسلامي نموذجًا مفترضًا يُضغط به على الحاضر، ويُستخدم لإدانة كل من يختار الحياة والواقعية بدل الفناء في المعركة.
هذه القراءة للماضي تُفضي إلى بناء سردية تراجيدية تتطلب "خلاصًا" حتميًا. في هذه السردية، يُقدَّم الموت لا كقدر مؤلم بل كخلاص شخصي ومجد جماعي. تُبنى الهوية على فكرة أن الإنسان لا يكون مسلمًا حقيقيًا إلا إذا "ضحى بنفسه"، وأن التضحية هنا تعني إزهاق الروح لا الاجتهاد أو الصبر أو النضال المدني. هذه المقاربة الخطابية تعيد تدوير مفهوم "الشهادة" وتفرغه من أبعاده الأخلاقية والفقهية، ليصبح مجرد أداء مسرحي للموت العنيف باسم العقيدة.
أخطر ما في هذه النوستالجيا الدينية أنها لا تستحضر الماضي كما كان، بل كما "يُراد له أن يكون". فكل السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شكّلت سلوك الصحابة والتابعين تُطمس عمداً، ويُختزل التاريخ الإسلامي في لحظة بطولية دائمة. النتيجة أن الأفراد المعاصرين يُدفعون إلى تقليد مثالات غير واقعية، تحت ضغط خطاب يستبعد تمامًا تعقيدات الواقع الراهن، ويُصور القفز إلى الموت كسبيل وحيد إلى المعنى والانتماء والانتصار.
وظيفة النص في السياق الدعائي العام للتنظيم
تُفهم هذه الافتتاحية بوصفها استجابة دعائية مدروسة لحالة تراجع ميداني يمر بها تنظيم داعش، سواء في معاقله التقليدية بسوريا والعراق، أو في فروعه النشطة بأفريقيا. في لحظات الانكسار، لا يملك التنظيم ما يقدّمه لجمهوره سوى الرمزية والتضحية. من هنا، يتصاعد التركيز على مفردات الموت، الشهادة، والبطولة الفردية، لتغطية العجز في تحقيق المكاسب الواقعية أو الحفاظ على الأراضي. إن توقيت نشر هذا النوع من الخطابات ليس اعتباطيًا، بل يأتي ضمن تقويم تعبوي هدفه إنعاش الروح القتالية وتجنب تفكك البنية التنظيمية.
يعمل النص على ترميم المعنويات داخل صفوف المقاتلين بعد سلسلة من الهزائم والتراجعات. في ظل خسائر متتالية، يصبح من الصعب الإبقاء على الحماسة الجهادية من دون تعزيز سرديات "الابتلاء" و"التمكين المؤجل" و"الفوز الأخروي". لذلك، تعتمد الافتتاحية على خطاب شعوري يمنح القتال قيمة رمزية مطلقة، حتى وإن فقد معناه الاستراتيجي. الرسالة المبطنة هنا: "لا تهمّ الهزائم، ما دمتم تموتون على الطريق الصحيح"، وهي رسالة تُبقي على درجة من التماسك العقائدي داخل التنظيم.
في لحظات الانكسار، تظهر التساؤلات داخل القواعد: لماذا خسرنا؟ أين وعد الله بالنصر؟ هل ما زال هذا الطريق صوابًا؟ هنا يتدخل الخطاب الدعائي ليحاصر هذه الأسئلة ويمنعها من التسرّب. تُصوَّر الهزيمة كنوع من "الفرز الإلهي"، لا كفشل تنظيمي أو استراتيجي، ويُعاد تعريف "النصر" باعتباره صبرًا وتمحيصًا لا إنجازًا ماديًا. بهذه الطريقة، يتحوّل النص إلى أداة تحصين نفسي وعقائدي ضد خطر الانشقاق أو التمرد الداخلي، ويعيد فرض الطاعة على القواعد الجهادية عبر آلية الإيمان بالمحنة لا بالنتائج.
أخيرًا، تعمل الافتتاحية على ترسيخ خطاب النخبوية الجهادية، عبر تصوير المقاتلين كـ"صفوة مختارة" تفهم الحقيقة بينما يغرق الناس في الغفلة والدنيا. هذا الخطاب يُعيد بناء هوية معنوية بديلة تحمي الأفراد من الشعور بالفشل أو العزلة، فحتى في الهزيمة يُمنح المنتمي شعورًا بالتفوّق الأخلاقي والروحي. بهذا المنطق، تصبح الخسائر فرصة لإعادة تعريف الذات بوصفها "مظلومة لكنها طاهرة"، و"مُحاصَرة لكنها على الحق"، وهي إحدى أهم ركائز الدعاية الجهادية في لحظات الضعف والانكفاء.
أثر هذا الخطاب على تنامي الإرهاب
تُنتج الخطابات من هذا النوع بنية نفسية تبريرية تجعل من العنف، بل ومن الانتحار ذاته، خيارًا مشروعًا بل ومرغوبًا. حين يُقدَّم الموت بوصفه طريقًا مؤكدًا إلى الفوز الأخروي، ويُصوَّر القتل بوصفه طاعة لله، يُعاد تشكيل وعي المتلقي بطريقة تُعطّل الحاجز الأخلاقي الطبيعي تجاه العنف. بهذا، تتحول مشاعر الخوف أو التردد إلى شعور بالبطولة، ويُعاد تعريف "الإنسانية" كضعف، في مقابل "القوة" التي تتمثل في التضحية بالذات وقتل الآخرين.
يُستخدم هذا الخطاب كسند ديني زائف يسهم في تجنيد المراهقين والشباب، خصوصًا في البيئات المهمشة أو التي تفتقر إلى وعي ديني رصين. حين يُقدَّم النص الشرعي خارج سياقه ليخدم فكرة الموت كأسمى مراتب الإيمان، يتحوّل إلى أداة تجنيد ذات فاعلية كبيرة، لأنها تلبّي حاجة الشباب للانتماء، وتمنحهم غاية "عظيمة" يضحّون من أجلها. هكذا، يصبح الانخراط في العنف مشروعًا دينيًا لا يحتاج إلى تبرير، بل إلى تسليم مطلق.
أحد أخطر آثار هذا الخطاب هو خلق حالة من الانفصال الكامل عن الواقع الاجتماعي. فكل ما هو خارج دائرة "المجاهدين" يُصوَّر كفساد أو ضلال أو جبن، بما في ذلك الأسرة، المدرسة، الدولة، وحتى الفقهاء والعلماء. هكذا تنشأ عقلية تكفيرية مغلقة ترى أن الخلاص لا يكون إلا بالقطيعة مع المجتمع، وتمارس عنفًا "تطهيريًا" لا يستهدف الأعداء فحسب، بل كل من يخالف أو يتردد أو يشكّك.
الخطاب الجهادي لا يعترف بفكرة السياسة، ولا بالمجتمع المدني، ولا بالحلول التفاوضية. هو خطاب يختزل العالم في صراع مطلق بين الحق والباطل، ويحوّل أي تسوية أو نقاش إلى خيانة. حين تُختزل الحياة في ثنائية "الجهاد أو القعود"، تصبح أدوات التغيير السلمي ملغاة، ويُفسَّر كل خلاف باعتباره ردّة أو نفاقًا. بهذا الشكل، تُغلق أبواب الإصلاح من الداخل، وتُفتح نوافذ الإرهاب بوصفه الطريق الوحيد المتاح أمام "المؤمن الحقيقي".
خاتمة:
تُظهر هذه الافتتاحية، رغم لغتها الهادئة وكسوتها الدينية، جوهرًا مدمّرًا يختزل الإيمان في القتل، والنجاة في الموت، والبطولة في سفك الدم. فالمأساة تُحوّل إلى ملحمة، والضرورة الدفاعية تُبدَّل بغرض وجودي. هنا لا يعود القتل جريمة تُضطر الجماعات لتبريرها، بل يتحول إلى فضيلة تُدعى الجماهير لتمجيدها. وهكذا يولد خطاب استئصالي لا يكتفي بإبادة الآخر، بل يستهدف الذات أيضًا، عبر تقديم الموت كأعلى درجات التعبّد.
إن مواجهة هذا النمط من الخطاب الجهادي لا يمكن أن تتم بالاستنكار الأخلاقي فقط أو بالملاحقة الأمنية فحسب. بل هي معركة تأويل ومعرفة، تبدأ بإعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة واعية وناقدة، لا تجتزئ النصوص ولا تسلخها من سياقاتها. فالمفاهيم المحورية مثل الجهاد، الشهادة، البيعة، والفوز، تحتاج إلى إعادة تأصيل فقهي وتاريخي، يضعها في أطرها المقاصدية، ويحررها من التوظيف التحريضي الذي تمارسه التنظيمات المتطرفة.
كما أن الاستمرار في تجاهل المنصات التي تروّج لهذا الخطاب يساهم في انتشاره وتعميق أثره. فهناك حاجة ملحة لتجفيف المنابع الإعلامية التي تُعيد إنتاج هذه النصوص أو تُمررها باسم "الرأي الآخر" أو "حرية التعبير". ويجب مساءلة كل من يتيح لهذه الأفكار أن تتسلل إلى الفضاء العام دون تفكيك أو نقد، لأن السلبية هنا ليست حيادًا، بل تمهيد لصعود موجات جديدة من العنف المؤدلج.
يبقى الرهان الأعمق في هذه المواجهة هو إصلاح الفضاء الديني والإعلامي، بحيث يستعيد لغته الأصيلة المرتبطة بالحياة والكرامة والرحمة. فمواجهة خطاب القتل لا تكون بخطابات مضادة له بنفس منطق التجييش، بل ببناء سردية دينية وأخلاقية جديدة تُعيد للمقدس معناه، وللإنسان قيمته. هذا التحول من فقه الموت إلى فقه الحياة هو الشرط الجوهري لخلق حصانة معرفية ومجتمعية ضد مشاريع العنف والانتحار الجماعي المقنّع باسم الدين.