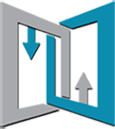عبد الرحيم علي يكتب عن مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي
الإثنين 27/يناير/2020 - 07:12 م
طباعة
 عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي
تلقيت دعوة كريمة، من فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب؛ لحضور مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي، الذي تم افتتاحه الإثنين 27 يناير2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من علماء الأزهر والعالم الإسلامي.
حال بيني وبين تلبية الدعوة الكريمة، كوني في مرحلة التعافي، إثر جراحة بسيطة، أجريتها في باريس، قبل أسبوعين من موعد المؤتمر، لكن الدعوة ذكرتني بدعوة مماثلة، تلقيتها من الإمام الأكبر، منذ خمس سنوات أو يزيد، وبالتحديد في ديسمبر 2014.
أفكار مستنيرة وأفق واسع
معرفتي بالدكتور أحمد الطيب، قديمة، تعود إلى سنوات بعيدة مضت، إبان كان الإمام رئيسًا لجامعة الأزهر، قبلها، تعرفت عليه من خلال كتاباته وأفكاره المستنيرة، التي ضمَّنها أكثر من خمسة عشر كتابًا، ما بين التأليف والترجمة، بعضها في المنطق ككتابه «مدخل لدراسة المنطق القديم»، والآخر في الفقه والتصوف والفلسفة ككتابه «الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي»، إضافةً إلى ترجماته من وإلى الفرنسية، التي يجيدها بطلاقة.
عرفته إمامًا عصريًّا بامتياز، تعلم وعاش في فرنسا سنوات طوال، فتمتع مثله مثل كل الذين تعلموا وعاشوا فترة من عمرهم في الغرب، أمثال «رفاعة رافع الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسين ولويس عوض»، بسعة الأفق، وانضباط المنهج، والدقة في استخدام المصطلحات، والانفتاح على الآراء المخالفة.
تحدث فضيلة الإمام، في ذلك اللقاء، «ديسمبر 2014»، معبِّرًا عن حزنه وألمه، من جراء ما يعتقد أنها حملة منظمة، تشنها بعض الفضائيات والجرائد والمواقع، ضده وضد الأزهر، متهمةً المؤسسة العريقة، بأنها مخترَقة من قبل بعض مفكري الإخوان، وأنها ترفض فكرة التجديد أو الدعوة إليه.
كان الحوار ساخنًا، بدرجة وحجم كل الذين حضروا اللقاء، آنذاك، وكانوا تقريبًا معظم رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ونقيب الصحفيين آنذاك الصديق العزيز الدكتور «ضياء رشوان».
موجة الإعارات.. ومذكرات التعصب
تحدث الإمام الأكبر مؤكدًا، أن القضية أعمق من كيفية مناقشة أو عرض الإعلام لها، وأن الأزهر كمؤسسة لا يتبنى أي فكر متطرف؛ إذ إنه يقوم بالأساس على مذهب الأشاعرة، القائل بعدم تكفير مَن يصلى إلى القبلتين، ويشهد الشهادتين، وهو ما دعا الأزهر إلى «التورط» في فتوى عدم تكفير «داعش»، اتساقًا مع المذهب الأشعري، ولكن ما حدث في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ـ والحديث هنا للإمام الأكبر- غيَّر أشياء كثيرة، فموجة الإعارات الخاصة بالأساتذة والمدرسين إلى بعض البلدان التي تتبنى تكفير المخالف في المذهب وتنحاز إلى مذهب واحد بعينه، أثَّرت كثيرًا على هؤلاء الأساتذة والمعلمين، ونشرت بينهم تقليعة جديدة على مستوى المنهج، وهى الانحياز إلى مذهب واحد بعينه على عكس ما تعلموه في الأزهر، وهو الأخذ بالمذاهب الخمسة، ومن حيث الشكل، اعتماد مفهوم «المذكرة» بديلًا عن الكتاب الأزهري، الذى تربّت عليه أجيال العمالقة؛ ليستعيض بذلك الأستاذ أو المدرس عن كتب التسامح والتعددية، بمذكرات التعصب والتنطع.
وضع الإمام يده، يومها، على لُبِّ الحقيقة تمامًا، لكن دون اعتراف واضح بأن تأثير تلك السنوات ما زال مستمرًا، ويحتاج إلى ثورة حقيقية؛ لكي تتم معالجة تأثيره، فضلًا عن آثاره، قضايا عديدة، تناولها الإمام الأكبر حقيقةً، لا نستطيع تعديدها هنا، بعد مرور كل تلك السنوات، ولكن من أهم ما قاله الرجل: إن مجهودات خارقة تُبذل في إطار التطوير والتحديث، منها إلغاء موضوع المذكرات الجامعية السابق الإشارة إليها، واعتماد الكتاب الأزهري القديم، وإن كانت مشكلة شرح ما بداخله ستظل موجودة، وتعتمد بالأساس على طريقة فهم الأستاذ لتلك الأفكار وموقفه منها، كذلك قضية البعثات، التي يهتم بها الإمام اهتمامًا كبيرًا، ويقوم بتغيير جذري في طرق اختيار المبعوثين في محاولة لوضع نهاية لعصر كامل من الاختيار، على أساس الأقدمية، تلك الطريقة التي أساءت إلى مصر والأزهر، بقدر ما كان يجب أن تقدم من إفادة، إضافةً إلى قضايا أخرى عديدة، لكن للأمانة لم نشهد بعد ذلك وطوال خمس سنوات كاملة، أي خطوات حقيقية أو جادة، باتجاه تلك القضايا.
طرد الخفافيش
لذا كانت فرحتي كبيرة، بعقد هذا المؤتمر، الذي آمل أن يخرج بتوصيات ويعتمد دراسات ومفاهيم، تنقذ الفكر الإسلامي من المأزق الذي حشره فيه بعض من أساءوا إليه، ولعل أهم قضية أتمنى أن يخرجوا بها، هي فتح باب الاجتهاد، على مصراعيه من جديد، أمام علماء ومفكري الأمة، لعلنا بإفساحنا المجال للهواء النقي، نستطيع طرد تلك الخفافيش التي عششت في فكرنا لقرون طويلة.
ومن هذا المنطلق، أقدم رؤيتي تلك، التي سبق أن قدمتها منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وبالتحديد عام 2005، في مقدمة كتابي «الإسلام وحرية الرأي والتعبير»، الذي نشرته دار المحروسة للنشر والتوزيع.
ضرورة فتح باب الاجتهاد
الاجتهاد، الذي أمرت به نصوص عديدة من القرآن والسنة، معناه بذل الجهد العقلي والفكري في التعرف على الحكم الشرعي، لما يُعرض للفقيه أو المفتي أو القاضي من مسائل.
وأصل الاجتهاد مقرر في الشريعة، بفعل النبي «ﷺ» نفسه، وبأمره أصحابه بالاجتهاد في حضرته، وبإقراره اجتهاد من اجتهد منهم في غيبته، ووقائع ذلك مذكورة بالتفصيل في كتب أصول الفقه، وفي كتب تاريخ التشريع، وفي كتب عديدة خصصها مؤلفوها لموضوع الاجتهاد دون سواه.
وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، نشأ القول بمنع الاجتهاد، وعرفت المسألة باسم: «قفل باب الاجتهاد»، وقيل بعد ذلك بوجوب التقليد مطلقًا، دون تحديد من الذي يجب تقليده من العلماء، ثم تطور الأمر إلى القول: بوجوب تقليد واحد من الأئمة الأربعة.
وعلى الرغم من أن مسألة القول: بقفل باب الاجتهاد، لم يرد فيها نص من الكتاب ولا السُّنة، فقد لجأ إليها القائلون بها من العلماء؛ لأسباب من أهمها:
- تدوين المذاهب وتكامل نصوص مؤسسيها وأتباعهم.
- الضعف السياسي الذي أصاب هيكل الدولة الإسلامية، فتفتت إلى دويلات متنافسة.
- تولية القضاء لأتباع المذاهب، فشاع تقليدها طمعًا في الولايات الدنيوية.
- أهم من ذلك كله أن العلماء وجدوا من لم يتأهلوا للاجتهاد، يدعون أنهم مجتهدون، ويفتون الناس بآرائهم، فأرادوا سد الطريق أمام هؤلاء المدعين فقالوا: بقفل باب الاجتهاد، بل قالوا: إن هذا محل «إجماع».
فلم يكن الذين قالوا بمنع الاجتهاد من أعداء الأمة أو أعداء الدين – كما قد يفهم البعض- ولكنهم كانوا فقهاء، أرادوا تحقيق هدف نبيل، لكنهم أخطأوا الطريق إليه، أرادوا منع أولئك المدعين من إضلال العباد باجتهادهم المزعوم، وأخطأوا بادعاء ما ليس لهم أن يدعوه.(1)
ولذلك، فإن الصحيح الذي يذهب إليه الفقه العصري، بلسان أعلامه وأقلامهم، أن الاجتهاد باقٍ ما بقي الإسلام نفسه، لا يملك أحد منع من استكمل التأهل له من ممارسته.
حرية الرأي.. مفاهيم مغلوطة
ومن أعجب الآفات التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية اليوم، آفة طلب كل ذي رأي، أن يكون له الحق والحرية في إبداء رأيه وإعلانه والدعوة إليه، ثم حجره ـ هو نفسه ـ على الآخرين، أن يتمتعوا بمثل هذا الحق، وأن يمارسوا مثل تلك الحرية.
والإيمان بالحق في الاجتهاد، يقضي على هذه الآفة، ويحاصرها ويمنع انتشارها، ويئد مضارها الكثيرة، وأخطرها نشوء أجيال من المتعصبين، الذين لا يرون إلا رأيهم، ولا يسلمون إلا بحقوق أنفسهم، وهؤلاء هم وقود الغلو «الذي يسميه الناس تطرفًا»، الذي يقضي في نهاية مطافه على الأخضر واليابس من حياتنا الفكرية والثقافية. (2)
هل يعقل، أن يظل المسلمون أسرى لما قاله علماء أجلاء في القرون السابقة، في وصف نظم الحكم التي كانت سائدة لديهم -وهي كلها نظم فردية محورها هو الحاكم الذي تدين له بالطاعة، وتستمد منه القدوة- سائر السلطات والهيئات والأفراد؟
وهل يعقل أن يظل المسلمون يحتكمون ويرجعون في علاقاتهم، بغير المسلمين من مواطنيهم، إلى أفكار وآراء صيغت؛ لتناسب حال الحرب التي كانت سائدة في وقت ما، بعد أن مضت على الحياة المتآخية بين الفريقين قرون؟
إن النصوص الصريحة واجبة الاتباع.
وإن هدف الاجتهاد هو تطبيق هذه النصوص في الزمن الذي يقع الاجتهاد فيه. (3)
إن في الإسلام سماحةً ويسرًا، تنطق بهما آيات الكتاب الكريم، وتجسدهما سيرة النبي العظيم، وتقوم عليهما شرائعه وشعائره وآدابه، إن الإيمان لا يلغي دور العقل، وشمول الإسلام، لا يعنى أن النصوص تعالج كل صغيرة وكبيرة من أمور الحياة، فذلك – فضلًا عن استحالته– غير مقبول في ظل ما تركه الإسلام للعقل من حرية الحركة وواجب الاجتهاد، وخلود الإسلام لا يعني «جمود شريعته» وإنما يعنى قدرتها على التجدد والإبداع؛ لملاقاة حركة الحياة وتغير أشكالها، وأصالة المسلمين، لا تعني عزلتهم عن الناس وانغلاقهم على أنفسهم، وإنما تعنى الاتصال بالناس والعيش معهم.
الشريعة والفقه.. الدين والتدين
إن الشريعة غير الفقه، كما أن الدين غير التدين، فالشريعة هي مجموع أحكام الله تعالى الثابتة عنه وعن نبيه «ﷺ»، والتي تنظم أفعال الناس، ومصدرها كتاب الله وسنة نبيه «ﷺ»، أما الفقه فهو عمل الرجال في الشريعة، استخلاصًا لأحكامها وتفسيرًا لنصوصها وقياسًا على تلك النصوص فيما لم يرد فيه نص، وطلبًا للمصلحة فيما يعرض من أمور السياسة، وإذا كانت الشريعة حاكمة كما يقال، فإن الفقه محكوم بكل ما يحكم عمل الرجال وسلوكهم في الجماعة.
والطاعة الواجبة على المسلم، إنما هي طاعة الشريعة، وليست طاعة الفقه ورجاله..(4)
إن مجال الاجتهاد في التشريع مجال واسع وكبير؛ لأن ما لم تتناوله النصوص كثير بالقياس إلى ما تناولته، وليس ذلك –كما يتوهم البعض– قدحًا في الشريعة، ولا هو نيل من قول الله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء»، بل هو آية الحكمة، ودليل الكمال في شرع الذي خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه، والذي يعلم –وله المثل الأعلى– أن العالم يتطور، وأن أشكال الحياة تتغير، وأن مشاكل الناس تتبدى في قوالب جديدة؛ لأنه سبحانه كما أودع ناموس الحركة في الكون والمجتمع، أودع نعمة العقل في الرؤوس؛ ليلاقى شرعة الحركة بمثلها، وليستجيب للتطور في الحياة بتطوير في الأحكام، وهو وحده الكفيل بحماية الشريعة وتحقيق مقاصدها الدينية.
الواقعة الاجتماعية، هي السند المادي لكل نشاط تشريعي فقهي، ومعنى هذا أن جزءًا كبيرًا من الاجتهاد يجب أن يتجه إلى رصد الظواهر الاجتماعية وفهمها وتحليلها وتصور الحلول التشريعية المختلفة التي تتعامل معها، وتحليل النتائج العملية، التي تترتب على كل اختيار فقهي مطروح، ذلك أن التشريع ليس نظرًا فلسفيًّا ولا رياضة عقلية، وإنما هو رعاية لمصالح الناس بسلطان الحكم، ولذلك قال الإمام الشاطبي بحق: «إن التكاليف الشرعية ترجع كلها إلى تحقيق مقاصدها في الخلق».
وحين يمارس الاجتهاد، وتعرض على المُشرع والفقيه ورجل السياسة حلول متعددة، تقبلها الشريعة الإسلامية، وتتسع لها، فإن الاختيار حينئذ لا بد أن يحكمه فهم الواقع الاجتماعي وتحليل حركته، لذلك وجب أن يستقر في ذهن دعاة الإسلام والمنادين بتطبيق الشريعة، أن الجهد الفقهي الخالص، لا بد أن يتممه عمل اجتماعي واسع؛ حتى تأتى ثمرته رحمة حقيقية للناس، ومخرجًا لهم من الضيق، ورفعا للحرج(5)
الاجتهاد الحديث
هنا يبرز تساؤل غاية في الأهمية، لماذا يحجم علماء الإسلام عن الاجتهاد في العصر الحديث؟ يُرجع د. أحمد كمال أبو المجد السبب إلى أمرين، الأول عجز بعض علماء المسلمين عن الاجتهاد، والثاني تردد البعض الآخر عن ممارسته.
والتردد في ممارسة الاجتهاد، مرده أن، الاجتهاد لا بد أن يفضى إلى اختلاف العلماء، وذلك أن صاحب الرأي، إن وافق برأيه فريقًا، فقد خالف فريقًا، وإن أرضى طائفة، فقد أسخط طائفة، وبعض الذين يسخطون – في أمور الدين– لا يقولون – كما أدب الإسلام أهله – اجتهد صاحبنا فأخطأ فهو مأجور أو معذور، وإنما يسارعون – إجهازًا على الرأي يعارضونه – فيتهمون صاحبه بالإثم والخطيئة والعدوان فيقولون: ضل، ومرق من الدين، وكاد للإسلام والمسلمين.
والخطر الحقيقي في هذا المنهج أو «اللامنهج» الغريب على روح الإسلام وآدابه ومبادئه، أن آثاره السيئة تصيب الجماعة كلها، فإنه إذا خاف أصحاب الرأي حبسوا رأيهم، وإذا أشفق العلماء على أنفسهم، كتموا علمهم، وإذا افتقد الناس الرأي والعمل، لم يبق لهم إلا الهوى، الذي تتفرق به السُبل وتختلط الأمور، أو التقليد الذي يجمد به الفكر، ويعم الحرج، وتتوقف عند قوالبه الصماء حركة الحياة. (6)
من أجل ذلك، كان تصحيح منهج البحث والاتفاق على قواعد «الخلاف» بين العلماء والمجتهدين «مسألة أولية»، كما يقول المعاصرون، لا بد من حسمها؛ حتى يقبل أولو العلم على ممارسة الاجتهاد.
بعد مئات السنين من إغلاق باب الاجتهاد، وبعد أن تحول الدين إلى منطقة مغلقة، يسعى بعضهم إلى الحيلولة دون المفكرين، والدخول إلى ساحتها وطرح رؤى مغايرة للسائد المهيمن، يبدو ضروريًّا أن تتغير المعادلة، وأن يعاد النظر في كثير من القضايا والإشكالات التي ترفع فوقها رايات زائفة، تحذر من خطورة الاقتراب والتفكير في طرح البدائل، من منطلق اجتهادي مستنير.
الدين لا ينفصل عن الحياة ولا ينبغي له أن يبتعد عن كل جديد يطرأ عليها، والدنيا التي نعيشها تقترن بكل ما هو جاد وخطير، وليس بالشكليات والسفاسف والمعالجات الهشة المتهافتة، إن الدين ضرورة اجتماعية، ولا بد من التمييز الصارم الواضح بين مكانه ومكانته وبين كل الأنشطة الإنسانية الأخرى، الفصل حتمي بين العقيدة الدينية وما يرتبط بها، وبين الاجتهادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ذلك أنها اجتهادات تستدعي الخلاف، وتعتمد على البحث والتجربة، وتخضع للصواب والخطأ.
الإيمان وليد التسليم والعاطفة، وهو في حاجة – أيضًا – إلى مناخ من الحرية التي ترتقي بذلك الإيمان العاطفي وتسلحه بالمنطق والعقل، لن يضير الدين مخالفة غير المؤمنين، وليس من مبرر للإرغام على الإيمان قهرًا وإجبارًا، فالقرآن الكريم يعلنها صريحة مدوية: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».. الكهف: 29.
للمخالفين رأي لابد من معرفته
الإسلام عقيدة قوية، ولا يستقيم أن يتحقق الإيمان الحقيقي به دون اقتناع عقلي، ولا مجال لهذا الاقتناع بمعزل عن معرفة ما يقوله الآخرون، ومثل هذه المعرفة، تتطلب إتاحة الفرصة لحق المخالفين في إبداء آرائهم والتعبير عن وجهات نظرهم، وهذا ما نص عليه القرآن في أكثر من موضع ستأتي الإشارة إليها في الفصل الأول عند الحديث عن «القرآن وحرية الرأي والتعبير»، وهو عينه ما مارسه النبي «ﷺ» في دولة المدينة، كما سيتضح لنا بعد قراءتنا للفصل الثاني من هذا الكتاب الذي خصصناه لهذا الغرض.
وفي السياق ذاته، يسعى الفصل الثالث إلى البرهنة على أن قافلة الاجتهاد لم تتوقف عبر العصور، فما أكثر وأعظم المجتهدين الذين قالوا كلمتهم، وأرضوا ضمائرهم.
توقفنا في الصفحات السابقة أمام ثلاث مسائل، والمحصلة النهائية نوجزها، فيما يلي:
أولا: يحظى الإنسان بالاحترام والإجلال والتقدير في الآيات القرآنية الكريمة، ومثل هذه المكانة الشامخة السامية تعني، بالمنطق والضرورة، الحق الكامل للإنسان في ممارسة إنسانية، والتعبير عن ذاته، وإعمال عقله – وهو هبة إلهية – فيما يواجهه من قضايا وهموم.
ثانيا: ثنائية «الجبر والاختيار» استهلكت كثيرًا من الجهد في غير طائل، ذلك أن الإسلام – في أصوله الواجب اتباعها – يعلي من شأن الإرادة، ويعامل الإنسان من منطلق أنه كائن حر مسئول، وليس محكوما عليه – منذ البدء - بالوصول إلى نهاية محددة سلفًا.
ثالثا: الاجتهاد فريضة غائبة، لا بد من العمل على إعادتها إلى المكانة التي تجعل التصالح بين الدين والدنيا واقعا بديلا، ومن العقل هاديًا ومرشدًا، لما فيه خير الإنسان ومحصلته، وإذا كان بعض «المجتهدين» قد أغلقوا – قبل قرون – باب الاجتهاد؛ لأسباب قد تكون وجيهة ومبررة في إطار مرحلتها التاريخية، فإن المطلب الذي يلح عليه العلماء «المجتهدون» في العصر الحديث، هو إعادة فتح باب الاجتهاد، والسعي إلى التسلح بالنظرة العصرية العقلانية في مواجهة ما يجد على الواقع من قضايا ومتغيرات.
هوامش:
1. د. محمد سليم العوا: الفقه الإسلامي في طريق التجديد، ص 25.
2. المرجع السابق، ص 29.
3. نفسه، ص 142.
4. د. أحمد كمال أبو المجد: حوار لا مواجهة، ص 89.
5. المرجع نفسه، ص 91.
6. نفسه، ص 97