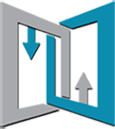الجماعات المتأسلمة بين العمالة وخيانة الوطن.. صفقات الإرهابيين مع بريطانيا (الحلقة السابعة)
الخميس 22/أكتوبر/2015 - 01:30 م
طباعة

في هذه الحلقة من الكتاب الوثائقي المهم "التآمر السري لبريطانيا مع الأصوليين" نجد قدرًا كبيرًا من الإثارة والتشويق؛ لأنها تكشف عن دور هذه الجماعات في العمالة والجاسوسية، وكيف وظفته بريطانيا لصالحها؛ حيث يقول مارك كورتيس في كتابه الرائع: أدت الجماعات المتأسلمة طويلاً تشكيلة من الوظائف الأساسية للسياسة الخارجية البريطانية، كما سبق أن رأينا في فترة ما بعد الحرب، خاصة كقوات صدام لتشجيع القلاقل والانقلابات، وكقوى سرية وكيلة تعمل بالنيابة للقضاء على قادة العدو أو كقوى محافظة تساعد في دعم النظم الموالية للغرب. والأرجح أن استضافة هذه الجماعات في لندن وفر مزايا أخرى للسياسة البريطانية.
كان إحداها هو التمكين من إقامة علاقات مع قادة المستقبل. وكان وخز الضمير الذي يشعر به البريطانيون بشأن من يتوددون إليه قليلاً. فعلى سبيل المثال، رد كيم هاولز وزير الدولة بوزارة الخارجية على استفسار برلماني في مارس 2007 بأنه:
في حفلات عشاء أقيمت في سفارات في شتى أنحاء العالم كنت اكتشف فجأة أن شخصاً ما حدث أن جلس بجواري كان من البقية المحترمة من فرقة للإعدام في مكان ما. كان السفير مدفوعاً بأفضل النوايا يدعو هذا الشخص لأنه يعتقد أنه في ظل الديمقراطية الجديدة، سيشكل الحكومة الجديدة.
واستضافت جماعات المعارضة السعودية، مثل حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية، ولجنة بن لادن للمشورة والإصلاح، مثيرة للاهتمام بوجه خاص في هذا الصدد. ربما رأى البريطانيون في هذه الاستضافة بوليصة تأمين في حالة سقوط بيت آل سعود. ففي ضوء المستقبل غير المؤكد لهذا النظام، من الأرجح أن هوايتهول حاولت أن تلعب على الحبلين عليه وعلى المعارضة على حد سواء.
وكان هذا ميزة ثانية لوجود الجماعات المتأسلمة في لندن هي أن ذلك يمكن أن يؤثر على السياسات الداخلية والخارجية لبلدان رئيسية. وقد نبه ماهان عابدين، رئيس تحرر مطبوعة جامعة جيمستاون المحترمة رصد الإرهاب (تيروريزم مونيتور)، أن "وجود هذه الجماعات ]في بريطانيا[ مكن المخابرات البريطانية من التجسس على أنشطتها واكتساب شكل من قوة التأثير على السياسات الداخلية لبلدانها الأصلية". وفي ضوء هذا، كانت هذه المجموعات أداة مفيدة، بل وورقة مساومة، بالنسبة للصفوة البريطانية لزيادة نفوذها أو ضغطها على الدول العربية. ومثلما يفسر الصحفي الأمريكي ستيف كول، فإن بريطانيا تسامحت مع مكتب بن لادن في منتصف التسعينيات نظراً لأنها رأت أنه يوفر "ضغطاً خارجياً قليلاً على النظام السعودي".
لكن كان على بريطانيا أن تحقق توازناً صعباً مع السعوديين. فقد قال ديفيد بلانكت وزير الداخلية السابق، الذي أشرف على إصدار مرسوم الإرهاب لعام 2001: إن "عالم المخابرات تبنى وجهة النظر القائلة بأننا ينبغي أن نهون من شأن هؤلاء المتطرفين في لندن بسبب مصالحنا في العالم العربي"، وبصفة خاصة المصالح التجارية البريطانية مع السعودية. ويبين هذا التعليق أن الأمر اقتضى أن تسترضي بريطانيا السعوديين، الذين كانوا يرعون الجماعات المتطرفة، بما يحبب الأصوليين في الرياض في هوايتهول، ويحمي مصالح بريطانيا الحاشدة في النفط وصادرات السلاح. وفي ضوء دور السعوديين في تنمية الإرهاب العالمي، فإن لهذه النقطة أهمية بالغة لا ريب في ذلك، وذلك يتفق تماماً مع التاريخ الطويل لدعم بريطانيا للسعوديين وسياستهم الخارجية.
وأعتقد أنه كانت هناك ميزة كبرى أخرى ناجمة عن استضافة الجماعات المتأسلمة المتطرفة في لندن، ترتبط بصورة وثيقة بهذه السياسة الخارجية البريطانية الأساسية والراهنة – إلا وهي تدعيم سياسة "فرق تسد" الدولية.
وقد هدف الدعم البريطاني للقوى المتأسلمة عادة لإثارة القلاقل داخل الدول وفيما بينها على حد سواء. فقد تبدت سياسة فرق تسد الداخلية للحفاظ على السلطة الاستعمارية، مثلاً في تشجيع المسلمين ضد القوميين الهندوس في الهند، وتشجيع العرب أو اليهود ضد بعضهما البعض في فلسطين في ظل الانتداب البريطاني. بيد أن السياسات البريطانية مضت عادة إلى أبعد من تغذية التوترات بين الطوائف، وانطوت أحياناً على محاولات لتحطيم الدول – استراتيجية البلقنة. والاتحاد السوفيتي هو أوضح مثال لهذا؛ حيث سعت بريطانيا لإثارة القلاقل في الجمهوريات الإسلامية بدعم تمرد الباسماشي في العشرينيات من القرن الماضي ومختلف حروب المجاهدين في الثمانينيات والتسعينيات منه. كذلك سعت العمليات السرية في إندونيسيا في أواخر الخمسينيات وفي كوسوفو في أواخر التسعينيات لبلقنة الدول. ويتوقف اهتمام بريطانيا بتحطم الدول على من يسيطر عليها، فإذا حكمها حلفاء تابعون فإنها ستنحو إلى تفضيل سيطرة مركزية قوية.
لكن بريطانيا كانت متسقة تماماً مع نفسها بشأن إثارة الانقسام بين الدول، على الأقل في الشرق الأوسط، إذ اتبعت هوايتهول سياسة قديمة العهد في الإبقاء على الشرق الأوسط مقسماً إلى دول منفصلة، يتمثل الوضع المثالي بالنسبة لها في خضوعها لحكم ملوك أو حكام ديكتاتوريين موالين للغرب. وتزخر الملفات البريطانية التي رفعت عنها السرية بهذه الشواغل، التي كانت هي الجذر والأصل لسياسات تشكيل الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى، وبعدها ظلت كذلك منذئذ على ما هو ظاهر. وقد وثق هذا الكتاب بعض الأمثلة، ابتداء من وجهة نظر اللورد كروس في العشرينيات القائلة بأن "ما نريده هو.. جزيرة عربية غير موحدة منقسمة إلى إمارات تحت سيادتنا"، وصولاً إلى الأولوية التي حددتها وزارة الخارجية في 1958، للإبقاء على المناطق الأربع الرئيسية المنتجة للنفط ]السعودية، والكويت، وإيران، والعراق "تحت سيطرة سياسية منفصلة". وهناك شكلان حديثان لنفس استراتيجية "فرق تسد" الدولية، وهما اقتراح توني بلير في 2006 بإقامة "تحالف الاعتدال" (الدول الموالية للغرب) ضد "قوس التطرف" (الأعداء الرسميين) في الشرق الأوسط، وهو ما سنأتي إليه ووجهة نظر بوش في "إنك إما أن تكون معنا أو ضدنا" بعد 11 سبتمبر. وكان السبب الغالب للإبقاء على الشرق الأوسط مقسماً هو ضمان قوة بمفردها على موارد النفط في المنطقة، ومن ثم لا يستطيع اتحاد من الدول أن يتحدى الهيمنة الغربية.
لم تكن القوى الإسلامية المتطرفة مفيدة في إثارة القلاقل المحلية لإحداث تغيير داخلي فحسب، بل كانت مفيدة أيضًا في الإبقاء على المنطقة مقسمة وإذكاء التوترات بين الدول. ففي الخمسينيات والستينيات مثلاً، قوض الإخوان المسلمون بدعم من الغرب تحركات النظم القومية في مصر وسوريا لإقامة تحالف أوثق، وساعدوا في دعم النظم المحافظة على غرار الأردن والسعودية، ضد القوى الصاعدة للقومية العلمانية عبر المنطقة. وفيما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي، لم تكن بريطانيا مستعدة للتواطؤ مع القوى الإسلامية ضد اليهود فحسب، لكنها كانت مستعدة أيضًا للتواطؤ مع إسرائيل أيضًا ضد العرب، مثلما حدث عندما قال جورج يونج رئيس جهاز المخابرات الخارجية حينذاك في الخمسينيات: إن إسرائيل "انسلت إلى الدور الذي كانت القوات البريطانية تقوم به في وقت ما – دور الحارس المسلح المستعد للضرب – وذلك خير ضمان لحسن سلوك المصريين والسوريين والأردنيين". ويبين هجوم إسرائيل على لبنان في 2006 للتصدي لحزب الله الذي تؤيده إيران- التي كانت بريطانيا تقدم لها مساندة بحكم الأمر الواقع- أن وظيفة إسرائيل هذه لم تختف.
والمؤكد أن بيع الأسلحة للطرفين – وتلك سياسة بريطانية قديمة العهد – يُبقي على التوترات مشتعلة بين الدول. ولنأخذ سنوات بلير (1997-2007) فحسب مثالاً، ففيها تدفقت أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات على الدول العربية، أساساً السعودية، لكن إسرائيل تلقت هي أيضًا معدات عسكرية تربو قيمتها على 110 كلايين استرليني، بما في ذلك طائفة من الإمدادات الحاسمة بالنسبة للعمليات الهجومية، مثل مكونات الطائرات المقاتلة والمروحيات المقاتلة، ومركبات الدفع الرباعي المدرعة. وسلحت بريطانيا تسليحاً ثقيلاً كلا من باكستان والهند، العدوين الإقليميين اللذين وصلا مؤخراً إلى شفا الحرب الشاملة – الهند بما تصل قيمته إلى 900 مليون استرليني تقريباً في سنوات بلير، وباكستان بما تربو قيمته على 150 مليون استرليني. واستمرت الإمدادات البريطانية تتدفق عندما وصل البلدان إلى حافة الحرب في 2002 مثلاً، وزادت بصورة كبيرة في العامين التاليين. وقدمت بريطانيا معدات عسكرية متماثلة للطرفين تساعد في عمليات القتال، مثل القذائف جو-جو ومكونات الطائرات المقاتلة، والفرقاطات ومعدات الاتصالات العسكرية. والرأي الذي انتهيت إليه هو أن استضافة تشكيلة من الجماعات المتشددة في لندن خلال التسعينيات، ربما اعتبرها البعض على الأقل في مجتمع المعلومات، مفيدة لتعزيز الاهتمام قديم العهد بسياسة "فرق تسد"، حتى وإن لم تكن سياسة رسمية للحكومة. فالأنشطة الإرهابية يمكنها أن تثير التوترات، وتمارس الضغوط على الدول بتقويض قياداتها أو تفريق الدول عن بعضها البعض – وهي وظائف اعتبرتها الصفوة البريطانية مفيدة كلها في أوقات معينة في عالم ما بعد الحرب.
ثم هناك التعاون المباشر لأجهزة الأمن مع أفراد بعينهم.
عملاء بريطانيون آخرون؟
قابلنا بالفعل بعض المتأسلمين الذين ربما يكونون قد عملوا عملاء للمخابرات البريطانية أو مرشدين لها. بيد أنه ربما كان المثال الأشد بروزاً هو أبو حمزة، وهو حالة تبين المدى الذي كانت أجهزة الأمن البريطانية مستعدة للمضي إليه في إغماض الأعين عن الإرهاب في الخارج؛ بغية الاحتفاظ بمرشدها.
فقد أسس أبو حمزة المصري المولد منظمة أنصار الشريعة في 1994، وقام في 1995 بثلاث رحلات إلى الحرب في البوسنة، ظاهرياً باعتباره من العاملين بتقديم المعاونة، لكنه عمل أيضًا كما يدعي مستشاراً للمقاتلين الجزائريين هناك. وفي العام نفسه، طلبت الحكومة المصرية تسليم أبي حمزة ليواجه تهماً بالإرهاب، بناء على شكوك بتورطه مع جماعة الجهاد الإسلامي المصرية والجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، ورفضت هوايهول هذا، إلى جانب طلب تسليم آخر قدم في 1999، كان هذه المرة من اليمن، لأسباب لا تزال غير واضحة.
وتبين الأدلة المطروحة في المجال العام أنه في أوائل 1997 فاتح الفرع الخاص أبا حمزة، عندما كان واعظاً في مسجد ليوتن، ليعمل مرشداً عن المجاهدين الآخرين وأعطى له اسماً حركياً: دامسون بير. وبغير علم من الشرطة، شرع جهاز المخابرات الداخلية هو أيضًا في لقاء أبي حمزة بطلب من المخابرات الفرنسية، التي كانت تبحث عن معلومات عن نشطاء الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، ويقال: إن أبا حمزة قام بعمليات تجنيد وجمع الأموال من أجل هذه الجماعة، وكذلك نشر رسالتها الإخبارية، التي كان يحررها عالم دين هو أبو قتادة. وعقد جهاز المخابرات الداخلية سبعة اجتماعات مع أبي حمزة بين 1997 و2000. وينبه شين أونيل ودانيال ماكجروري في كتابهما عن أبي حمزة إلى أنه كانت تربطه "علاقة" ودية مع جهاز المخابرات الداخلية والفرع الخاص في أواخر التسعينيات، إذ "كانوا يتصلون به بانتظام، ويدعونه لاجتماعات، وكانوا بصفة عامة على علاقة ودية به". وأحنق هذا في نهاية المطاف المسئولين الفرنسيين الذين كانوا يحققون في قضايا إرهابية يعتقدون أن أبا حمزة متورط فيها، نظراً "لأن بريطانيا" من وجهة نظر الفرنسيين، كانت "تحمي أبا حمزة وعدداً أكبر كثيراً من الأشخاص الخطرين في المسجد"، كما كتب أونيل ماكجروري. كما خلص إلى أن المعلومات التي كان ينقلها أبو حمزة لجهاز المخابرات الداخلية كانت تقتصر على الأسماء القديمة أو المعلومات العامة عن جماعات متأسلمة أخرى، وأن تعاونه مع أجهزة الأمن كان فضيحة.
وتبين سجلات لقاءات أبي حمزة وجهاز المخابرات الداخلية أن هذا الجهاز والفرع الخاص كانا يدركان تماماً أن بريطانيا كانت "تعتبر مكاناً لجمع الأموال والدعوة للإسلام". وقد ورد أن جهاز الأمن في اتصالاته بأبي حمزة حذره من عدم التورط "في التحريض على الإرهاب والعنف في الخارج.. وارتكابهما". لكن يبدو أن ذلك كان من قبيل ذر الرماد في العيون، حيث لم تتخذ أي خطوات في ذلك الحين لكبح جماحه. وبعد أن تولى منصب واعظ وإمام مسجد فنسبري بارك في مارس 1997، تواتر أن أبا حمزة انخرط في تجنيد مئات المجاهدين وتمويلهم وتحريضهم؛ ليتم إرسالهم لكل أنحاء العالم، بما في ذلك معسكرات التدريب في أفغانستان. ويوضح أحد التقديرات أن 50 رجلاً من مسجد فنسبري بارك ماتوا في عمليات إرهابية وهجمات للعصيان جرت في دستة أو أكثر من المنازعات في الخارج. كما كانت تجرى تدريبات على الأسلحة ببنادق الاقتحام داخل المسجد.
ومن المعروف أن تقريرًا أعده صحفي جزائري، هو رضا حسين، عن أن أجهزة الأمن البريطانية كانت على علم بكثير من نشاطات أبي حمزة في المسجد. إذ عمل حسين من أواخر 1998 حتى 2000 لحساب جهاز المخابرات الداخلية، في جمع المعلومات عن أبي حمزة. وقد تذكر مؤخراً كيف: "أنني أخبرتهم أن أبا حمزة كان يغسل عقول الناس ويرسلهم لمعسكرات التدريب الإرهابية التابعة للقاعدة في أفغانستان، وأنه كان يدعو للجهاد والقتل، وأنه تورط في توفير جوازات سفر مزيفة. لقد أخبرتهم بأنه إرهابي رئيسي"، بيد أن المشرف علي حسين في جهاز المخابرات الداخلية لم يبد عليه الاهتمام. واستمر تيار من الراغبين في أن يصبحوا مجاهدين يزورون المسجد للاستماع إلى خطب أبي حمزة، ومنهم ريتشارد ريد، "مفجر قنبلة الحذاء"، ومحمد صديق خان، مفجر قنابل 7 يوليو الذي ذهب إلى هناك في 2002.
ومنذ أواخر التسعينيات، شرع أبو حمزة أيضًا في تنظيم التدريب العسكري لأعضاء منظمة أنصار الشريعة التابعة له في معتزلات ريفية كانت في إنجلترا، وويلز واسكتلندا؛ حيث كانوا يتعلمون كيفية تفكيك الرشاشات ايه كى-47 والبنادق اليدوية. وأوردت صحيفة الأوبزرفر في تقرير لها أنه في دورة تدريب واحدة في ويلز في 1998، تم تدريب نحو عشرة من المجاهدين على أيدي جنود بريطانيين سابقين، وأن بعض هؤلاء المتدربين حارب في البوسنة. ونبهت الصحيفة قائلة: "ولكن أجهزة الأمن البريطانية لم تكن غير معنية أو جاهلة بنشاطات أبي حمزة". وقد كتب أونيل وماكجروري أن هذا التدريب كان يقدمه محاربون قدماء من الجيش البريطاني كان أبو حمزة قد جندهم بعد أن عرف أسماءهم من صفحات مجلة تُعنى بشئون القتال، وأن السلطات البريطانية كانت ترصد بعض دورات التدريب هذه. وكانت إحدى الفرق التي تم رصدها من بين الذين أرسلوا إلى اليمن في ديسمبر 1998 لاختطاف ستة عشر سائحاً غربياً، مات منهم ثلاثة بريطانيون وواحد أسترالي خلال محاولة حكومة اليمن إنقاذهم. وكان أبو حمزة على اتصال بهؤلاء الخاطفين، لكن عندما سلمت حكومة اليمن ملفاً قوامه 137 صفحة عن أبي حمزة للسلطات البريطانية في أوائل 1999، جرى تجاهله في البدء. وفي شهر مارس التالي، تم اعتقال أبي حمزة واستجوابه عن عمليات الاختطاف في اليمن لكن أطلق سراحه بعدئذ دون توجيه اتهام له. وفي الوقت نفسه، فإنه عندما سئلت الحكومة في البرلمان عن معسكرات التدريب في اسكتلندا وويلز، قدم جون دنهام وزير الداخلية، رداً مختصراً لا التزام فيه: "لقد فهمت أن الشرطة أجرت تحقيقات، وأخبروني بأنه ليس هناك أي دليل يبين أن أي جريمة جنائية قد ارتكبت في المكانين".
وكان هذا بعد 11 سبتمبر بشهرين. ولم تتحرك السلطات لاتخاذ إجراء ضد أبي حمزة إلا مؤخراً. ففي سبتمبر 2002، بدأت الشرطة تحقيقاً في جمع الأموال للإرهابيين الذي كان يتم في مسجد فنسبري بارك، وداهمته في شهر يناير التالي. وفي أبريل 2003، أمرت وزارة الداخلية بتجريد أبي حمزة من المواطنة البريطانية، وفي جلسة استماع عرضت في أبريل 2004، اتهمت الحكومة للمرة الأولى أبا حمزة بالتورط في العمل مع جماعات إرهابية، تم اعتقاله في الشهر التالي، عقب طلب بتسليمه قدمته الولايات المتحدة. وقد أخبر مسئول أقدم في وزارة العدل الأمريكية أونيل وماكجروري: "لقد سألنا أنفسنا عما إذا كان يعمل مرشداً لجهاز المخابرات الداخلية، أو أن هناك سراً ما لا تأتمننا الحكومة البريطانية عليه؟ إنه لا يمكن المساس به مطلقاً. ولفقت الحكومة البريطانية التي لم تكن راغبة في أن ترى وهي تسلم مواطناً بريطانياً إلى الولايات المتحدة دون محاكمته في بريطانيا، قضيه تتهمه بالتحريض على القتل والكراهية العرقية، وبعد محاكمة جرت في فبراير 2006، حكم على أبي حمزة بالسجن سبع سنوات. بيد أنه حتى حينذاك، لم ينل أبو حمزة سوى القليل من العقاب – فقد كانت السلطات الأمريكية تريد محاكمته على تجنيد الإرهابيين وتمويلهم وتوجيههم، لكن المدعين البريطانيين اتهموا أبا حمزة بجرائم أقل كثيراً؛ ولذلك فإن المحاكمة لم تقتص حتى صلاته المزعومة بالجماعات الإرهابية.
وتبين حالة حمزة أن أجهزة الأمن البريطانية كانت مستعدة للسماح لمرشدها هذا بأن يستمر في أنشطته لدعم الإرهاب في الخارج في حين تحصل منه على المعلومات عن أنشطة الجماعات المتطرفة داخل مسجد فنسبري بارك. وانطوت هذه السياسة على حمايته من الملاحقة القضائية سنين عدة، ليس فقط بالنسبة للفترة 1997-2000، عندما التقى بأجهزة الأمن، ولكن أيضًا بالنسبة للفترة بعد 11 سبتمبر. ربما أبرمت صفقة من نوع ما لمنع أبي حمزة من كشف المزيد عن علاقته بأجهزة الأمن.
وهناك أيضًا حالة الحماية البريطانية البادية للعيان لأبي قتادة الذي كان قد أصبح معروفاً باعتباره "القائد الروحي للقاعدة في أوروبا" ووصفه القاضي الذي كان يدرس وضعه بوصفه مهاجراً في 2004 بأنه "شخص خطر حقاً.. ينخرط في قلب الأنشطة الإرهابية التي تتم في المملكة المتحدة وترتبط بالقاعدة". وعلى ذلك، فقد تواتر أن أبا قتادة "كان عميلاً مزدوجاً يعمل لصالح جهاز المخابرات الداخلية، وأن بريطانيا تجاهلت تحذيرات جاءت قبل 11 سبتمبر من دسته من الحكومات الصديقة عن صلات القاعدة بالجماعات الإرهابية، ورفضت اعتقاله. وبدلاً من ذلك قيل "إن أجهزة المخابرات تعتزم استخدام عالم الدين هذا مرشداً رئيسياً ضد المناضلين الإسلاميين في بريطانيا". ويقال إن مناضلين كثيرين زاروه، بمن فيهم ريتشارد رايد مفجر قنبلة الحذاء.
وقد زار أبو قتادة أفغانستان في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات؛ حيث يدعي أنه تعرف على أبي مصعب الزرقاوي، الذي أصبح فيما بعد قائد القاعدة في العراق. وكان أبو قتادة قد وفد إلى بريطانيا في 1993 بجواز سفر مزيف من الإمارات العربية المتحدة، وطلب اللجوء، وفي 1994 حصل على تصريح للبقاء في بريطانيا حتى يونيو 1998. وخلال هذه الفترة، يزعم أنه حرض وجند أعضاء لجماعة الجهاد الإسلامي المصرية والجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، إلى جانب جماعات أخرى، وأنه أقام علاقات مع أبي دومة وهو متطرف جزائري تآمر أتباعه فيما بعد لتفجير سوق ستراسبورج. وقد أنكر أبو قتادة الادعاءات بأنه كان سفير القاعدة في أوروبا وأصر على أنه لم يلتق "بن لادن" مطلقاً.
وقد قال محامو أبي قتادة: إن أجهزة الأمن كانت تراقبه من منتصف التسعينيات، وإن "أعماله حظيت بدرجة كبيرة من الموافقة الضمنية: وادعوا: أن الشرطة لم تجعله يعتقد أن أيا من النشاطات التي يقوم بها حتى 2001 غير قانوني، بل الأمر على العكس تماماً، فقد كان يقوم بها علانية.. وكانت أجهزة الأمن على علم بنوع الآراء التي يعرب عنها ولم تتخذ أي خطوات لإيقافة أو تحذيره، أو ملاحقته قضائياً أو منعه من جمع الأموال لجماعات تعتبر إرهابية، خاصة فصيل خطاب الذي كان يقاتل في الشيشان، أو للتدريب في أفغانستان.
وقد تكتشف في الإجراءات القانونية التي اتخذت للبت في وصفه تاجراً أن جهاز المخابرات الداخلية قد عقد ثلاثة اجتماعات مع أبي قتادة في يونيو وديسمبر 1996 وفي فبراير 1997. وفي الاجتماع الأول سجل أبو قتادة: "تفسيره الحماسي للجهاد ولنشر الإسلام ليسود العالم". كما ادعى أنه كان له "تأثير روحي قوي على الجالية الجزائرية في لندن"، وأنه حسبما قال شاهد من جهاز المخابرات الداخلية في المحاضر: "وافق على استخدام تأثيره للتقليل لأدنى حد من خطر قيام رد فعل عنيف على التسليم المحتمل لرضا ]رشيد[، قائد الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية في المملكة المتحدة"، وأن جهاز المخابرات الداخلية "كان يطلب منه أن يكبح جماح الجماعة، وبصفة أعم أنشطة اللاجئين الجزائريين في المملكة المتحدة". وفي الاجتماع الثاني، أشار ضابط جهاز المخابرات الداخلية إلى أن أبا قتادة "عرض أن يبذل قصارى جهده لمساعدتي في أي تحقيق بشأن التطرف الإسلامي". وفي الاجتماع الثالث، قال الضابط: "لقد كنت أتوقع أن يستخدم بالكامل نفوذه ذلك- كلما أمكنه- للسيطرة على المتهورين، وضمان أن يبقى الإرهاب بعيداً عن شوارع لندن وكل أنحاء المملكة المتحدة". وخلص القاضي الذي كان ينظر في وضع أبي قتادة بوصفة مهاجراً إلى أنه خلال هذا الوقت 1965-1997، "ربما كان يعتبر المملكة المتحدة ملاذاً آمناً ويعتقد أن تمكنه من العمل هناك مفيد للغاية".
وبينما كان أبو قتادة يعرض نفسه على أنه قادر على منع وقوع هجمات إرهابية وكشف المناضلين الخطرين، استمر طوال ذلك في أنشطته لدعم المتطرفين، وهو ما كان معروفاً لجهاز المخابرات البريطانية بدون أدنى ريب. وفي مارس 1995 أصدر أبو قتادة فتوى تبرر قتل زوجات "المرتدين عن العقيدة" وأطفالهم بغية إيقاف قمع الأخوات و"الإخوة" المسلمين في الجزائر، ووفرت هذه الفتوى تبريراً دينياً لقيام الإرهابيين بقتل النساء والأطفال. ومع ذلك فقد ادعى جهاز المخابرات الداخلية فيما بعد أنه توصل في 1997 إلى تقييم لأبي قتادة يقول إنه ليس مجاهداً، كما تواتر ادعاء بأن آراءه بالنسبة للجهاد العالمي "تشددت" في السنوات التالية لاجتماعاته بجهاز المخابرات الداخلية. وهذا الاستنتاج ليس ملائماً تماماً لمقتضى الحال حاليًا.
وفي 1998 حكم على أبي قتادة بالسجن غيابياً في الأردن بسبب تحريضه على شن سلسلة من الهجمات بالقنابل في البلاد، وطالبت عمان بتسليمه. وكانت فترة تصريح بقائه غير محددة المدة في بريطانيا تستحق المراجعة في تلك السنة، في الوقت نفسه الذي كانت بريطانيا قد تلقت فيه تحذيرات من عدة بلدان من ارتباطات أبي قتادة بالإرهاب – لكنها سمحت له بالبقاء في البلاد ولم تعتقله. وفي 1999، أصدر المشرف في جهاز المخابرات الداخلية على رضا حسين، الجاسوس الجزائري لجهاز المخابرات الداخلية الذي كان يعمل داخل مسجد فنسبري بارك، تعليمات له بأن يجتمع بأبي قتادة مرتين شهرياً. وبعد هذه المرحلة، استمر علم الجهاز بما يقال عن أن أبا قتادة يجمع الأموال لأنشطة إرهابية في الخارج؛ حيث إن حسين أخبرهم بذلك.
وفي فبراير 2001 قام ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب باعتقال أبي قتادة للاشتباه في تورطه في التخطيط لهجوم في ستراسبورج، لكن تقرر أنه ليست هناك أدلة كافية ضده، ومن ثم لم توجه له أي تهم. وفي أعقاب 11 سبتمبر، اعتبرته الولايات المتحدة "إرهابياً عالمياً وطيد العزم". بيد أن السلطات البريطانية لم تتخذ أي إجراء ضده، وفي أكتوبر 2001، أجرى حواراً مع الأوبزرفر ادعى فيه أن جهاز المخابرات الداخلية فاتحه من خلال وسطاء "في منحه جواز سفر وتأشيرة إيرانية حتى يستطيع أن يترك البلاد"، ويهرب إلى أفغانستان. وأبرزت الصحيفة أن السلطات كانت تعتقد "أنه هناك أدلة راسخة بما يكفي لتوجيه تهم إليه" في حين أنه لا يمكن ترحيله للأردن؛ حيث لا يزال هذا البلد يطبق عقوبة الإعدام. بيد أنه هناك شكوك في أن الجهاز المذكور كان يسعى إلى حماية مرشده وأنه لا يريد أن يفضح أبو قتادة تفاصيل علاقته به. وقد ورد أن أبا قتادة رفض العرض.
وفي ديسمبر 2001، عندما كان البرلمان يوشك على أن يصدر تشريعاً جديداً لمحاربة الإرهاب بعد 11 سبتمبر، اختفى أبو قتادة. وقد أوردت صحيفة التلجراف أن "ضباط مكافحة الإرهاب الفرنسيين يعتقدون أن نظراءهم البريطانيين في جهاز المخابرات الداخلية تواطئوا في اختفائه". وقد أخبر مرشد آخر لجهاز المخابرات الداخلية، وهو بشير الراوي، وهو عراقي عاش في بريطانيا تسعة عشر عاماً، فريقاً من الخبراء العسكريين في خليج جوانتانامو فيما بعد: "إنني واثق من أن المخابرات البريطانية كانت على بذلك؛ لأنني أخبرتهم به". وقال إنه زار أبا قتادة مرات كثيرة في صيف 2002 بعلم من جهاز المخابرات الداخلية. وقد تسرب فيما بعد أن أبا قتادة ظل "مختفياً" لمدة عشرين عامًا تقريباً في شقة في بيرموندسي في جنوب لندن؛ حيث كانت تزوره باستمرار زوجته وأبناؤه، كذلك كانت تجري معه اتصالات من الخارج. وأوردت مجلة التيم أن مسئولين أقدم في المخابرات الأوروبية قالوا: إن "أبا قتادة انزوى في بيت آمن في شمال انجلترا، أسكنته فيه أجهزة المخابرات البريطانية هو وأسرته وأطعمتهم وكستهم". وتقول المصادر: إن "الصفقة كانت تقضي بحرمان أبي قتادة من الاتصال بالمتطرفين في لندن وأوروبا، لكن لا يمكن اعتقاله أو طرده لأنه لا أحد يعرف رسمياً أين هو؟ لقد فاز البريطانيون لأن آخر ما كانوا يريدونه هو تسليم شخص تتعرض يد من يمسه للحرق؛ وذلك خوفاً من انتقام القاعدة لكن وجوده كان يتعارض مع دعم لندن للحرب على الإرهاب".
وأخيراً "تم العثور" على أبي قتادة في أكتوبر 2002، بعد إصداره وثيقة من عشر صفحات تبرر هجوم 11 سبتمبر. واحتجزته السلطات البريطانية بضعة أيام بعد ذلك للاشتباه في اضطلاعه "بطائفة من دعم الإرهاب، بما في ذلك جمع الأموال، نيابة عن منظمات إرهابية دولية شتى" والإدلاء "ببيانات عامة لدعم الأنشطة العنيفة لهذه الجماعات". وبعد ذلك جرى احتجاز أبي قتادة دون توجيه اتهام له في سجن بلمارش شديدة الحراسة حتى تم إطلاق سراحه، على أن يخضع لأمر بالمراقبة، في مارس 2005، عندما أسقطت محكمة الاستئناف العليا بمجلس اللوردات قانون طوارئ لمكافحة الإرهاب كان يسمح بالاحتجاز لما لا نهاية بدون محاكمة. بيد أن السلطات احتجزته ثانية بعد ذلك بخمسة أشهر، مباشرة عقب أن وقعت بريطانيا على اتفاقية لتسليم لمجرمين مع الأردن، لكن أبا قتادة أفرج عنه من السجن مرة ثانية في يونيو 2008، بشرط أن يخضع لشروط كفالة صارمة مع تحديد إقامة لمدة 22 ساعة يومياً، وذلك بعد أن قبلت المحكمة العليا الاستئناف المقدم منه ضد ترحيله للأردن، على أساس أنه من المحتمل أن يواجه هناك محاكمة بتهمة الإرهاب استناداً لأدلة قدمها شهود كان قد تم تعذيبهم. بيد أنه في فبراير 2009، قضت محكمة الاستئناف العليا بمجلس اللوردات بأنه يمكن ترحيل أبي قتادة للأردن؛ حيث إنه عندما كان يعارض الترحيل فإن ذلك تم من سجن في بريطانيا.
وقد جند جهاز المخابرات الداخلية أناساً آخرين كانوا قريبين من أبي قتادة، مثل بشير الراوي الذي تمت مفاتحته عقب 11 سبتمبر مباشرة في أن يعمل وسيطاً بين الجهاز وأبي قتادة وتقديم معلومات عن هذا الأخير. بيد أن هذا نقل في 2002 معلومات إلى وكالة المخابرات المركزية تقول بأن الراوي كان إرهابياً متأسلماً – وهو اتهام زائف كلية، حسبما قال محاموه. وسارعت الولايات المتحدة بالقبض عليه في جامبيا وحبسته في خليج جوانتانامو خمس سنوات؛ حيث ادعى أنه تعرض هناك باستمرار لسوء المعاملة والتعذيب النفسي، وأطلق سراحه في أوائل 2007.
وأخيراً، هناك حالة الشيخ عمر بكري محمد، وهو سوري المولد رأس جماعة "المهاجرون". وحالة بكري مثيرة للاهتمام بصفة خاصة في ضوء احتمال تعاونه مع المخابرات البريطانية للمساعدة في إرسال مجاهدين إلى كوسوفو في أواخر التسعينيات، إلى جانب مشاركته في عملية جهاز المخابرات الداخلية السرية للمساعدة في تدريب مقاتلي جيش تحرير كوسوفو في معسكرات في ألبانيا. وفي ذلك الوقت كان بكري يوصف في وسائل الإعلام البريطانية بأنه "رئيس الجناح السياسي للجبهة الإسلامية الدولية التي أسسها أسامة بن لادن". وذلك من المثير للاهتمام أيضًا في ضوء صلة جماعة "المهاجرون" بتفجيرات لندن في يوليو 2005.
كان بكري قد فر من سوريا بعد انضمامه للإخوان المسلمين في ثورتهم على نظام الأسد، الذي سحق المنظمة بوحشية في 1982. وذهب أولاً إلى السعودية، لكنه طرد منها في 1985 ووصل إلى بريطانيا في يناير 1986؛ حيث منح فيها بعد تصريح إقامة مفتوح. وتم إلقاء القبض على بكري في 1991 بعد أن قال: إن جون ميجور رئيس الوزراء هدف مشروع للاغتيال؛ بسبب تورط بريطانيا في حرب الخليج ضد العراق. وأصبح قائداً للفرع البريطاني الأول لحزب التحرير، لكنه انقسم مع قادته الدوليين وشكل منظمته الخاصة، "المهاجرون" في يناير 1996". وقد تباهى بكري في حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر باللغة العربية من لندن بأنه كان في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، يرسل من 300 إلى 400 مناضل سنوياً لحضور دورات للتدريب العسكري وتعلم حرب العصابات في صحراء ميتشجان وميسوري في الولايات المتحدة، وأنه ذهب للقتال في كشمير والشيشان وكوسوفو. وحينذاك كانت روسيا تدعو الحكومة البريطانية لإغلاق منظمة "المهاجرون" باعتبارها واحدة من منظمات كثيرة في بريطانيا ترسل عشرات من المقاتلين إلى الشيشان. كما أبرزت مذكرة كتبها عميل لمكتب التحقيقات الاتحادية الأمريكي قبل 11 سبتمبر مباشرة أن هناك صلة بين بكري وعدة مشتبه بهم ينتظمون في مدارس للتدريب على الطيران في الولايات المتحدة، وأن أحد الخاطفين انتظم في واحدة منها. لكن بريطانيا لم تطبق قانون الإرهاب ضد جماعة "المهاجرون" إلا في يوليو 2003. وبعد أن تبين أن موقعها على الشبكة العنكبوتية يتضمن تهديداً مباشراً بشن هجمات إرهابية على أهداف حكومية، تمت مداهمة مكاتب جماعة "المهاجرون" واحتجاز بكري واستجوابه، قبل أن يطلق سراحه بدون توجيه اتهام له.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بكري قد تعاون مع أجهزة الأمن بعد انتهاء حرب كوسوفو في يونيو 1995، وتبين حواراته الصحفية أنه كان يعتقد أن لديه "حصانة عامة" على الأقل حتى منتصف 1999. ومن الواضح أن بعضاً من أعضاء مجتمع الجهاد اكتشف إمكانية تواطئه مع السلطات، ففي نوفمبر 2001 مثلاً، حذرت مطبوعات عزام التي تدر من لندن المجاهدين من بكري وجماعة "المهاجرون"، قائلة: "كجزء من خطة "إخلاص" بكري زعيم منظمة "المهاجرون"، في أعين المسلمين البريطانيين، نتوقع أن تلقى السلطات البريطانية القبض عليه في المستقبل القريب، لكن لتطلق سراحه عقب ذلك". والواقع أن الشرطة وأجهزة الأمن استجوبت بكري عدة مرات – "على الأقل ست عشرة مرة" كما قال هو بنفسه – لكنه نجا من الاعتقال على الدوام.
لكن الأكثر إثارة للاهتمام، أنه بعد تفجيرات لندن في 2005، لم تستوجب أجهزة الأمن بكري باعتباره مشتبهاً به محتملاً، وبدلاً من ذلك سمح له بمغادرة البلاد. وبعد شهر من تفجيرات 7 يوليو، ترك بكري بريطانيا طواعية للذهاب إلى لبنان، وبعد ذلك بسنة، أعلن تشارلس كلارك وزير الداخلية في يوليو 2006، ان بكري لن يسمح له بالعودة إلى بريطانيا نظراً لأن "وجوده لن يحقق الصالح العام". وتثير هذه القرارات مزيداً من الشبهات بشأن علاقة هوايتهول ببكري في ضوء الأنشطة الجهادية التي كان قد انخرط فيها، وكذلك الصلات التي ذاع خبرها بين مفجري قنابل يوليو، وغيرهم من الطامحين لأن يكونوا من مفجري القنابل وبين منظمة المجاهدين. فعلى سبيل المثال، فإن محمد بابار – وهو أمريكي اعترف إما المحكمة بأنه مذنب في سلسلة من المؤامرات الإرهابية وقدم أدلة ضد جماعة من المتآمرين على تفجير القنابل في بريطانيا – كان عدوا سابقاً في جماعة "المهاجرون"، وكان على اتصال بأعضائها في لندن خلال التدبير لمؤامرة إرهابية في العامين التاليين لهجوم 11 سبتمبر.
وقد اجتمع بابار شخصياً ببكري، واتصل به فيما بعد عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف، عندما كان يقيم مكتباً لجماعة "المهاجرون" في بيشاور في باكستان. كما حضر عمر الخيام وهو قائد عصابة، "مؤامرة القنابل المصنوعة من الأسمدة" الذي أدين في أبريل 2007. كما كان لعمر خان شريف، الذي تطوع لتفجير قنابل في بار تل أبيب 2003، صلات بجماعة "المهاجرون" وكان من أتباع بكري. وبحلول الوقت الذي سافر فيه بكري إلى لبنان، كانت جماعة "المهاجرون" قد شكلت 81 منظمة منفصلة تعمل واجهة في ستة بلدان، حسب تحقيق أجرته شرطة نيويورك، وكانت تضم من 600 إلى 1500 عضو في بريطانيا. وربما كان سيغدو من المفيد لأجهزة الأمن لو كانت قد استجوبت بكري عن اتصالاته. وربما عرض البريطانيون على بكري الصفقة نفسها التي كانوا قد عرضوها على أبي قتادة ليرحل عن البلاد، وينجو من تقديمه للمحاكمة، في ضوء ما كان يمكن أن ينكشف عن علاقته بأجهزة المخابرات.
وختاماً، يحتمل أن عهد الأمن منع وقوع الهجمات المتأسلمة في بريطانيا في التسعينيات، لكن بتكلفة باهظة هي إعطاء "ضوء أخضر" للقيام بعمليات إرهابية في الخارج. بيد أنه في السنوات التي تلت 11 سبتمبر، قبل غزو العراق وبعده، بدأ تدبير عدد من مؤامرات تفجير القنابل في بريطانيا. ربما أثمر تجنيد المتطرفين الإسلاميين بعض معلومات للمخابرات عن أنشطتهم في الخارج، لكنه يصعب الحكم على مدى فائدة ذلك أو المدى الذي أفادت به السلطات البريطانية نظراءها الأجانب عن ذلك. يحتمل أن أجهزة الأمن كانت ساذجة فحسب في الاعتقاد بأن مرشديها يستطيعون السيطرة على "المتهورين"، لكن يحتمل أيضًا أن اقساماً من مؤسسة الأمن البريطانية لم يحركها الحصول على المعلومات وكبح جماح المتطرفين فحسب، وإنما حركتها المزايا التي تعود على السياسة الخارجية البريطانية نتيجة إيواء هؤلاء الأفراد في لندن. ولم يرد برهان على صحة هذا القول؛ نظراً للافتقار لمزيد من الأدلة، لكنه يتسق مع استخدام بريطانيا قديم العهد للمتأسلمين لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية. وبذلك أصبحت السياسات البريطانية خطيرة بكل معنى الكلمة على عامة الناس في بريطانيا وفي العالم.
لقراءة الحلقة الأولى اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الثانية اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الثالثة اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الرابعة اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الخامسة اضغط هنا
ولقراءة الحلقة السادسة اضغط هنا