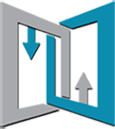قاعدة "بن لادن" في لندن.. صفقات بريطانيا مع تنظيم القاعدة (الحلقة السادسة)
الإثنين 19/أكتوبر/2015 - 03:14 م
طباعة

ما زلنا نبحر بين صفحات الكتاب الكاشف لعلاقة بريطانيا مع الجماعات الإرهابية من خلال الوثائق التي تم رفع الحظر عنها من قبل المخابرات البريطانية والتي قدم قراءة وتحليلًا لها الكاتب والصحفي مارك كورتيس، وفي الحلقة السابقة تناولنا خفايا علاقة المملكة المتحدة مع تنظيم الجهاد، وفي هذه الحلقة نتعرض للعلاقة الآثمة مع تنظيم القاعدة.
احتضان القاعدة
جاء مطلع التسعينيات بالإرهاب المتأسلم لكل من الولايات المتحدة وأوروبا للمرة الأولى، وذلك مع أول حرب للجهاد في أوروبا – حرب البوسنة بعد 1992، وتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 1993، والهجمات الأولى في أوروبا الغربية، وتفجيرات 1995 في مترو باريس. وعانت السعودية هي أيضًا من أول هجمات إرهابية كبيرة تتعرض لها في نوفمبر 1995 – عندما فجرت عربة نقل بضائع مفخخة مكتباً يؤوي بعثة عسكرية أمريكية كانت تدرب الحرس الوطني – وفي يونيو 1996 – عندما أصاب تفجير شاحنة مفخخة ناطحات سحاب الخبر التي كانت تؤوي عاملين بالقوات الجوية الأمريكية، وقتلت 20 شخصاً. كما أثر الإرهاب في بلدان كثيرة أخرى. فقد ابتليت الجزائر بحرب أهلية وحشية بين الحكومة والقوى المتأسلمة أزهقت أرواح 100 ألف شخص بعد نشوبها في 1992. وفي أفغانستان، انقضت فضائل المجاهدين على بعضها البعض بعد سقوط الحكومة التي كان السوفيت يؤيدونها في 1992؛ مما تسبب في قتل الآلاف وتدمير العاصمة كابول، ومهد عدم خضوعها الأثيم للقانون الطريق لاستيلاء طالبان على السلطة فيما بعد. كذلك شهدت الهند ودول آسيا الوسطى موجه عارمة من الإرهاب الذي استند لمجموعات باكستانية كانت تسعى إلى "تحرير" كشمير التي تسيطر عليها الهند وتوسيع نطاق الثورة الإسلامية.
كانت هذه نتائج كريهة لعولمة الإرهاب؛ حيث كان المجاهدون المتشددون، الذين ارتكنوا إلى خبراتهم في الحرب في أفغانستان في الثمانينيات وتدربوا في المعسكرات الأفغانية والباكستانية، قد عادوا لبلادهم لمحاربة حكوماتهم، محاولين تكرار نجاحهم في مواجهة السوفيت. وتطورت أيديولوجية الجهاد إلى ما وصفه جيلر كيبل المحلل الفرنسي بأنه جهاد سلفي يطالب بالعودة إلى الأسلاف الأتقياء، والالتزام بالنصوص المقدسة بأكثر معانيها حرفية. ويعني هذا، الالتزام بالعنف وتحدي ما كان يعتبر اعتدال جماعات مثل الإخوان المسلمين، التي كانت تتعرض للانتقاد لمشاركتها في الانتخابات وإضفاء مشروعية دينية زائفة على النظم التي تجب الإطاحة بها. وتوافرت دفعة تعزيز أخرى لهذه العملية، بفضل الرعاية السعودية القائمة لبعض هذه الجماعات إلى جانب قيام السعودية بتخفيض تمويلها للإخوان المسلمين تدريجياً. فقد تعرض الأخيران لغضب السعودية بسبب تأييدهم لغزو صدام حسين للكويت في 1990، الذي كان يهدد السعودية على ما يبدو. وخسف نفوذ الإخوان، ظهور مجموعة أكثر عنفاً على المسرح آنذاك، وكان الجهاديون هم من تحتاج السعودية إلى استخدامهم لنشر الإسلام الوهابي وضمان بقاء بيت آل سعود.
وفي خضم هذا التشدد المتنامي، أعدت المخابرات البريطانية في صيف 1993، تقريراً قدمته لوزارة الخارجية بعنوان "الأصولية الإسلامية في الشرق الأوسط". وهو يمثل تلخيصاً متقناً لبعض المعتقدات التي جعلت المسئولين البريطانيين يتعاملون مع المتأسلمين المتطرفين. فقد عرض التقرير وجهة نظر جهاز المخابرات الخارجية البريطاني بشأن جذور الأصولية وتأثيرها، ملاحظاً أنها "تتغذى على الفشل في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والفساد في الحكم وإفلاس الأيديولوجيات السياسية – الشيوعية والناصرية والبعثية، إلخ". وبالطبع، فقد كانت هذه أيديولوجيات هي التي بذل البريطانيون أقصى جهدهم لتقويضها، وبذلك مهدوا الطريق لصعود الأصولية. كما بين التقرير أن المسئولين كانوا مدركين أن "الأموال السعودية والخليجية الخاصة الموهوبة للقضايا الإسلامية، عامل مشترك في كثير من أنحاء المنطقة" – وأنهم يواصلون تعميق دعمهم لهذه النظم.
وبعد ذلك يعترف التقرير بأن "قدرة الإسلام بوصفه محوراً للمعارضة، توفر أيديولوجية جاهزة تؤكد على العدالة"، وأن الأمر الحاسم أيضا هو أن "الأصولية ليست بالضرورة مرادفاً للتطرف السياسي وسياسات معاداة الغرب – وذلك تعليق يوحي بالكثير وسبب رئيسي في أن بريطانيا ظلت تتعامل مع هذه المجموعات لهذه المدة الطويلة.
ويواصل التقرير:
أن المجموعات الأصولية التي تدعو للعنف والثورة أقلية. ومع ذلك، فإن هناك خطاً معادياً للغرب في كل الحركات الأصولية الرئيسية في المنطقة، حيث تعتبر الثقافة والمادية الغربية- خاصة الأمريكية- تهديداً للقيم الإسلامية. والأهداف الأعرض للأصوليين تتعارض تقريباً مع المبادئ الليبرالية الغربية – فهي تعارض التعددية السياسية، والتسامح الديني، وحقوق المرأة.
ولا ريب ان النقطة الأخيرة صحيحة، لكن هذه أيضا كانت سمات لأى حكومة ساندتها بريطانيا في الشرق الأوسط طوال عقود كثيرة، تحديداً للتصدي للحكومات التعددية الأكثر دعماً لحقوق المرأة مثلاً.
كذلك لاحظ التقرير أن الجماعات الأصولية "مستعدة لاستخدام صناديق الاقتراع للحصول على السلطة. لكن هناك شك تام في أن "أحزاب الله" هذه ستخضع سلطتها السياسية، فور تحقيقها لعملية ديمقراطية". بيد أن الخاتمة يردد فيها ما يلي:
أن الأصولية لا تمثل تهديداً متماسكاً وموحداً للمصالح الغربية بالطريقة التي فعلت بها الشيوعية ذلك ذات مرة. وتقتصر جاذبيتها في البلاد الغربية على الأقليات الإسلامية، وخطر التدمير في حده الأدنى، على الأقل في الولايات المتحدة، أن التعامل مع النظم الأصولية المتطرفة لا يمكن التنبؤ به بدرجة كبيرة لكنه يمكن تدبره.
إن التحليل القائل بأن بريطانيا يمكن أن تكون لها علاقات يستطاع تدبرها مع النظم الأصولية مليء بالإيحاءات. ويساعد الاعتقاد بأن الأصولية لا تمثل تهديداً استراتيجياً للمصالح الغربية في تفسير السبب في أن بريطانيا تعاونت مع هذه الجماعات لمواجهة قوى لم تكن تمثل مثل هذا التهديد، خاصة الناصرية. وفي الوقت نفسه، فإن وجهة النظر القائلة إن جاذبية الأصولية في بريطانيا كانت صغيرة تفسر جزئياً تسامح السلطات مع بعض هذه الجماعات وحمايتها لها خلال صعود نجم لندنستان في التسعينيات. ثم، إن هذه كانت وجهة نظر مسئولين بريطانيين رئيسيين؛ حيث استمرت هوايتهول في سياساتها بحكم الأمر الواقع في مساندة الإسلام المتطرف..
إنقاذ السعوديين وامبراطوريتهم المالية
بعد غزو صدام حسين للكويت في أغسطس 1990، ساهم النظام السعودي بما يربو على 50 مليون دولار في حرب قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لإبادة الجيش العراقي في فبراير 1991. وقدم هذا النزاع دفعة مساندة حاشدة للإسلام السني. ففي اجتماع مع الأمير تركي رئيس المخابرات السعودية ووزير الدفاع الأمير سلطان، عرض "بن لادن" استخدام قواته العربية الأفغانية التي أكسبتها المعارك صلابة في الدفاع عن المملكة، لكن السعوديون رفضوا هذا الاقتراح، واختاروا بدلاً من ذلك نشر نصف مليون من القوات الأمريكية الكافرة في أرض الحرمين. كانت الحقيقة واضحة جلية، فقد كان السعوديون يعتمدون كلية على الولايات المتحدة في بقائهم. وحينذاك أصبحت الجماعات الجهادية، التي نذرت نفسها لاستئصال الوجود الغربي من السعودية، ترى أن الحكام السعوديين خانوا الإسلام، وأن حشد مجندين لقضيتهم أصبح أكثر سهولة في السعودية، التي سرعان ما أصبحت هدفاً للهجمات الإرهابية.
وها هي الأيام تثبت رؤية الكاتب عن الهجمات المحتملة والتي أصبحت واقعًا تعيشه السعودية هذه الأيام..
للمزيد عن تلك الهجمات:
هجمات مسجد القطيف.. اضغط هنا
هجمات مسجد الدمام .. اضغط هنا
هجمات مسجد تابع لقوات الطوارئ السعودية.. اضغط هنا
إطلاق نار في حسينية الحديرية بالسعودية.. اضغط هنا
وهبت بريطانيا للدفاع عن الحليف الأصولي والنظام الكويتي لجابر الصباح، الذي حكمت أسرته الإمارة، في ظل الحماية البريطانية، من منتصف القرن الثامن عشر. كانت أسرة الصبح من أقرب حلفاء هوايتهول في المنطقة، تسيطر على دولة غنية بالنفط تستثمر مليارات من إيراداتها في الاقتصاد البريطاني. وأرسلت بريطانيا ثاني أكبر فرقة عسكرية في القوة المتحالفة – ما يربو على 40 ألف جندي- إلى جانب سفن حربية وأسراب من السلاح الجوي الملكي الذي كان يعمل من قواعد في السعودية، كما لعبت القوات البرية البريطانية دوراً مهماً، فقد كان نشر جهاز المخابرات الخارجية لقواته هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وانطوى على العمل خلف خطوط العدو لتدمير مرافق الاتصالات العراقية ومنصات إطلاق قذائف "سكود" المتحركة المضادة للطائرات كمقدمة للهجوم الرئيسي بقيادة الولايات المتحدة. كما ساعد فريق من ضباط الجهاز في تنظيم المقاومة الكويتية في ارتباط مع السعوديين. وأقيم معسكر لتدريب المتطوعين الكويتيين في شرق السعودية، إلى جانب برامج أمريكية مماثلة، في حين تم إلحاق أعضاء كثيرين من الجهاز بفرق التدريب هذه وقام الجهاز أيضًا بتوفير الأسلحة. وأصبح التحالف الأمريكي البريطاني السعودي السري بادياً للعيان مرة أخرى ولكن امتداداً حقيقياً للعملية التي كانت قد انتهت تواً في أفغانستان.
وقد ذكر الجنرال السير بيتر دي بيليير مؤخراً:
مثلما ساندنا نحن البريطانيين نظام حكم الشيوخ دوماً منذ انسحابنا من الخليج في أوائل السبعينيات، ورأيناه يزدهر، كنا متحمسين لاستمراره. فقد كانت السعودية صديقاً قديماً مجرباً بالنسبة لنا، واستخدمت ثروتها النفطية الهائلة بطريقة حميدة ومتروية، وكان من نتيجة ذلك أن أصبح مستوى المعيشة مرتفعاً جداً. ومن ثم فإن من مصلحتنا للغاية أن يظل هذا البلد ونظامه مستقرين بعد الحرب.
وبالطبع كانت هذه الطريقة "الحميدة والمتدبرة" التي استخدم بها السعوديون ثروتهم من النفط محض تضليل، كما سنرى فيما بعد، إذ كانت الفكرة الأساسية هي أن هؤلاء هم حلفاؤنا، وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون بأموالهم بقدر ما يعني الأمر الصفوة البريطانية.
وخلال الحرب، شجعت الولايات المتحدة الشيعة في جنوبي العراق على أن يهبوا في ثورة ضد صدام، لكن بمجرد أن بدأ هذا كما ينبغي في مارس 1991، سمحت واشنطن للقوات العراقية بإعادة التجمع وسحق التمرد بصورة وحشية وذبحت الآلاف. وحلقت طائرة أمريكية فوق طائرات مروحية عراقية، لتوفر لها الحماية بالفعل، في حين أوقفت القوات الأمريكية في مرحلة من الانتفاضة، المتمردين الشيعة الذين كانوا قد وصلوا لمخزن السلاح للحصول على ذخيرة. إذ فضلت واشنطن الإبقاء على صدام في السلطة، على أن تطلق العنان لقوى قد تتحالف مع عدوها، جمهورية إيران الإسلامية. كذلك حدث مع البريطانيين، الذين شجعوا المتمردين في البدء، فقد ساعد جهاز المخابرات الخارجية إلى جانب وكالة المخابرات المركزية في إنشاء محطة إذاعة العراق الحر، التي كانت تذيع دعاية أنجلو أمريكية في كل أنحاء البلاد. وعندما سئل أحد مسئولي المخابرات البريطانية عن النداءات السابقة للحض على الثورة، رد: "لم نفكر في ذلك على نحو صحيح". وكان ذلك هراء: إذ إن تحريض كل من واشنطن ولندن للشيعة، سياسة تقليدية لهما. استخدام القوى الإسلامية لتحقيق أهداف قصيرة الأجل محددة، وكان الهدف في هذه الحالة هو زعزعة حكم صدام حسين وتمهيد الطريق لطرد العراق من الكويت. وبمجرد أن تحقق هذا الهدف، أصبحت هذه القوى مستهلكة، وكان ذلك حينذاك قد أصبح نمطاً مألوفاً للغاية في التواطؤ الأنجلو أمريكي مع القوى الإسلامية في المنطقة.
ومع عودة صدام إلى صندوقة، كان نظامه لا يزال قادراً على أن يكون مفيداً. وعادت بريطانيا والولايات المتحدة إلى التسليم بأن ديكتاتورية العراق الوحشية يمكن أن تتصدى لمساعي إيران الشيعية للسيادة في المنطقة – وهي سياسة كانت قد بدأت عندما سلحت واشنطن ولندن العراق إبان حربه مع إيران التي كانت قد بدأت قبل عقد من الزمن. وكان هذا الدعم لنظام وطني علماني ضد المتأسلمين المتطرفين انعكاساً للسياسة البريطانية والأمريكية التقليدية في المنطقة؛ مما يبين الدرجة التي أصبحت بها إيران الشيعية تهديداً استراتيجياً للغرب. لكن ذلك لم يكن سوى موقف مؤقت، فبمجرد أن دعم صدام قبضته على السلطة في ظل نظام دولي صارم للعقوبات، ارتدت سياسة بريطانيا والولايات المتحدة إلى التواطؤ مع القوى المتأسلمة للإطاحة به.
وبينما كانت القوات الأمريكية تبيد قوات صدام من قواعدها في السعودية، تحول "بن لادن" بين عشية وضحاها من كونه نصيراً للنظام السعودي إلى خصم له. وفي الوقت نفسه، كان مستمراً في تجنيد المتطوعين- وكان كثيرون منهم سعوديين- للتدريب على حرب العصابات في معسكراته في أفغانستان، استعداداً للجهاد المقبل. بيد أنه بدلاً من طرد بن لادن من السعودية، ورد أن السعوديين حاولوا في مطلع 1991 إبرام صفقة معه، يترك بن لادن بمقتضاها السعودية مقابل قيام السعوديين بتقديم الأموال لتزويد قواته العربية الأفغانية باحتياجاتها، وبشرط ألا يستهدف الإرهاب السعودية نفسها. وفي حين بدا أن بن لادن قد "طرد" من السعودية، فقد انتقل إلى السودان في 1992، حيث قدم له حسن الترابي رئيس الجبهة الوطنية الإسلامية قاعدة جديدة. بيد أن السعوديين لم يشجعوا مطلقاً السودانيين على اتخاذ أي إجراء ضده، بل لقد ظل "بن لادن" على جدول الرواتب التي يدفعونها.
وفي شهر أبريل 1994 فحسب، بعد استمرار النقد العلني لبيت آل سعود، سحب السعوديون الجنسية من بن لادن. بيد أنه بعد حدوث هذا، ظلوا على ما يبدو يحاولون شراءه بالأموال. وهكذا ففي 1996، تواتر أن السعوديين الذين كانوا لا يزالون خائفين على ما يفترض من الهجمات التي يحرض عليها بن لادن في المملكة، باركوا صفقة سرية أبرمها "بن لادن" مع ضابط عسكري باكستاني له صلات وثيقة بجهاز المخابرات الباكستاني، تقضي بأن يستمر الأخير في تزويد القاعدة بالحماية والسلاح. كما ادعت بعض مصادر المخابرات أنه في العام نفسه، اجتمعت مجموعه من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين في باريس واتفقوا على الاستمرار في مساعدة شبكة بن لادن الإرهابية. ولاحظ تقرير أعده في 2002 جان تشارلس وهو خبير مخابرات فرنسي أن 300 مليون دولار على الأقل كانت قد تدفقت إلى القاعدة وغيرها من جماعات الجهاد في السنوات السابقة، معظمها من واهبين وجمعيات خيرية في السعودية.
وكانت المخابرات الأمريكية تورد تقارير عن التمويل السعودي للإرهاب بحلول منتصف التسعينيات، على الأقل. وذكر تقرير سري لوكالة المخابرات المركزية كشفت عنه الصحافة الأمريكية في 2003 أن "النشطاء الإسلاميين يهيمنون على قيادة أكبر الجمعيات الخيرية" وأنه "حتى أعضاء ذوي مناصب سامية في وكالات جمع المعلومات والرصد في السعودية والكويت وباكستان – مثل المفوضية السعودية السامية – متورطون في أنشطة غير قانونية، من بينها دعم الإرهاب". ويصعب تصديق أن البريطانيين لم يكونوا على علم بهذا الدور السعودي. وتمثل تطور آخر مهم بالنسبة للسعوديين في أن نهاية النظام السوفيتي في 89-1991، أتاحت للتمويل الإسلامي أعظم فرصة للنمو منذ إحيائه في منتصف السبعينيات. فقد انتهت حينذاك عقبات سياسية كبرى كانت تعترض إلغاء القيود المالية، الذي كانت قد طالبت به سياسة تاتشر وريجان النقدية في العقد المنصرم. وأصبحت الأموال السعودية تستطيع آنذاك أن تنتشر إلى مدى من العالم أبعد حتى من ذلك.. وبذلك وصلوا إلى المسلمين في شمال إفريقيا وآسيا الوسطى. وتولت المهمة البنوك والجمعيات الخيرية السعودية التي عملت أدوات رئيسية لتمويل انتشار الأصولية الإسلامية.
وكانت البنوك البريطانية والأمريكية تدير قدراً كبيراً من الأموال السعودية والعربية الأخرى المتداولة في النظام المالي الإسلامي، في حين كانت بعض المجموعات الإرهابية تستخدم البنوك البريطانية على ما يبدو لفتح بعض حساباتها. وقد تلقى حساب لجنة الشورى والإصلاح، وهو المنظمة الواجهة لبن لادن، أموالاً من بنوك في السودان ودبي والإمارات العربية المتحدة. وكانت الأموال تحول من لندن إلى خلايا القاعدة في المدن الغربية، وإلى عدة مراكز وجمعيات خيرية إسلامية في أماكن مثل البوسنة وكوسوفو وألبانيا.
بيد أن الإدارة السياسية على كلا جانبي الأطلسي قبل 11 سبتمبر في رصد التمويل الإرهابي والسيطرة عليه، كانت ضعيفة. وليس هناك أدلة على أن بريطانيا حاولت مطلقاً الضغط على السعوديين لإغلاق قنوات التمويل المقدم للجماعات المتأسلمة، إذ كان اعتماد بريطانيا الاقتصادي حينذاك كبيراً إلى حد أن هوايتهول كانت تشعر بالعجز عن تحدي أي سياسات مهمة لحليفها الأثير، وهو موقف لا يزال جلياً إلى اليوم. والأحرى أن كل الأدلة تشير إلى أن بريطانيا واصلت التغاضي عن السياسة الخارجية "الإسلامية" للسعودية وناصرتها. ويصدق الأمر نفسه على الولايات المتحدة، التي تقاعست هي أيضًا عن تحدي الدعم السعودي "للجمعيات الخيرية" العاملة في بلدان إسلامية أخرى. وعندما ناقش رئيس مكافحة الاهاب في الخارجية الأمريكية مثل هذا الضغط في النهاية في 2002 في برقية تم إرسالها إلى شتى السفارات الأمريكية، رفض مسئولو الخارجية الأمريكية الآخرون التوصيات الواردة في البرقية بحجة مضادة هي أن هذه الجمعيات الخيرية تؤدي أعمالًا حسنة كثيرة.
وكان اعتماد بريطانيا على السعودية إلى حد كبير نتيجة لخيارات في السياسة اتخذت عبر عقود ماضية، عندما فضل المخططون في هوايتهول باستمرار الوقوف في صف النظم الرجعية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فقد تغير شيء ما، ففي الماضي كان الوزراء يغترفون في مجالسهم الخاصة صراحة بالطابع القمعي المنتمي للعصور الوسطى للنظام السعودي، لكنهم كانوا حريصين في العلن على عدم ربط هذا النظام بهذه الصفات – بصورة وثيقة – خوفاً من استثارة مزيد من النقد من النظم القومية في المنطقة بل وفقد المزيد من النفوذ البريطاني هناك. بيد أن الوزراء البريطانيين في ظل حكومتي تاتشر وميجور أصبحوا يغتنمون أي فرصة للثناء على السعوديين، والعمل مبررين لسياساتهم بغية الظفر بعقود تجارية وعسكرية.
وفي يناير 1996، وصف جيريمي هانلي وهو وزير دولة بالخارجية، السعودية، بأنها "البلد الذي تتقاسم سياسته الخارجية معنا أهدافاً مماثلة لأهدافنا"، وهو "بلد لعب دوراً حاسماً في تشجيع السياسات المعتدلة والرشيدة"، وكان "حصناً للاستقرار والاعتدال في منطقة لم تعرف بهذه السمات دوماً". وقبل ذلك بعام، كان هانلي قد أخبر البرلمان بأن "حكومة صاحبة الجلالة ليس لديها أي خطط لربط سياسات المملكة المتحدة بشأن التجارة والدفاع بأداء السياسة السعودية في مجال احترام حقوق الإنسان.. ]أو[ بأداء السعودية في مجال الحرية الدينية". كان السعوديون يستطيعون أن يفعلوا ما بدا لهم ويظلوا مع ذلك يركنون لحماية الحكومة البريطانية وخداع النفس البشع بأن السعوديين "معتدلون ومعقولون". وفي خطاب استثنائي ألقته في المعهد الملكي للشئون الدولية في لندن في أكتوبر 1993، أكدت أن السعودية كانت "قائداً لأسرة إسلامية أعرض من الدول" وأنها "قوة ضخمة للاعتدال والاستقرار على المسرح العالمي"، وأضافت: "إنني من أشد المعجبين بالسعودية وقيادة الملك فهد". كانت بريطانيا مستمرة في "برامجها للتدريب وتقديم المشورة والمعدات". وقالت تاتشر: إن "السعودية لم تستخدم أسلحتها بطريقة غير مسئولة مطلقاً".
أضافت المزيد:
لكن ماذا عن "داخل السعودية؟" ليس لدي النية في أن أتدخل في الشئون الداخلية لهذا البلد. فمن بين أكثر معتقداتي رسوخاً أنه على الرغم من أن هناك معايير وأهدافاً أساسية معينة يجب أن نتوقعها من كل عضو في المجتمع الدولي، فإن الوتيرة والنهج المحدد يجب أن يعكس الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للمجتمعات المختلفة.
وخلصت تاتشر إلى القول بأنه "على الرغم من التهديد الذي يبدو أن الأصولية الإسلامية تطرحه في بعض البلدان، لا ينتابني أي شك في أن الإسلام نفسه قوة من القوى الأساسية من أجل الاستقرار في السعودية الحديثة. وهناك قوة أخرى كهذه باعثة على الاستقرار هي الأساس الوطيد لملكية راسخة الأقدام ومحترمة".
وقد كشف هذا التعليق عن عجز تاتشر عن الاعتراف بأن السعوديين تحديداً كانوا من بين الدعاة الرئيسيين للأصولية الإسلامية.
واستمر تدفق الأسلحة البريطانية كجزء من صفقات أسلحة كانت قد وقعت في العقد الماضي، كما قدمت هوايتهول خدمات عسكرية أخرى، مثل تدريب الحرس الوطني السعودي الذي كان لا يزال يقوده عبدالله ولي العهد. وبقيام بريطانيا بذلك ربما تكون قد ساعدت في تقديم مزيد من التدريب للمجاهدين السعوديين السابقين في الحرب الأفغانية، ولكن كثيرين منهم قد عادوا إلى السعودية حينذاك وانضموا للحرس الوطني. والمعروف أن آخرين متعاطفين مع القاعدة قد انضموا للحرس الوطني وربما استفادوا من التدريب البريطاني.
قاعدة بن لادن في لندن
بيد أنه في حين كانت بريطانيا تساند ملوك السعودية، فقد وفرت أيضًا قاعدة مضيافة لهؤلاء الذين كانوا قد أصبحوا حينذاك خصومهم المروعين. ففي يوليو 1994، أنشأ أسامة بن لادن مكتباً في لندن لأسماه لجنة الشورى والإصلاح، وسعى لتشجيع المعارضة للنظام السعودي على النطاق العالمي – وكان ذلك رد فعل فوريًّا على سحب السعوديين للجنسية منه، وفق ما ذكر تقرير لوكالة المخابرات المركزية رفعت عنه السرية. وكانت اللجنة التي تدار من بيت في ويمبلي في شمال لندن، مجهزة بحشد من أكياس الفاكس والحاسبات التي كانت تقذف من باطنها بعشرات الكتيبات والبلاغات التي تدين تبذير بيت آل سعود وزيغه عن الشريعة في البلاد، وتدعو كذلك إلى تحطيم الدولة السعودية. ووفق وثائق حديثة صادرة عن محكمة أمريكية، فإن اللجنة "أنشئت على حد سواء بغرض نشر بيانات بن لادن وتوفير غطاء لأنشطة دعم أعمال القاعدة العسكرية"، بما في ذلك "تجنيد المتدربين، وصرف الأموال وشراء المعدات والخدمات". وإضافة لذلك، عمل مكتب لندن مركز اتصال بالنسبة لتلقي التقارير عن الأمور العسكرية والأمنية وغيرها المقدمة من مختلف خلايا القاعدة إلى قيادتها.
ولاحظ تقرير البحوث الذي يعده الكونجرس الذي أذن بنشره بعد هجمات 11 سبتمبر في 2001 مباشرة، أن بن لادن زار لندن في 1994ومكث فيها بضعة أشهر في ويمبلي ليقيم اللجنة. وتدعي مصادر أخرى أنه زار لندن في 1994؛ ليجتمع مع أعضاء من الجماعة الجزائرية الإسلامية المسلحة، بل وأنه كان يسافر بانتظام إلى لندن في 1995 و1996 في طائرته النفاثة الخاصة. وأيًّا كانت الحقيقة في هذه الادعاءات، فإن سجلات فواتير هاتف "بن لادن" من 1996 إلى 1998 تبين أن نحو خُمس مكالماته، 238 مكالمة من 1100 مكالمة – أكبر عدد بمفرده – أجرى إلى لندن؛ مما يبين أهمية هذه القاعدة. وكانت اللجنة هي التي نظمت اجتماعاً بين "بن لادن" وعدد من صحفيي "سي إن إن" في مارس 1997.
وضمت هيئة العاملين باللجنة أعضاء من منظمة أيمن الظواهري الإرهابية، منظمة الجهاد الإسلامي المصرية، منهم عادل عبد الباري وإبراهيم عيدروس، وقد حكم عليهما كليهما بالسجن في الولايات المتحدة لتورطهما في تفجير السفارتين في 1998، عندما قتلت انفجارات متزامنة في دار السلام ونيروبي ما يربو على 200 شخص. وتزعم الولايات المتحدة أن عادل عبد الباري كان يدير معسكرات التدريب وبيوت الضيافة التابعة للقاعدة قبل وصولة إلى لندن، حيث تم منحه حق اللجوء في 1993، وبعد عامين حكم عليه بالإعدام غيابياً بزعم تورطه في تفجير خان الخليلي وهو مطعم سياحي في مصر. وفي مايو 1996، تم اتهام عبد الباري بأن الظواهري عينه قائداً لخلية لندن من تنظيم الجهاد المصري. وزعموا أن عيدروس كان قد بدأ ينظم خلية لتنظيم الجهاد الإسلامي في أذربيجان في أغسطس 1995 قبل أن يفد إلى لندن في سبتمبر 1997 ليصبح قائد قاعدتها في لندن. وعندما كان عيدروس في بريطانيا؛ حيث منح هو أيضًا حق اللجوء السياسي، اتهم بإجراء اتصالات هاتفيه عن طريق القمر الصناعي مع قيادة القاعدة، واتهم بأنه وفر مع عبد الباري جوازات سفر مزورة لنشطاء جماعة الجهاد الإسلامي المصرية في هولندا وألبانيا. وفي يوم التفجير الذي وقع في شرق إفريقيا، وزع كلاهما بيانات عن مسئولية التنظيم من خلال الفاكسات على وسائل الإعلام، وأنكر محامو الرجلين أنه كان لديهما علم مسبق بالتفجيرات، ولكن ضابطًا من جهاز المخابرات الداخلية، قدم مؤخراً أدلة تتعلق باستئناف بشأن الهجرة، ذكر أن الفاكسات أرسلت فعلاً قبل إجراء التفجيرات. واحتجز الفرع الخاص الرجلين في سبتمبر 1998 بموجب قانون الإرهاب، بتهمة أنهما كانا على صلة بتفجيرات 1998.
وكان رئيس لجنة بن لادن للشورى والإصلاح هو خالد الفواز وهو منشق سعودي، اعتقلته الشرطة البريطانية بموجب طلب ترحيل قدمته الولايات المتحدة في سبتمبر 1998؛ بزعم تورطه في تفجيرات شرق إفريقيا في الشهر السابق. وحتى هذه المرحلة كانت السلطات البريطانية قد سمحت للفواز ولجنة الشورى والإصلاح بأن يعملا علناً لمدة أربع سنوات. ويدعي هذه الاتهام الموجه للفواز أنه زود بن لادن "بمختلف وسائل الاتصال"، بما في ذلك هاتف يعمل بالقمر الصناعي للتحدث إلى خلايا القاعدة، وأنه زار نيروبي في 1993 ووفر سكناً هناك لأبي عبيدة، أحد قادة القاعدة العسكريين. وتم احتجاز الفواز في بريطانيا منذ 1998، ورفضت المحاكم البريطانية بإثبات محاولات الولايات المتحدة ترحيله إليها، بعد عمليات استئناف قدمها محامو الفواز تدعي أن حقوق الإنسان الخاصة به ستنتهك في السجون الأمريكية.
وتشير الأدلة إلى أن نشطاء لجنة الشورى والإصلاح كانوا يلقون تسامحاً من البريطانيين، الذين ربما اعتبروهم مصدراً مفيداً للاستخبارات. فقد قال محامو الفواز مثلاً إنه كان على اتصال منتظم بجهاز المخابرات الداخلية منذ وقت وصوله إلى بريطانيا في 1994 حتى القبض عليه بعد ذلك بأربع سنوات. وكانت اجتماعاته معه تدوم عادة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر، في حين إن هاتفه محل تسجيل على الأرجح وكانت مراسلاته يجري اعتراضها. ولاحظت الجارديان أنه: "ربما اعتقد جهاز المخابرات الداخلية أنه من الأفضل رصد فواز.. للحصول على الاستخبارات".
وبعد المذبحة الإرهابية للسياح في الأقصر في مصر، شن الرئيس مبارك هجوماً على بريطانيا؛ لأنها تؤوي المجاهدين في لندن والمرتبطين بهذا الهجوم وغيره، بمن فيهم عادل عبد الباري، وطالب بتسليمهم. وقد ورد أن الحكومة البريطانية رفضت هذا الطلب. بيد أنه يبدو أن الحكومة كانت تميل إلى ترحيل المجاهدين، عقب طلب من المصريين، لكن أعاقها رفض مصر لطلب بريطاني بضمان أن يلقوا معاملة عادلة، وإذا وجد أنهم مذنبون، لا يتم إعدامهم. ذلك أن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية تمنع ترحيل المشتبه بهم الذين قد يتعرضون للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
وكان سعد الفقية منشقاً سعودياً آخر في لندن، وهو أستاذ جراحة سابق في جامعة الملك سعود وضع خبرته الطبية في خدمة الجهاد ضد السوفيت في أفغانستان. وكان الفقيه قد هرب من السعودية في 1994 وأقام مجموعة أخرى معارضة للنظام، هي حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية في لندن في 1996 ومنح حق اللجوء السياسي. وقد قال الفقيه مؤخراً إنه يحتفظ "باتصالات عالية المستوى" مع إدارات المخابرات البريطانية "ويقدم لهم المشورة بشأن السعودية. وفي 2004، حددت الولايات المتحدة الفقيه بوصفه موفر الدعم المالي والمادي للقاعدة منذ منتصف التسعينيات، واتهمته بأنه على صلة بـ"بن لادن"، لكن الفقيه كان يعيش علناً في بريطانيا لمدة تربو على عقد ولم تستجوبه السلطات البريطانية ولو لمرة واحدة. وقد شك كثيرون من المحللين العالمين ببواطن الأمور في تورطه المزعوم في الإرهاب، وأشاروا إلى حقيقة أنه لم توجه له أي تهمة، ناهيك عن أي دليل على ذلك، وأكدوا أن حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية هي حركة معرضة مشروعة للسعودية، وأن اعتبار الولايات المتحدة له إرهابياً يتعلق أساساً باسترضاء زبون سعودي.
لكن ربما رأى البريطانيون أن الحركة وغيرها من المجموعات السعودية توفر ما هو أكثر من الاستخبارات. ويقدم ستيف كول الصحي الأمريكي، مستشهداً بحوارات أجراها مع مسئولين بريطانيين، سبباً لعزوف بريطانيا عن أن تأخذ المراكز المعارضة للسعودية بالشدة: "كانت مسألة إيمان في واشنطن ولندن خلال أوائل التسعينيات بأن قليلاً من الضغط الخارجي- حتى وإن جاء من متأسلمين- يخلق سياسات أكثر صحة وأشد استقراراً في المدى الطويل". ونظرية كول عن أن المخططين البريطانيين والأمريكيين كانوا يريدون استخدام رافعة متأسلمة للتأثير على جدول الأعمال السعودي الداخلي، معقولة وتتسق مع سياساتهم السابقة في المنطقة. بيد أن نظريته عن أن هذا يستهدف سياسات "أكثر صحة" (بدلاً من مجرد "موالية للغرب") أقل معقولية "فالأرجح أن لندن وواشنطن كانتا تعتبران الإصلاح الداخلي وسيلة لتدعيم حكم بيت آل سعود".
ويضرب الفقيه تفسيراً آخر لتسامح الحكومة البريطانية مع هذه الجماعات. فعندما سئل في حوار دار معه في نوفمبر 2003 عن العيش في بريطانيا رد بأن البريطانيين "اكتشفوا أن المراهنة على علاقات استراتيجية مع النظام ]السعودي[ خطيرة، ومن الأفضل أن تكون لهم علاقات مع الشعب وافترض أنهم يعرفون كم نحظى به من مساندة من الرأي العام". كما قال الفقية مؤخراً إن "البريطانيين دهاة.. بما يكفي ليدركوا أن النظام السعودي مقضي عليه بالزوال. وهم يريدون أن يكونوا في وضع يتيح لهم التعامل مع قادة بدلاء". وهنا يبالغ الفقيه في الدعم الذي تحظى به حركته في السعودية. فمن الهراء جعلها مرادفاً "للشعب". ومع ذلك، فإن فكرة أن بريطانيا كانت تحاول إقامة علاقات مع صناع السياسة في المستقبل في البلاد بالتسامح مع جماعات المعارضة هذه، هي بلا ريب فكرة معقولة. ففي حين أن بريطانيا ساندت طويلاً الحكام الإقطاعيين في السعودية، فإن الاستقرار طويل الأجل للنظام كان محل تساؤل منذ أجل طويل بالمثل. ومرة ثانية، فإن جماعات المعارضة كانت تستطيع أن تعمل كقوة وكيلة تعمل بالنيابة عن هوايتهول، ومن ثم، فإن بريطانيا ربما كانت إلى حد ما تحاول أن تلعب على الطرفين.
وقد سمحت قاعدة لندن لـ"بن لادن" بتحريك أنصاره في كل مكان في العالم. فقد قرأ مرتكبوا الهجمات بالقنابل في السعودية في 1995، كتابات بن لادن بعد أن أرسلت إليهم بالفاكس من لندن. ومن لندن أيضاً، تم إرسال فتاوى رئيسية شتى لـ"بن لادن" إلى سائر أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، وزعت لجنة الشورى والإصلاح ترجمة إنجليزية لإعلان بن لادن الصادر في أغسطس 1996 عن الجهاد ضد الأمريكيين "الذين يحتلون أرض الحرمين"، والذي يدعو لطرد الولايات المتحدة من السعودية، والإطاحة ببيت آل سعود والثورة الإسلامية في كل أرجاء العالم. وبعد ذلك بعامين، أذاعت لجنة الشورى والإصلاح في فبراير 1998، خبر إنشاء بن لادن لجبهة دولية للجهاد ضد الصليبيين واليهود، لتضم معاً تشكيلة من الجماعات الإرهابية. بيد أن هذا "لم يسبب قلقاً كبيراً لهوايتهول"..
ومما له دلالاته أيضًا أن إدارات المخابرات البريطانية والأمريكية أهدرت مراراً فرصة الحصول على معلومات عن بن لادن والقاعدة. ففي مطلع 1995 على سبيل المثال، عرضت الحكومة السودانية، التي كانت تؤوي بن لادن حينذاك، تسليمه أو استجوابه هو ونشطاء آخرين كان قد تم القبض عليهم بتهمة التخطيط لارتكاب فظائع إرهابية. وعرض السودانيون صوراً وتفاصيل عن أفغان عرب شتى، بما في ذلك سعوديون ويمنيون ومصريون حاربوا ضد السوفيت في أفغانستان. وقال مصدر سوداني: "إننا نعرفهم بالتفصيل. نعرف قادتهم، وكيف يطبقون سياساتهم وكيف يخططون للمستقبل. وقد حاولنا نقل هذه المعلومات للمخابرات الأمريكية والبريطانية حتى يعرفوا كيف تعالج الأمور". وتم رفض عرض السودانيين، بسبب الكراهية غير العاقلة، التي يكنها الأمريكيون للنظام السوداني كما تواتر، كما تم رفض عرض لاحق قدم تحديداً إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني. وبعد ذلك بثلاث سنوات، تجاهلت بريطانيا أمر اعتقال لـ"بن لادن" أصدرته ليبيا.
لقد بلغ إحساس أنصار بن لادن بالأمان في لندن حد أنهم أرسلوا طلبات إلى وزارة الداخلية يستعلمون فيها عما إذا كان زعيمهم يستطيع أن يطلب اللجوء إلى بريطانيا. ومؤخراً قال مايكل هوارد وزير الداخلية آنذاك: إن تحقيقاً أجراه العاملون معه أسفر عن فرض أمر حظر عليه. وفي يناير 1996، أرسلت وزارة الداخلية خطاباً لـ"بن لادن" تذكر فيه أنه سيواجه الطرد من المملكة على أساس أن وجودك هنا لن يحقق المصلحة العامة". وافترض أن منح حق اللجوء لـ"بن لادن" كان سيمثل خطوة أبعد من اللازم بالنسبة للبريطانيين في ضوء حاجتهم إلى اعتبارهم ساعين لرضا السعودية.
لم يكن تفجير السفارتين الأمريكيتين في 1998 هو الاعتداء الوحشي الإرهابي الوحيد الذي خطط له بن لادن، أو المقربون منه خلال الفترة التي كانت لجنة الشورى والإصلاح تتخذ فيها من لندن مقراً لها. ففي أواخر 1994، حددت وكالة المخابرات المركزية بن لادن باعتباره تهديداً إرهابياً، مدركة أن حلقته الداخلية كانت تعمل عن كثب مع إدارات المخابرات السودانية التي كانت بدورها تدير عمليات إرهابية وشبه عسكرية في مصر وغيرها. ففي يونيو 1995، هاجم فريق للقاعدة السيارة الرئاسية للرئيس مبارك خلال زيارة لأديس أبابا عاصمة إثيوبيا. وفي 1996 بين تحليل سري لوكالة المخابرات المركزية أن الولايات المتحدة كانت على علم بتمويل بن لادن للمتطرفين الإسلاميين المسئولين عن محاولة تفجير مائة جندى أمريكي في عدن في ديسمبر 1992، وأنه يُجري الأموال على المتطرفين المصريين لشراء الأسلحة، ويُغدق الأموال على "ثلاثة معسكرات إرهابية على الأقل في شمالي السودان. وبعد انتقال بن لادن إلى أفغانستان، أقام معسكرات تدرب على الإرهاب هناك تحت حماية طالبان. ويصعب الاقتناع بأن المخابرات البريطانية لم تكن هي أيضًا على علم بأنشطة بن لادن خلال الفترة التي تغاضت فيها عن قاعدته في لندن".
وعلى النقيض من تسامح بريطانيا مع لجنة الشورى والإصلاح وحركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية، فإنها كرست معاملة مختلفة لقائد مجموعة سعودية أخرى معارضة في لندن هو محمد المصري، وهو لاجئ من السعودية أسس في 1994 لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة. وبحلول أوائل 1995، كانت الحكومة السعودية تحتج بقوة لدى هوايتهول بشأن محاولات المصري تدمير النظام السعودي، وهددت بإلغاء صفقات السلاح إذا تقاعست الحكومة عن اتخاذ إجراء ضده. ونظراً للمصالح الكبرى المتضمنة، ألقى دوجلاس هيرد وير الخارجية وجون ميجور رئيس الوزراء خطابين في أبريل ومايو 1995، كان من الواضح أنهما موجهان للمصري جا فيهما أن المنشقين الإسلاميين، "غير مرحب بهم في لندن لأقصى حد". وفي شهر ديسمبر، اتخذت هوايتهول خطوة غير مسبوقة بإصدار أمر بطرد المصري وحاولت إرساله لأي مكان يمكن فيه إقناع السلطات المحلية بذلك، ليستقر في جزيرة دومنيك في الكاريبي والتي زادت بريطانيا معونتها لها أربع مرات كإغراء، وبذلك أعطت بريطانيا الأولوية لصادرات السلاح إلى السعودية. بيد أن المحاكم البريطانية قضت بأن الطرد غير قانوني، وأن الحكومة فشلت في أن تثبت أن المصري لن يتعرض للخطر بعد إبعاده. وحسبما قال روبرت باير وهو ضابط سابق في المخابرات المركزية، فإن السعوديين كانوا وراء محاولتين لاغتيال المصري على الأقل، وليس من الواضح ما إذا كان هذا قد تم في بريطانيا أو في مكان آخر.
وفسرت الجارديان خطابي ميجور وهيرد بأنهما إشارة إلى أن موقف الحكومة إزاء المنشقين الإسلاميين طفق يتشدد، وعجل به ضغط الحكومات العربية على بريطانيا للتضييق عليهم. ومع ذلك، فإن الإجراءات الحكومية اقتصرت على المصري إلى حد كبير، ترضية للسعوديين كما يبدو، في حين أن منشقين آخرين، مثل أتباع بن لادن، كان يسمح لهم بأن يمضوا فيما يعملونه بحرية حتى سبتمبر 1998. إذ كان من الواضح أنهم يعملون برضا ضمني من السلطات البريطانية، وكان السبب الأرجح في ذلك هو أنهم كانوا يعتبرون مفيدين بالنسبة للبريطانيين، وذلك يتفق مع سجلات التاريخ.
لقراءة الحلقة الأولى اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الثانية اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الثالثة اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الرابعة اضغط هنا
ولقراءة الحلقة الخامسة اضغط هنا